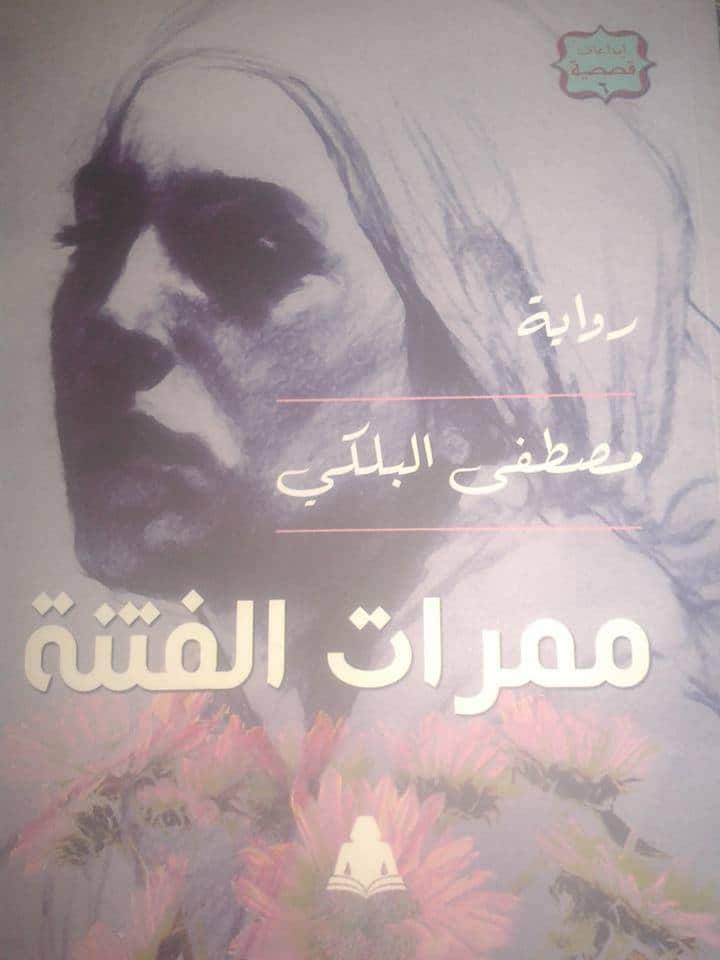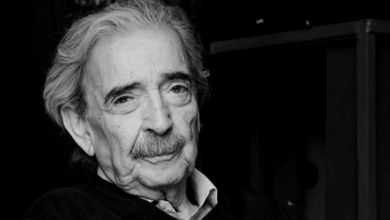صحبني جدي في يومي الأول إلى المدرسة، فارقت يده، تجاوزت اللافتة، فأحسست بالغربة وأنا وسط دوامات التراب الناتجة من هرج ومرج العيال، سرتُ متجنبًا الصدام، وكوني أحفظ وصية جدي:
“ملكش دعوة بحد وخليك في حالك”
دسستُ القرش في جيبي، ورحتُ ألتمس طريقًا تجنبني الصدام، لم أجد إلا الطرقة المبلطة والتي تمتد أمام غرف الإدارة بكل تشكيلاتها، وفي نهايتها لمحت حفنة من الأطفال، كل واحد في عنقه مخلاة من نفس قماش المرايل، يتحلقون حول شخص نحيل، يميل إلى القصر، وجهه أغرب ما فيه، فهو يحتل مساحة كبيرة من مقدمة رأس كبير، يجلله شعر كثيف منبته يحتل نصف الجبهة، شكله رغم ما فيه إلا أن هناك نوعًا من الدفء يشع من ملامحه، وهو ما قربني منه، بيديه أفسح لي مكانًا في الحلقة، وقبل أن أحتل البقعة التي خلت، أرسلت نظرة فإذا الفراغ حوله يكفي لجلوس نفس العدد، الكل في انتظام، يشغل كل واحد مكانًا في الحلقة، وهو في الوسط، يسرد القصص، وصوته يتلون طبقًا لما يقول، يملك قدرة سلب العقول، وجعلها تتساءل: من أين جاء بكل تلك الحكايات؟.
في تلك اللحظة تمنت العقول أن يطول الزمن ويتمدد، لكن عم نعيم حينما أمسك بسلسلة الجرس، انتهى كل شيء، ووقفنا في أماكننا تُلجمنا مقدمات الحياة الجديدة، ويتقدمنا صاحب الجسد النحيل، والرأس المملوء بالحكايات.
وفي ركن قصي بجوار المصلَّى استجابت الأجساد جديدة العهد بالمدرسة، لعصا طويلة، يمسك بها رجل يرتدي البنطلون والقميص، طبقا لوصف جدي فهو”الأفندي”، تداخلت الأجساد، فضاع جسدي بين أقراني، وكذلك صاحب الجسد النحيف، بحثتُ عنه وجدته في مقدمة الكتلة المتداخلة من الصغار، يقف ثابتًا، فأبعدت الارتعاش عن جسد يرف فيه كل شيء ابتداءً من الساقين، وانتهاءً بالشفتين، وبعينين مفتوحتين تابعتُ انصراف من هم أكبر منا إلى فصولهم على وقع النشيد الجمهوري:
والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي
انطق وقول أنا صاحي يا حرب والله زمان.
وحينما سكت صوت المارش العسكري، ولد صوت قوي ألهب الأذنين، راح يتلو الأسماء، حاولت أن أبدو ثابتًا في مكاني والمكان من حولي يفقد أندادي، مع كل اسم، يفارق الكتلة البشرية، ليلحق بالصف، من داخلي أيقنت أن وجودي بين الذين انتظموا في صفوف معلق باسمي حينما يخرج من بين الشفتين الضامرتين، بعد أن تمر عليه عينان تسكنان خلف نظارة سميكة الزجاج.
رضيتُ وتسمرتُ في مكاني، ونظرتُ فإذا بصاحب العود النحيف مثلي يسبح في فراغ، تابعته، فوجدته يستجيب للفم حينما نطق اسمه، أكده حينما رد قائلاً: “أفندم” صحبته وهو يتقدم ليحتل مقدمة الصف المتلاصق، وحزنت حينما امتدت يد وسحبته إلى مكانه في ترتيب الأسماء، ومن ملامحه وهو يحتل مكانًا متأخرًا، عرفت أن الضيق هو ما يسيطر عليه، تمنيتُ لحظتها لو كان اسمي التالي ليأتي خلفه، لكن الأسماء بدأت تتردد، والمساحات الفارغة راحت تتسع حولي، وعلى مسافات بعيدة منى بعض الصغار المنتظرين لأمر الالتحاق بالصفوف، صعدتُ من أمنيتي بقلب صغير لا يعي ما كان يدفعه لذلك.
مع تناقص الأطفال من حولي، راح الحبل يلتف حول رقبتي، ويشعرني بالاختناق، إنقاذي كان في الصوت وقت أن يخرج حاملاً اسمي، ليستبيح الفضاء الذي كاد يخلو من أندادي، وفي اللحظة التي فرغ فيها من كان يردد الأسماء، طوى الدفتر، وتوجه إليّ، كنت أقف وحيدًا أحتضن مخلاتي، بينما الصفوف تأخذ طريقها إلى الفصول. لولا ابتسامة مطمئنة خرجت من فم صاحب الحكايات خصني بها وهو يمضي بجواري، لانهرت كجذع نخلة عصفت به ريح قوية.
وقت أن فقد الفناء كل الضجيج، راح إحساس الوحدة يطاردني، كوني مللت من حياة بلا ألعاب مع أطفال لا أجدهم إلا في أوقات متباعدة، كانوا يأتون إلى الحقول المحدقة ببيت وحيد في الملقة، تفاقم ودبيب قدميّ الممسك بالدفتر يقترب مني وهو لا يكف عن التحديق إليّ، رأيتُ على وجهه جهامة لم أتعودها حتى من جَدّتي التي كانت حاضرة معي بوصيتها، فقبل خروجي من بيت الملقة اقتربت منى وسألتني:
– اسمك إيه؟
– نصر.
– نصر مين يا نصر؟
سكتُ, فقالتْ:
– نصر واد البعيد.
حدقتُ فيها، وأنا أضع المخلاة في رقبتي، أردتُ أن أعترض، لكن جدي، قال موبخًا إياها.
– يا شيخه انسي، دا ربنا بيغفر.
صرختْ فيه:
– وأنا مش ربنا.
جدّى، وهو يرافقنى، ظل طول المشوار من بيت الملقة إلى المدرسة، يوصيني:
“اسمك نصر سيد الحناوي”
بلعتُ ريقي، ونطقتُ باسمي كما أوصاني جدي، أخذ المدرس يمر على الأسماء بعينين راجفتين، وحينما انتهى رفع رأسه، وضم أصابع يده اليمنى، ثم جعلها تستقر مفرودة على صدغي الصغير، فترنحتُ وكدتُ أقع، ولم أملك إلا الدموع، فرت من عينيّ من دون صوت، فثبتُ في مكاني أقاوم ارتباكي، وماء يريد أن يخرج من عضوي المنكمش خلف لباس جديد من الدبلان الأبيض، إلا أن اليد الأخرى التي طارت واستقرت على خدي الثاني، جعلتني أنسى، وأضع كفىّ على الصدغين من أجل حمايتهما، من لطمات أخرى، لكن اليد عادت وأمسكت بياقة المريلة وجذبتني كما يجذب الفلاح بهيمة لا تعرف الطريق، ودفعني عبر باب مفتوح، فاجتزته والدموع تسيل على خدين يأكلهما الألم، وجدتُ نفسي داخل غرفة أنيقة، يجلس فيها رجل إلى مكتبه، يقترب من سن جدي، رفع عينيه عن أوراق كان يتفحصها، وصعق إذ لمح الدموع تنسال من عينيّ. غادر مكتبه، وقال موبخًا:
– قلت ألف مرة بلاش ضرب.
قال المدرس وهو يرسل عينيه إلى الأرض:
– ده مش عارف اسمه.
حوّل الناظر عينيه من على وجه من ضربني وعانق وجهي، وابتسم وسألني عن اسمي، كررتُ ما قلته وما أعرفه، ربت على كتفي، وخطف الكشف، وأجرى عينيه على الأسماء، فلما انتهى سأل المدرس:
– أنت مش من البلد دى؟
– لأ.
– كان لازم تعرف اللي بيحصل بخصوص الأسماء.
فغر المدرس فاه، ولم يعرف كيف يرد، فنظر الناظر إليه في غضب، وطلب الملفات، خرج المدرس مسرعًا، وجلستُ بضع دقائق، كانت مريحة بفعل طيبة الرجل، الذي أحببته لأنه مثل جدي يحتفظ بنفس الصورة فوق رأسه، صورة لرجل باسم الثغر، والكاب بنسره يستقر على رأسه، ومن فرط راحتي كدتُ أنسى صفعة المدرس، ولولا دخوله لاستطعتُ ولو مؤقتا.
تناول الناظر الملف، وسحب منه ورقة قديمة، ظلت لسنوات مطوية عدة طيات، ومسجونة في كيس بجوار عقد البيت والقراريط القليلة التي يملكها جدي في الملقة، وبعينين تسكنان خلف النظارة، قرأ ثم وضعها على المكتب، وسألني:
– اسم والدتك إيه؟
– سندس طايع.
– ووالدك؟
– سيد الحناوي.
ابتسم، وقال لي برفق:
– اسمك من النهارده غصوب.
ثم نظر إلى المدرس وقال له:
– خده على أولى أول.
في نهاية اليوم، عند عودتي لبيت الملقة، جلست قليلاً بجوار جدتي، يدي على خدي، وحينما تذكرتُ اسمي الجديد، نزعتُ مخلاتي الفارغة إلا من قلم رصاص، وكراسة واحدة بيضاء، وضعتها على حجري، وبدأتُ أستوعب اسمًا جديدًا لم أعرفه إلا من ساعات، وألمًا كان يتصاعد في خدي.
جلس جدى بجواري صامتًا، وكلما سألته عن اسمى، همهمَ بكلمات قليلة، لم تصلني منها إلا كلمات قليلة، منها كلمة نصيبك، وربنا يسامحها..
قلت له:
ـ مين؟
قال:
ـ الحاجة شاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل من رواية ممرات الفتنة