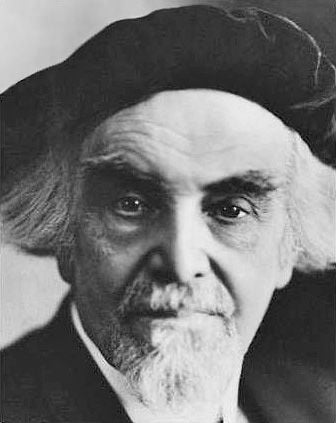إن فكرة الله هي أعظَم فكرة إنسانية، وفكرة الإنسان هي أعظَم فكرة إلهية.
وإذا كان الحق – وأعتقِد أنه لكذلك بعمق – أن روح الإنسان الحقيقية، روحه الخلاَّقَة، وعمله المبدِع، يتفوَّقان على ميولِه الطبيعية والوراثية، فإن أخلاقَه وصفاتِه النفسية الجسدية تتأثر بها تأثرًا بالغًا.
كان يبدو لي دائمًا أن النقود الضرورية للعيش مرسَلَةٌ “من أعلى” وذلك حتى أستطيع أن أكرِّس نفسي جملة وتفصيلاً لعملي الخلاَّق.
غير أن افتراقي عن الطلَبَة، وعن جو الفرقة كله، كان يضرب بجذوره إلى أعمق من ذلك، إذ استيقظَ في نفسي منذ الأعوام المبكرة من حياتي اهتمام بالمشكلات الفلسفية، وأحسَستُ، ولمَّا أزل صبيًا، برسالتي الفلسفية.
وكان شقيقي وسيطًا بارعًا، وكان يتلاعَب أحيانًا بهذه القدرة فينطق شعرًا، أو يتحدَّث بلغة غير مفهومة، وكان يدَّعي أنه على اتصال بأحد الكهنة الهندوسيين. وفي نوبة غير مفهومة، كان يدَّعي أنها صادِرة عن هندوسي، قال فيها “إن أخاك (أي أنا) سيكون شهيرًا في أوروبا المنحدِرَة إلى الشيخوخة”.
فأنا أدرك نفسي باعتباري نقطة يتقاطع عندها عالمان، فبينما أعرف “هذا العالَم” – عالَم حياتي الفعلية – باعتبارِه عالمًا كاذبًا غير حقيقي خاليًا من الأولية والنهائية، يوجد “عالَم آخَر” أكثر صدقًا وحقيقية تنتسِب إليه ذاتي العميقة.
وقد خضتُ معارك مع العالَم لا بوصفي إنسانًا يريد أو يستطيع أن يغزو هذا العالَم، ويخضعَه لنفسِه، بل باعتباري شخصًا يريد أن يحرر نفسَه من هذا العالَم، ويرفض تسلُّط هذا العالَم على حياة الناس.
والخيال بالنسبة لي أيضًا ميزةٌ من مزايا الإنسان، وهو يمنعني من قبول الواقِع أيًا كان أو الرضا به. انسحَبتُ داخِلَ نفسي رافِضًا أن أكون أسيرًا لأية لحظة من لحظات الحياة. وإنه ليبدو لي أن كل لحظة ناقصة مشوَّهَة لا سبيل إلى الرضا عنها.
وثورتي هي على أي شيء يحمل طابَعَ التكالب والتنافس والطموح إلى المركز الاجتماعي والصراع من أجل القوة، فتراني أحاول عدم الإصغاء إلى هذه الأمور إذا عُرِضَت علي، وأشعر بالارتياع عندما ينتهي أمرها، وذلك حتى أستطيع العودة إلى الأشياء التي تهمني حقيقةً. والآن أصبح مما لا يقبَل الشك أن الحب الجنسي والصِّراع في سبيل القوة هما اللذان يؤلِّفان ما يُعرَف بالحياة. ولقد كان يبدو لي دائمًا في الواقِع أنه لا مكان لي في “الحياة”، إذ كان يتردَّد صداها في نفسي، وكأنني منها على مسافَة بعيدة، دون أن تمسَّني إلا نادرًا… ولكنني في نهاية الأمر ظللت خارج الحياة، وعلى مستوى مختلِف كل الاختلاف. كنتُ متشعِّبًا بدافع أخروي لا يُقهَر، ولا يمكن إرضاؤه بأي عالَم موجود.
ومن المحتمل أن أعظم آثامي هو عدم قدرتي، ورفضي الاحتمال وطأة ما هو مبتذَل… ذلك المبتذَل الذي يؤلِّف نسيج الحياة ذاتِه، وكذلك عدم قدرتي على رؤية النور خلال الظلام المتكاثِف الذي يحيط بما هو مبتذَل.
ولابد من أنني أنتمي إلى طراز من الناس كان عدم الرضا بالواقِع، والحنين إلى ما هو أبدي هما الشاغِل الأسمى الحاسِم في حياتِهم. فلقد رددت طيلة حياتي كلمات زرادشت الخالِدَة: “أيتها الأبدية… إنني أعشقكِ”. ومن المُحال أن يعشِقَ المرء شيئًا غيرَ الأبدية. وكل حب هو حب لما هو أبدي… ولو لم تكن الأبدية موجودَة لما وُجِدَ شيء: واللحظة من لحظات الزمان تملك من القيمَة بمقدار ما يربطها بالأبدية، وبمقدار ما تسمح بمخرج من الزمان المغلَق – أي باعتبارها ذرةً من الأبدية لا من الزمان، على حد تعبير كيركيجارد.
المادة تتعلق بالزمني، أما الروح فتسعى وراء الأبدية.
ونشأ عن إدراكي للطابَع المنفصِل للعالَم عجزي عن اكتساب مكان وطيد فيه، ولعله يفسِّر أيضًا إعراضي عن أي مطامح في الحياة. ولقد كنتُ دائمًا عديم المبالاة بالنسبة للأشياء التي تخصُّني، وللثناء الذي يُغدقُه الآخَرون على عملي، إذ كان التقدير الإنساني يمس – في نظري دائمًا – المستوى السطحي أو القشرة الخارجية لأفكاري دون أن يصِل مطلقًا إلى جوهرها الحقيقي.
حركة العلو الذاتي هي بالنسبة إليَّ مسألة ذات أهمية عظمى، فأنا دائمًا وحيثما توجهت أغراني المتعالي وجذَبَني إليه. ذلك “الآخَر” الذي يتجاوز الحدود والسدود جميعًا وينطوي في ذاتِه على سر الحياة.
عندما أحسَستُ برسالتي كفيلسوف، صرتُ شاعرًا بنفسي بوصفي قد وهبتُ حياتي للبحث عن الحقيقة، وللكشف عن المعنى في الحياة.
ثمة قلق في الجنس الذي لا يشير إلى الرغبة في إشباع الشهوة فحسب، بل يحمل طابع الطبيعة الساقِطَة للإنسان – ومن المحال إرواء ظمأ الجنس في ظروف هذه الحياة الساقِطَة. لأن هذا الظمأ يفضي إلى أوهام تجعل من الإنسان أداة لعملية بيولوجية لا إنسانية. إن “ديونيسيوس” – إله الموت والحياة – قد أنجب المأساة التي لا يمكن أن يتحرر منها الجنس… والجنس يعرض الإنسان مجروحًا، ساقطًا، عاجزًا عن بلوغ الاكتمال الحقيقي عن طريق الاتحاد، إنه يدعو الإنسان للخروج من نفسِه للاتحاد بالآخَر، ولكنه يعود مرة أخرى إلى ذاتِه، ويستمر قلق اشتياقه إلى الاتحاد دون أن تخف حدَّتَه. إن شهوة الإنسان إلى الاكتمال التي جُبِلَ عليها لا يمكن إشباعها. وعلى الأخص لا تستطيع الشهوة الجنسية إشباعها، بل إنها تعمِّق حقًا من جروح الانفصال. والجنس في طبيعة ذاتِه غير صحي، وغير نقي… فهو شاهِد على طبيعة الإنسان المنقسِمَة، والحب الحقيقي هو الذي يتغلَّب على الانفِصال، ويصِل إلى الاكتمال والطهارة.
من الممكن أن يشير القلق إلى تجربة دينية، والقلق الديني يتضمن شوقًا إلى الخلود، والحياة الأبدية، وإلى استنفاد ما ينطوي عليه الوجود من تناهٍ. وكان يبدو لي أن الفن مشحون بالقلق أيضًا، وبالتالي يُعَدُّ دليلاً على الحنين المتعالي. وسحر الفن كامن في قدرته على اجتثاث جذور التناهي، وتحويل نظرة الإنسان إلى ما هو أبدي، وإلى أشكال الوجود النموذجية، وصوَرِه.
أطلقَ عليَّ بعضُ الناس اسم فيلسوف الحرية… والحق أنني أعشق الحرية فوق كل شيء آخَر. ومنشأ الإنسان من الحرية ومرجعه إليها. الحرية هي المصدر الأولي للوجود وشرطِه، ولقد وضعتُ “الحرية” بدلاً من “الوجود” في أساس فلسفتي. ولا أعتقد أن فيلسوفًا آخَر قد فعل هذا بنفس الطريقة الأساسية المفصلة. إن سر العالَم يكمن في الحرية، وقد أراد الله الحرية، والحرية هي منشأ المأساة في العالَم. الحرية في البدء والمنتهى. وأستطيع أن أقول إنني عكفتُ طيلة حياتي على صياغة فلسفة من الحرية، وكان يحرِّكني اعتقاد أساسي ألا وهو أن الله حاضر حضورًا حقيقيًا، وفاعلاً في الحرية وحدها. ويجب أن نعترِف بأن الحرية هي التي تملك وحدَها صفةً مقدَّسةً. بينما ينبغي أن تُلغَى جميع الأشياء التي أضفى عليها الإنسان منذ فجر التاريخ طابعًا مقدَّسًا.
ولكنني لا أستطيع أن أقول إنني “اكتسبتُ” الحرية أو تجربةَ الحرية، إذ كانت الحرية تبدو لي مبدئيًا، باعتبارها الشيء القبلي من الوجود. وفكرة الحرية تشير عندي إلى شيء أكثر أساسية من الكمال نفسه، مادامَت الحرية هي مفتاح الكمال، وفي غيابِها ينقلِب الكمال إلى قهر وعبودية، وبالتالي يناقض طبيعته ذاتها.
الحرية أولاً وقبل كل شيء هي استقلالي، هي تحديدي من الداخِل، وهي مبادأتي الخلاَّقَة. وواقِعها لا يعتمِد على أي معيار، وممارستها ليسَت مجرد اختيار بين الخير والشر باعتبارهما شيئين يقِفان إزائي. الأحرى أن الحرية هي معياري الخاص، وأنها خلقي الخاص للخير والشر. والتحرر عندما يتم الاختيار، وعندما أكون قد شرعت في عملية الخلق.
ينبغي على كل إنسان أن يكون متمردًا، أي أن يكفَّ عن احتمال العبودية في أية صورة من صورها.
والواقِع أن المتشكِّك لا يبحَث عن أي شيء، ولا ينتقِل من مكانِه على الإطلاق. والشك المطلَق إذا كان مُمكِنًا (وهو لا يمكن أن يكون كذلك) هو حقًا وضع الثبات التام… والموت. والمتشكِّك يناقِض نزعتَه الشكية فعلاً في كل مرة يسأل سؤالاً أو يعبِّر عن شكِّه ونكرانه، وبمثل هذا التناقض لنزعتِه الشكِّية يستطيع أن يعيش وأن يفكر. والشك المتطرِّف هو والقطيعة الصارِمَة شيء واحد في نهاية التحليل، إذ أن كلاً منهما يتشابه في أنه يفضي إلى انعدام الحركة، وإنهاء كل حياة خلاَّقَة. ومن الخطأ أن نفكر في أن الشك يمكن أن يكون موقفًا عقليًا خالصًا. ويخدع الإنسان نفسه حين يزعَم أن شكَّه لا يرجع إلى أسباب عاطفية وإرادية. والشك الدائم الجامِد الصلب، أعني الشك الذي استحال بعد تجربة عابِرَة إلى عناد، “دليل على افتقار إلى الشخصية، وعلى عجز عن الاختيار الحر”. وعندما يُنكِر الناس من ناحية أخرى – مثلاً – وجود الله على أساس عَدَم اتفاق هذا الوجود مع وجود الشر والألَم في العالَم، فإن هذا اللون من الشك لا يدلُّ على وجهَةِ نظر عقلية غير متحيِّزَة، بل يدل على حالة من حالات العقل، على تجربة عاطفية تستحق عطفًا عظيمًا.
أما الشك الدائم الملحّ والنزعة الشكية فيدلاَّن من وجهة أخرى على الفساد والانحلال. فإذا تغلَّب الشك تغلبًا نهائيًا، استحالَت الحياة إلى حلم شاحِب. والإيمان وحده، والفعل المتكامِل للإيمان لا الخضوع للقضايا القطعية هو الذي يمنَع تحوُّل العالَم كلّه إلى كابوس. وقد قاومت دائمًا ذوَبان صورة الإنسان، وانتهيت إلى معرفة أن الإنسان بهذه المقاوَمَة ذاتَها إما أن ينهَض، وإما أن يكبو وفقًا لإيمانه، أو كفره. ونزعة الشك هي في الحقيقة إضعاف للإنسان، وتحطيم له في نهاية الأمر.
الحب هو أكثر تجارب الحياة مساسًا بالشخصية، وينبغي ألا يجرؤ المجتمع على التدخُّل فيه.
… وما الحب إلا انتصار الشخصية على النوع والجنس اللذين يخلوان من التفرد والفردية. ولابد أن ينتصِر الحب الحقيقي على الجنس. وعندما يكون الحب قويًا فإنه يتصف بعمق يمكن أن يصِل إلى اللانهائية، أما الجنس فعلى العكس من ذلك يحمل في طياته وصمة التناهي، وهو يخفق إخفاقًا فاجعًا في الوصول إلى الاكتمال، ومقدر عليه أن يبقى مجالاً منعزلاً منفصلاً من الطبيعة الساقِطَة.
وأنا أرى دافعين أوليين في حياة الإنسان الباطنة: البحث عن المعنى، والبحث عن الأبدي. وذات مرة بينما كنت على أعتاب المراهقة هزتني هذه الفكرة في أعماق نفسي، ألا وهي أنه حتى ولو لم يكن هناك مثل هذا الشيء الذي أسميه معنى الحياة، فإن مجرد البحث عن هذا المعنى كفيل بأن يجعل الحياة ذات دلالة ومعنى. كان ذلك بلا شك ضربًا من الانقلاب – ولعله أقوى من انقلاب، أو ربما كان الانقلاب الوحيد في حياتي. كان انقلابًا للبحث عن الحق، وهو بحث يقتضي هو نفسه الإيمان بوجود الحق.
… وانتهيت إلى الاعتقاد بالواقع الأولي للروح على مستوى أعمق من مجال التفكير النظري، ويسمو عليه، لأن هذا المجال الأخير له طبيعة ثانوية غير أصيلة وينتمي إلى العالَم الخارجي “الرمزي” “المنعكِس”.
… ووجهة النظر الروحية ترى أن الروح والحرية شيء واحِد.
… وانتهيت إلى الشعور باستقلال الروح عن جميع الأشياء التي قد تجد فيها تعبيرًا عنها، وصرت أفهم معنى التضحية، وتسليم الذات من أجل حرية الروح التي لا يشوبها دنس.
… وكان تفكيري الخاص يتجِه اتجاهًا متزايدًا نحو مشكلات الأخلاق، وسيطرَة فكرة “ما يجب أن يكون” على فكرة “ما هو كائن”. لابد أن نعلِّق أهمية حاسِمَة في مجال المعرِفَة على العنصر الوجداني، أيًا كانت صعوبة العثور على هذا العنصر في القضايا العقلية – وكذلك ينبغي أن نعلِّق هذه الأهمية على القبول أو الرفض العاطفيين لهذه الفكرة أو تلك، أو هذه الواقعة أو ذاك السلوك.
… لا يسعني إلا الاعتقاد بأنه ينبغي على الأشخاص الذين يأملون في الوصول إلى الحقيقة أن يستغلوا مواهبهم في الاتصال بسر الوجود، بدلاً من تحليل حقيقة القضايا المنطقية والدفاع عنها.
لم تكن فلسفتي “علمية” قط بل كانت “تنبؤية” “أخروية” في طريقتها واتجاهها.
الحقيقة هي الله الذي يتعالى على الأشياء جميعًا، ولكنه يكشف عن نفسِه للإنسان، وفي الإنسان، وبوصفِه إنسانًا.
إن ما كان يثيرني هو إمكانية الثورة الروحية: قيام الروح والحرية والمعنى ضد ذلك العبء القاتِل… ضد العبودية وافتقار العالَم إلى المعنى.
… لقد كنت معنيًا بثورة الشخص الإنساني، لا بثورة الشعب أو الجماهير.
ولم تكن الثورات السياسية الخالِصَة منفِّرَة لي بسبب الأساليب التي تصطنعها لبلوغ مآربها فحسب، بل لميلِها المحتوم إلى خيانة الروح، وتزييف الواقِع، أي عكس الثورة الروحية. فثورة الروح هي الثورة الوحيدة التي يمكن أن تكون لها قوة خلاَّقَة حتى ولو لم تكن مهتمة في المقام الأول بالجماهير. إنها تهتم في المقام الأول بالإنسان.
لا ينبغي أن ننظر إلى المجتمع أو إلى الدولة أو إلى الأمة، باعتبارها مقدسة، بل إلى الإنسان وحده.
لابد أن يكون موضوع الثورة الحقيقية هو الإنسان، لا الجماهير أو السلطة السياسية، والثورة الشخصية هي وحدها التي يمكن أن تُسمّى “ثورة”. ومحاولَة الحصول على الحرية بإنكار حرية الذات أو حرية الآخَرين محاولة مآلها الفشل.
وقد فهمت أن الروح معناها الحرية والثورة، بينما “المادة” معناها الضرورة، والرجعية… فالناس على أتم استعداد للتنازل عن الروح في سبيل الخبز.
الحرية هي الروح، لا الجسد الذي يستعبِد الإنسان في أغلب الأحيان. ونحن نبلغ الحرية لا عن طريق الإنكار الزاهِد أو عن التمجيد الطبيعي للجسدية، ولكن عن طريق “الجوانية” حيث لا يكون أي جزء من طبيعة الإنسان خارجيًا بالنسبة إليه.
… الجنس الذي لا يتكامَل ويسمو عن طريق الروح يكون شاهدًا دائمًا على خضوع الإنسان للنوع.
أما عن الكتَّاب الزاهدين المتصوفين فقد هزَّني “إسحق السوري” وأثَّر في نفسي تأثيرًا شديدًا.
أما العالَم فكان، بالنسبة لي، مصدرًا دائمًا للعذاب، وكنت أرى الإنسان محرومًا من الاعتراف به، مهانًا مدنسًا في هذا العالَم وبواسطتِه، وكنتُ أراه وقد نزلت به ضربة فاجعة، ومع ذلك مطلوب منه أن يُبدِع، وأن يكون قادرًا على الإبداع.
والحق أن الروس لم يفطنوا من قبل بمثل هذه القوة إلى المجهول اللامحدود الذي يحيط بالحياة الإنسانية، وإلى السر والهوة المخيفَة التي يواجَه بها الإنسان. بيد أن هذا كان يوشِك في بعض الحالات أن يكون اتخاذًا لوضع معين، بحيث أصبحَت كلمات “السر” و”الهوة” مجرد كلمات تخفي خواء داخليًا آخِذًا في النماء.
لم أكن أشعر بالراحَة قط عندما أتخذ موقفًا باطنيًا بحتًا إزاء الحياة، بل كنتُ أناضِل دائمًا لأصِل إلى ما هو عبر الحياة، ولكي أتعالى عليها باعتبارها مجرد حقيقة خارجية. وأيًا كان الأمر، فإن معرفة المتعالي هي في حد ذاتِها تجربة روحية باطنية.
وحتى وأنا طفل، كان لدي فهم مبهم للحياة الدينية على أنها مملكة الوحي الروحي الداخلي الذي إن أحيل إلى الخارج، فقَدَ طابِعَه الأصيل، ولا يصنع الوحي التاريخي أكثر من أن يجعل من سر الحياة رمزًا، وأن يعكس الحالة الناقِصَة لوعي الإنسان وبيئتِه الاجتماعية. إن له وظيفة العلامة، وهو يدفَع الإنسان بعيدًا عن الدلالات الخارجية إلى الشيء المدلول عليه.
كلما دخلت كنيسة قوطية استبدّ بي إحساس غريب بأنني أعيش مرة أخرى تجربة عانيتُها في وجود سابق، ولم يفارقني هذا الإحساس خلال حياتي كلها “بيد أني لم أستطع له تفسيرًا قط”.
كان الدافع الديني الأصيل مرتبطًا عندي بإحساس أليم بالامتعاض والاختلاف عن العالَم بما فيه من شر وفساد، وفي ذلك إشارة أولى إلى اعتقادي التالي بأن وجود الشر ليس عَقَبَة تعترِض الإيمان بالله، وإنما الشر برهان على وجود الله، وتحدٍّ للعودة إلى من ينتصِر فيه الحب على البغض، والاتحاد على الانقسام، والحياة الأبدية على الموت.
غير أن الله الروح، وهو يفعل داخل نظام الحرية، لا في نطاق الضرورة الموضوعية، ولا يمكن أن يُفهَم نشاطه بالمصطلَح الطبيعي. وهو ليس حاضرًا في الأشياء والحوادث الخارجية التي نلصِق بها أسماء إلهية، ونصور لها غرضًا إلهيًا، أو في قوة هذا العالَم أو قواه. بل في الحقيقة والجمال والحب والحرية والإبداع.
أما إذا وجد الله، فالإنسان كائن مستقل استقلالاً روحيًا، وينبغي تحديد علاقته بالله على أنها حرية.
إذا كان علم الأساطير يمثل محاولةً للتعبير عن حقائق الدين، وتوضيحها فإن التجربة الدينية نفسها تصدر عن اتصال حي مباشَر بالسر النهائي، وهذا هو مجال التصوف. وعندما استيقظَت اهتماماتي الدينية ألفيتُ نفسي منجذبًا بغريزتي إلى التصوف.
… كما استرعَت انتباهي أيضًا الوحدة الكامنة وراء التجربة الصوفية بغض النظر عن الاختلافات الطائفية، وهي وحدة تغوص إلى الأعماق أو تعلو على مجال الدقة القطعية والتباين المذهبي.
الحق لا يهبط علينا من عل، كما أنه لا يغشى العين كما يغشاها موضوع مرئي محسوس. الحق طريق وحياة أكثر من أن يكون حقيقة موضوعية تنهَض إزائي.
هناك حقيقة مسيحية أبدية تعلو على الزمان والمكان، غير أن هذه الحقيقة ذاتها، كما تتكشف في التاريخ، وكما ترتبط بمرحلة معينة ومجموعة معينَة من الظروف، وقد أخذَت تقترِب من نهايتِها، وهذه النهاية تطبع في الوقت نفسِه حكمًا على التحقق التاريخي السابِق للحقيقة المسيحية، وعلامَة على التحققات المقبِلَة الأخرى.
بيد أن فكري يضرب بجذوره عميقًا في فعل أصلي من أفعال الإيمان، وما من شيء أو إنسان يستطيع أن يزعزع هذا الإيمان، فهو عبر جميع العلاقات العقلية الخالِصَة، ولا أستطيع أن أعطي عنه تعبيرًا معادِلاً له. وإني لأرى نفسي مندمِجًا في أعماق الوجود الإنساني، واقِفًا في مواجَهَة سر العالَم الذي يفوق كل وصف وإزاء كل ما هو موجود. ومن هذا الموقِف، أشعر شعورًا حادًا محرقًا بأن العالَم لا يمكن أن يكون مكتفيًا بذاتِه، وأن ثمة معنى غامضًا متعاليًا مازال مختفيًا في أعماق أبعد غورًا من ذلك. وهذا المعنى هو الله، وقد عجز الناس عن العثور على اسم أسمى من ذلك، وإن كانوا قد أساؤوا إليه إلى الحد الذي كاد فيه ألا يكون منطوقًا. وليس من الممكن إنكار الله إلا من السطح فقط، ولا يمكن إنكاره حيث تغوص التجربة الإنسانية تحت سطح الوجود العادي التافِه المُبتذَل.
لقد بحثت باستمرار خلال تطوري الديني كله عن الاتصال الروحي بالآخَرين، مُدرِكًا الأهمية الشديدة التي تتسم بها الصلات مع الرجال والنساء الآخَرين. والحق أن الاتصال الروحي بالآخَرين، منبَع خالص جدًا من منابِع المعرفة الدينية، ومن خصائص الحياة الدينية أن الإنسان المشارِك فيها، سيتغلَّب على عزلتِه، ويدخل في اتصال روحي مع غيره من الناس.
وقد قصَّ عليَّ “أكيموشكا” ذات مرة حادثًا هامًا وقع له في حياتِه. كان راعيًا صغيرًا، وكان يرعى أغنامه ذات يوم عندما استولَت عليه فكرة مباغتة بأنه لا وجود لله. وحينذاك أظلمَت صفحة السماء، وغاص في الغياهب، فأحس بأنه إذا لم يكن الله موجودًا، فلا يمكن أن يوجد شيء على الإطلاق، ولن يكون هناك غير الظلام، والخواء المُطلَق. ولما أدرك أن الوجود نفسَه أخذ يتقلَّص في الفراغ، وأنه أُلقِيَ إلى أعماق العدَم، لمح بصيصًا مباغتًا من النور طفق ينمو وينمو مستوليًا على قلبه، وعقله، فأصبح في وعي بالله مرة أخرى، وتحوَّلَت الظلمة إلى نور يشمل كل شيء، واستردّت الأشياء جميعًا واقعَها الأصيل.
وإني لأذكر حلمًا – ولعله أعظم حلم زارني على الإطلاق – يمثل شيئًا من رحلة الحج الروحي التي قمتُ بها. شاهدت في هذا الحلم ميدانًا واسِعًا، تكاد لا تحدُّه الحدود، وقد نصبت وسط هذا الميدان موائد خشبية مغطاة بأفخَم أنواع الطعام، وأُحيطَت هذه الموائد بأرائك خشبية مستطيلة، كأنما سيُعقَد به مجمع مسكوني، واقتربت من الموائد، وأردت أن أجلس على واحدة من تلك الأرائك حتى أشارك في شؤون المجمَع، وأتصِل بالآخَرين الذين أوشكوا على المناقشة، والذين تعرفت بينهم على كثير من أصدقائي الأرثوذكس، ولكن كنت حيثما حاولت الجلوس يخبرونني أنني أخطأت المكان، أو أنه لم يعد لي مجلس أستقر فيه، فأخذت أدور حول المكان ولمحت في نهاية الميدان صخرة خشبية جرداء. فذهبت إليها، وشرعت أتسلقها، بيد أن محاولاتي الأولى للقيام بهذا العمل أظهرتني على المصاعب الفظيعة التي تنتظرني في صعودي ومضيت في محاولتي رازحًا تحت الإجهاد والإرهاق، ورأيت يدي وقدمي غارقة في الدماء. ولما بلغت ارتفاعًا معينًا تلفتُّ حولي، ونظرت إلى جانبي وإلى أسفل، فلمحت طريقًا ملتويًا مجهدًا، أخذ يصعد فيه عدد من الناس. وواصلتُ كفاحي باذلاً جهودًا أليمة لارتقاء الصخرة، وفي نهاية الأمر بلغت القمة، وفجأة شاهدت أمامي المسيح مصلوبًا، وقد أُثخِنَ جانبُه بالجراح، وأخذَت الدماء تسيل منها، فارتميت عند قدميه، وقد هدّني الإعياء، كدتُ أفقد وعيي.
بيد أنه لابد من وجود لحظة أحسست فيها بنفسي مسيحيًا، وإن لم أكن قادرًا على أن أحدد لها يومًا معينًا في حياتي. وإني لأذكر تجربة واحدة انتقلت إلي فيها معرفة عجيبة ونور غريب: حدث ذلك ذات صيف في الريف، ففي لحظة من لحظات القلق والضيق الشديد خرجت إلى الحديقة ساعة الغسَق، وكانَت سحب كثيفة تخيِّم على الرؤوس والظلال تهبط على الأرض عندما اشتعلَت روحي بغتة بنور محرق…!!
بيد أن هناك تجربة دينية أخرى تعرف السر الإلهي الإنساني الغامِض لإله يتوقع من الإنسان تلبية جزئية خلاَّقَة لندائه. وهذا يضع على عاتق الإنسان عبئًا أعظَم إلى غير حد. ومسؤولية أكبر مما يمكن أن يواجهه أي تصور للقانون وتحقيقه. ونصل إلى ذروة الجسارة في إدراكنا بأنه لا تتوقف على الإنسان الحياة الإنسانية وحدها، بل والحياة الإلهية كذلك.
الإبداع هو نفسه تبريره الخاص المستمد من وجود الإنسان نفسه إنه ما يؤلف علاقة الإنسان وتجاوبه مع الله.
إن فكرة الله هي أعظَم فكرة إنسانية، وفكرة الإنسان هي أعظَم فكرة إلهية. والإنسان ينتظر مولد الله في نفسه، والله ينتظر مولد الإنسان في نفسه.
وفي رأيي أن القدرة الخلاَّقَة ليسَت “إقحامًا” في المتناهي، وليسَت مسيطرة على الوسط، أو الإنتاج الخلاَّق نفسه، بل هي بالأحرى التجاء إلى اللامتناهي، وهي ليسَت نشاطًا يقوم بالإحالة الموضوعية في التناهي، وإنما نشاط يعلو على المتناهي متجهًا صوب اللامتناهي. والفعل الخلاَّق معناه الوجد أي النفاذ صعدًا نحو الأبدية.
وأستطيع أن أذكر كيف استبدت بي فجأة، في يوم من أيام الصيف، قبل بزوغ الفجر، قوة عاصفة وكأنها تنتزعني انتزاعًا من قِبَل ذلك السر الغامض الذي أسلمتني إليه حالتي القانطة، وغمر النور كياني. وعلمت حينئذ أنه نداء واحد للإبداع، ومن الآن فصاعِدًا سوف أبدع من حرية روحي كما فعل الصانع العظيم الذي أحمل صورته بين جوانحي.
وقد كان الشيء الذي أُلقِيَ على عاتقي في هذه التجربة باعتباري مسيحيًا هو تحقيق عمليتين تبدوان متنافرتين في الظاهِر، ولكنهما في الواقِع تكمل إحداهما الأخرى بمفارقة من مفارقات الحياة، وإحدى هاتين العمليتين فدائية، والأخرى خلاَّقة. وقد أدركت المغالَطَة الكامنة وراء دين فدائي بحت. ذلك أن الإنسان لا يتغلب على ضغط المؤثرات الخارجية عليه واستعبادها له إلا بالفعل الخلاق.
ثمة رابطة حميمية بين الإبداع والتأمل، وإن يكن الميل الشائع إحلال التعارض بينهما. وينبغي ألا يُفهَم التأمل على أنه حالة سلبية مطلقة أو استقبالية، إذ يضمُّ التأمل عنصرًا إيجابيًا وخلاَّقًا متميزًا. وهكذا نرى أن التأمل الاستطيقي للجمال الطبيعي هو أكثر من حالة: إنه فعل، وانطلاق إلى عالَم آخَر. والجمال هو حقًا ذلك العالَم الآخَر الذي يكشف عن نفسه في عالمِنا، والإنسان في تأمله للجمال يخرج لتلبية نداء ذلك العالَم الآخَر.
المصدر الوحيد للمساواة الاجتماعية الحقيقية توجَد في الاعتراف بكرامة الشخص الإنساني وقيمته.
الشيء الوحيد الذي لستُ على استعداد لإنكاره في هذا الكتاب هو أنني كتبته نتيجةَ اهتمام شديد بالحرية ضد نزعة المساواة الروحية، والاجتماعية، وهي النزعة التي أطلقتها الثورة وحكم “الإنسان العادي” و”العقل الجمعي”. ودافعت عن تلك الحقيقة الواضحة ألا وهي أن المصدر الوحيد للمساواة الاجتماعية الحقيقية توجد في الاعتراف بكرامة الشخص الإنساني وقيمته.
لقد عارضت الشيوعية لأنني أومن بالحرية. بالاستقلال النهائي للشخص الإنساني في مواجهة النظم الاجتماعية والسياسية كافة. وقد تكون الحرية ما برحَت مكبَّلَة في الواقع بآلاف القيود إلى حكم الضرورة. غير أن الشيوعية من حيث أنها تضع قانون ذلك الحكم بتصرُّف وتتصرَّف تبعًا لذلك، فإنها تعرض المبدأ الحي للحرية والشخصية للخطر.
أما أنا فلا أشتهي شيئًا أكثر من تخطي العقبات التي تعوق تحرري من هذا العالَم إلى حرية عالَم آخَر.
ومن أبرز الشخصيات التي ظفرتُ بصداقتِها في المنفى “الأم ماريا” التي قضَت نحبَها في حجرة غاز بأحد معسكرات الاعتقال الألمانية، ويبدو أن حياتها ونهايتها الفاجِعَة تعكس مصير عصر بأكمله، وقد كانَت تتجسَّد فيها سائر السِّمات المميِّزَة للقديسات الروسيات، وفوق هذه السمات جميعًا تضامن شامل مع آلام العالَم وعذاباته، واستعداد باسِل للتضحية بنفسها في سبيل أخوانِها في الإنسانية. ويُعدُّ مصرعُها الذي كان إنكارًا خالِصًا للذات من أجل امرأة يهودية لا تريد الانفصال عن طفلها. وهي على وشك الموت في حجرة غاز – تعد هذه الوفاة صفحة من أعظم الصفحات البطولية في سجلات الحرب الجهنمية.
العالَم الذي أُحيلَ إحالةً موضوعية ليس هو العالَم الحقيقي الواقعي، بل مجرد حالة لهذا العالَم الحقيقي الذي انبثق ذلك العالَم الأخير للتغير. فالذات تنتج الموضوع، والذات وحدها هي الواقعية “الوجودية” والذات وحدها هي القادِرة على معرفة الواقِع.
والعالَم يوجد حقيقةً في الذات التي لم تخضَع للإحالَة الموضوعية. الواقع الأصيل هو الفعل الخلاَّق، وهو الحرية، وحامِل الواقِع الأصيل هو الشخص، وهو الذات، والروح… والموضوعية معناها استبعاد الروح للأشياء الخارجية، وهي نتاج التفسخ، والانفصال والغربة والعداء. وتتوقف المعرفة – وهي نشاط تبذله الذات – على الاقتصار على الانفصال والغربة، وعلى مدى الاتصال الروحي وشدته وفي المعرفة الحقة يتعالى الإنسان على الموضوع، أو بالأحرى يملك الموضوع امتلاكًا خلاَّقًا، بل الحق أنه يخلق بنفسه. والواقع يثرى بالمعرفة.
وللمسيحية الأخروية تأثير، بل ينبغي أن يكون لها تأثير الثورة على المسيحية التاريخية، لأن هذه المسيحية التاريخية قد كيَّفَت نفسَها مع العالَم، وأسمنت نفسها عليه… غير أن العالَم الأخروي ليس دعوة للهروب إلى جنة خاصة، بل هو نداء للتسامي، بهذا العالَم الشرير المنكوب.
قد يكتسِب الإنسان الذي اجتاز تجربة العذاب، معرفة جديدة: والحق أن كل معرفة مؤلِمَة.
ليسَت العناية الإلهية فاعلاً يمكن قياسه بالمصطلحات الطبيعية بل شيئًا نحياه في أعماق الروح الإنساني الحر.
… غير أن صورة المسيح الصادِقَة تتعالى على الصورة التي تتضمنها الأناجيل، إذ تقدم هذه انكسارًا للصورة في مرآة التحديدات الإنسانية المعتمة.
إني لأعتقِد أن أعظم ثورة أحدثتها المسيحية هي الكشف عن إنسانية الله.
وما من أحد استطاع أن يعبِّر هذا التعبير اللاذع عن مأساة الكلمة المنطوقَة كما فعل “تيوتشف” حين يقول:
كن صموتًا، واحجب نفسك، دع أحلامك
وأشواقك تشرق وتغرب في حنايا قلبك،
اطرح كنوزك جانبًا، حتى تتمكن نجوم الليل العميق
من النفاذ في بهجة إلى روحك
كيف يستطيع الفؤاد أن يجد التعبير عنه؟
وكيف يستطيع إنسان أن يقرأ ما يجول بعقل غيره،
أو أن يعرف شخص آخَر ما به تعيش؟
الفكرة المنطوقة ليسَت غير أكذوبة،
وإذا تحركت، عكَّرَت ماء الجدول
فاغتذ على أحلامِك،
ولا تحرك ساكنًا
عش في نفسك، فهناك عالم بأكمله
من الوجود يموج داخل روحك
عالَم من الفكر، والأفكار المسحورة
غير أن الضوضاء التي تنبعث من الخارج
تصيبها بالصمم…
ووهج النهار يصيبها بالعمى، فتنقطع
أغانيها… أوه… أسكت، وأنصت!
وقد كنت أعلم علم اليقين أن قوة عليا تراقب حياتي وترشدها كلما تهددها خطر عظيم.
وتنبع كل من الواقعية الحقيقية، والمثالية الحقيقية من الاعتراف بالسر الكامن تحت هذا العالَم وعبرَه.
إن كل فعل إبداعي حقيقي يدخل ملكوت الله.
لا شيء يمكن أن ينقذ العالَم من حالَة الغربة في نهاية الأمر غير الله.
قد يكون الموت انتصارًا للحب والتضحية بالذات، والإنسان يشقُّ عليه أن يواجِهَ سرَّ الموت، ولكنه يدرِك في نهاية الأمر أن الموت ينطوي على سر فريد هو الحب النابِع في الحياة الأبدية. ولابد من أن نفقد الحياة لكي نظفر بها ظَفَرًا كامِلاً، والحب والموت لا ينفصِلان، غير أن الحب أقوى من الموت ولهذا يستمر في الموت الاتصال الروحي بهؤلاء الذين نحبهم بل إنه يزداد توثقًا، وذلك لأنه اجتاز تضحية الحب العظمى التي هي الموت. الموت حادثة في الزمن، وعلاقة على صَوْلَةِ الزمان على الإنسان، بيد أنه حادثة تضعه وجهًا لوجه إزاء الأبدية حيث ينتصِر الحب والقرابة على الغربة والانفصال… ولماذا تحمل الوجوه الميتة لمحة من جمال غريب؟ أعتقد أن الأمر كذلك لأن الموت هو لحظة التنوير العظمى، ولأن الإنسان يتحرر في الموت من ملامحِه الفظَّة القبيحَة، ولأن الموت إيذانٌ بالتحول السامي.
ترجمة: نبيل سلامة