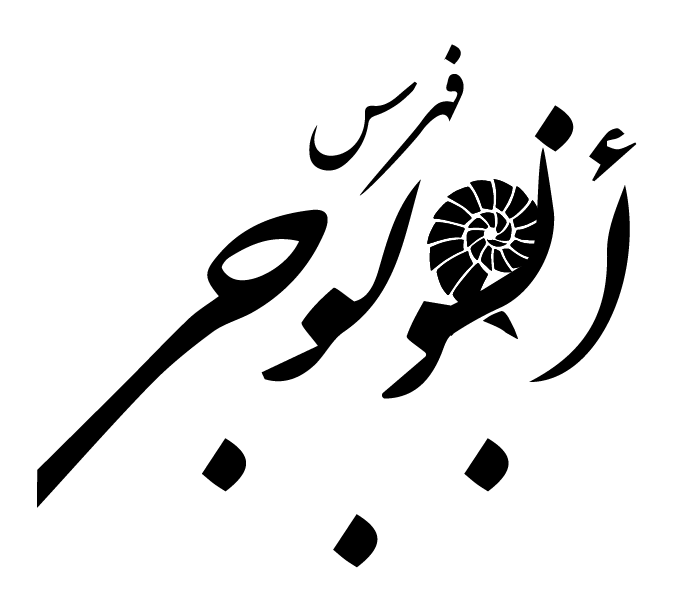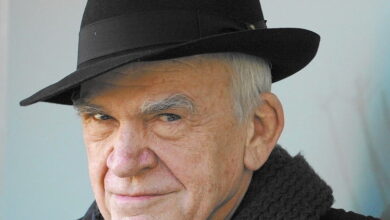عندما يأخذني أحدٌ إلى مكاني الأول، أو آخذ نفسي إليه، أبدأ في كل مرةٍ بتفحص عواطفي وتحريك ذهني لإيجاد الصلة بيني وبين تلك البلاد، وأتساءل عن سرّ هذا الامتداد في الزمن الذي يوصلني، حتى الآن ببقعةٍ من الأرض ابتعدت عنها قرابة ستة عقود، ونأيت عنها ماكثاً عقوداً في هذه المدينة أو في تلك المدينة، في أماكن أخرى بعيداً عن مكاني الأول.
المكان الأول، عندما أبحر فيه تتحول الأماكن والصور والأشياء إلى عناصر سحرية، كما يحصل في الكيمياء، فنتخذ تلك مدلولاتٍ وصيغاً عاطفية وفكرية تؤثّر في ذهني وتدفعني إلى استنتاجاتٍ متضاربة، أمتلكها مرةً وتمتلكني مرة، أقبل بها لأراها في المسافة، كما لو أنها تغطيني بطبقةٍ من حشيش، وأحياناً أرى تلك الأزمان بنظرةٍ أخلاقية أو من خلال امتثالٍ أيديولوجي لتلحّ عليّ أن أرى وفق منظورها فأحدد بها موقفي من الزمان، فأرى بذلك مكاني الأول مجرّداً مني وأنا خارجٌ عنه، وأعني بذلك أن أُسيّرَ لها عاطفةً محدودةً مسماةً: أن أحب أو أن أكره ذلك المكان.
أن أنتقد المكان هو أن أستخلص من حياةٍ متكاملةٍ مشبوبةٍ بالتفاعل جزءاً منها وهو موقفٌ يحطُّ من شأن المكان، وهو كذلك تناقضُ يبعث الارتباك في النفس، لكنه أيضاً –هذا الارتباك- وشيجة الارتباط بالمكان الأول، يحاول دائماً أن يستنفذ كنهه، يتلوّن في كل مرةٍ تعود بنا الذاكرة إليه، أو يعود إلينا، يبزغ قوس قزحٍ من أفق الماضي ليحنو على المرء الذي يمسك زمنه ومكانه الأول في قلبه الذي ينبض ويفيض به.
إذن فالمكان تلك الكلمة السرية والمعقدة الممتلئة بالطلاسم، يجعلني بالرجوع إليه أستغرب من قوة جذبه وقدرته على وضعي أمام محاكمة الذات، وقبالة فحص الضمير، والتشكك في صياغات العقل المجرّد الناجزة، وهل ثمة قوة أشدّ من قوة المكان –ليس أي مكان، وإنما المكان الأول- الذي أطلق فينا العاطفة وأشبعنا بالرؤية والرؤى، وعمل بسريةٍ على إطلاق وعينا وتقديم عواطفنا بحيث كبرنا واغتنينا به وبها، وشكّل جزءاً كبيراً منا.
ولكن خارج ما تثيره الذاكرة لدى استعادة الأماكن والأشخاص والصور والأشياء، من دون محاكمتها عقلياً في سياق المنطق والمقارنة، تبدو العلاقة بيننا وبين المكان صعبةً وشائكة، علاقة غير واضحة المعالم، تتخذ كل مرةٍ في الرجوع إلى المكان معانٍ وإضافات وحيوات مغايرة ومختلفة، فهي –العلاقة- تغتني وتتفاعل ونغتني بذلك، وبتفاعلها في دواخلنا بتفاصيلها، نغذّيها وتغذّينا على الدوام، ولأن تلك العلاقة مستمرة في تفاعلها وهي تنمو باستمرار، فهي صعبة التحديد ومبهمة الصورة، وبالتالي من الصعب أيضاً تحديد تلك العلاقة وتوصيفها، لكنها بالأكيد ضرورية لإبقاء التفاعل بيننا وبين المكان قائماً ومتواتراً على نحو عضوي وخلاق.
(1)
قضيت ما يزيد على أربعة عقود من الزمن بعيداً عن مكاني الأول “كركوك”، وأكثر من ثلاثة عقود عن بغداد. ولكن البلاد ما زالت تمثل عندي إشكاليةُ لم تنتهِ إلى الحل، بينما تفاعلت بقدر المدة مع مدن وبلدان أخرى، برجاحة عقل وفطنة، بجدلٍ وبوعي، فدخلت كما أظن أعماقها، فعلت بي وغيّرتني وملأتني، سيّرت لي تجارب غنية في الرضى وفي الخسارة، وأحالتني أحياناً عبر المغامرة إلى شحاذٍ وإلى بطل، مثلما أحالتني إلى متواطئ، وأدخلتني السجون، لكنها أبقت ذهني قادراً على التمييز يقبل هذا ويرفض ذاك، وأوقفتني أمام ذاتي لأحاول التطهّر، وأحسب كل هذا محاكمةً وحصاراً للذات التي تحذر من الحياة وتريد الملائمة معها، إلا أن مكاني الأول مكث في غمرة تداخل الأماكن والأحداث يلحّ علي أن أكتشفه وأن أُسيطر عليه، وقد أصبح في كثيرٍ من الأحيان إدماناً على المؤاخاة بيني وبين ما تركه زمن الطفولة من عالمٍ مفتوحٍ لا رقابة فيه، ومن دون حذرٍ كان ممنوحاً للدهشة ومفتوحاً للامتصاص في خلايا الذهن وفي نسيج القلب، وربما أصبح بمثابة نوستالجيا يأخذني في طريقه إلى وعيي وإلى حلمي دون أن أستطيع منعه من السفر إليّ أو السفر إليه.
في ابتعادي عن البلاد كان يلحّ عليّ دوماً المكان الأول، طوال تلك العقود، عندما يذكّرني به أحدٌ ما ويضعه أمامي، أو يثير فيّ صوره ويشجّع هوى أوقاتٍ معينة لكي أحاول استعادة تلك الصور وفك رموزها السحرية، سواءً كانت صور أوقاتٍ مشبوبةٍ بنار العواطف والمعرفة أو كانت صور الانكسار والضعف، وربما هذه الاستعادة هي التي حفرت في رأسي عميقاً تلك البلاد، دون أن أتيقّن من حبي أو كراهيتي لها، ومن غير محاكمةٍ خاضعةٍ لمنظومةٍ من الأفكار تبقى البلاد مكاناً مضافاً إليّ، وأنا مضافٌ إليه، بمعنىً آخر، نحن نشكل معاً وحدةً متمازجةً لا مجال للانفصام فيما بيننا، نحفر في بعضنا البعض، وتضيف كل مرةٍ بالرجوع إلى تلك الأزمان إرثاً جديداً ومزيداً من الحب.
أعتقد بأن العاطفة إشكاليةٌ معقدةٌ تواجه المرء، تُحدث فيه وبه، ليس في تمثّلها بل في جوهرها، وهذه الإشكالية التي تريد الحل تغذي العاطفة الإنسانية على نحوٍ دائمٍ طالما المرء غير قادرٍ على تأميم وحل تلك الإشكالية وقطع الأسئلة بشأنها وإنهاء تناقضها في داخله. وتتخذ الإشكالية مادتها واستمرارها من التناقض والتضارب القائم في العالم الذي تواجهه الذات الناقصة والتي تريد وتلحّ على الامتلاء، الذات التي تواجه العالم وتتفاعل معه وتنتقي منه ما يتفاعل معها، لذا فإن إحالة العاطفة إلى مفرداتٍ مجردة ومحددة وجاهزة للتعريف، مثل الحب والكراهية والعطف والتآلف… إلخ، إنما هو إنكارٌ للعاطفة ذاتها وإيقافٌ لديناميتها، العاطفة، من ثم، احتدامٌ وتفاعلٌ معقدٌ يجري في الإنسان، مع نفسه ومع ما يحيط به، هي التي تكوّنه وتقوده إلى عمل الذهن والوعي –الذي يتغيّر دوماً ومكونات الوعي معقدةٌ ومتداخلة، ولكي أحسب أن ماكينته هي العاطفة التي تميّزه عن غيره من الأشياء، وهكذا فإن العاطفة في جوهرها المحتدم لا تقبل التأويل، ومن الخطأ تحديدها.
هذا ما أحسه في داخلي، حينما أكون في صحوي، وهذا ما أتلمسه حينما أبتعد عن عالم الوعي، عالم الفكر والمؤسسات التي جعلتنا أن نكون جزءاً منها لنحيل عواطفنا وفقها.
أن أسوق المواقف وأبدأ بنقد حياتي في المكان الأول وأقاوم جوهر عواطفي إزاء أولئك الناس والأشياء والأحداث، واضعاً إياها في سياق الزمن وفي إطار المكان وفق منطق منظومةٍ من الأفكار، إنما هو اختزالٌ وتشيٌّ للسر الذي جعل الإنسان محوراً للعالم، متمكناً وقادراً على كل هذه الإضافات على معنى الحياة، لكي تكون هذه الحياة قادرةٌ على أن نعيشها ونتفاعل معها، وبإلحاحٍ نريد كشف أسرارها.
(2)
إن أشكال الكتابة منذ الأساطير الأولى ومنذ بدء الحرف والكلمة، لم تكن إلا محاولات لمعرفة سر الحياة، الذي هو في الواقع سر الإنسان في المكان- بأشيائه وبزمنه-، ذلك الإنسان القادر على توليد الحلم وخلق الوهم وتحديد وتفسير الزمن وفق ما يحسه أو يتلمّسه، وللمكان طاقةٌ يمنحها للاستشراف وفتح آفاقٍ عديدة أوسع مدىً وأعمق من مجرد الإحاطة به أو الحفر فيه، للتعرّف على البنية المعقدة التي تتشكل بين الفرد وبين المكان، وربما للمكان من معنى أوسع من وجود الطبيعة والأشياء والناس، بعلاقاتهم الاجتماعية وبتراثهم وثقافتهم وبأسرار روحهم الخاصة التي تشكّل جميعها مزيجاً متفاعلاً في الإنسان الذي لا يصل في معرفته إلى الإحاطة بكنه كل تلك العناصر التي تكوّنه وتتفاعل في داخله لتشكّل نسيجه الخاص به، النسيج الذي يختلف بالتأكيد عن نسيج شخصٍ غيره، بمعنىً آخر، كل ذاتٍ تملك صفاتها الخاصة ومكوناتها المعقّدة، حيث لا يمكن لذاتٍ أن تكون نسخةً من ذاتٍ أخرى، إنه سرٌ غريبٌ، سر هذا الاختلاف والتفرد ما بين أُناسٍ يعيشون حتى في ذات االمكان، كل واحدٍ يغرف في الواقع من بحر المكان، ويحمل من زبد ذلك البحر، كلٌ يرى موجه وينزل شاطئه، ولكن كل واحدٍ يمتلأ على نحوٍ مختلفٍ عن الآخر من ذلك البحر المفتوح أمام العاطفة.
(3)
مكاني الأول، كان في “كركوك”.
وكركوك، خارج مواصفات مدينةٍ ما، كانت بالنسبة لي كوناً يؤلّف مفاتيح وأقفالاً، بحاراً عميقة القاع، وماكينة للحياة، ليلٌ تجيء إليّ نجومه لتفاتحني بأسرارها وبولائمها المضيئة، تجلب ملائكتها وتطلق أرواحها المبهمة لكي تحاورني وأحاورها.
أراها الآن بعيدة، في سفر، أحاول دوماً أن ألتحق بإحدى عرباتها الذهبية لكي أصل عرشها، مسافرةً تطلب مني أن أراقبها من خلال الضباب، أو من خلال تراب العاصفة التي تحمل رمل الأرض وصخور الجبال.
لا أعرف ماذا أحدَثَت المدينة –مكاني الأول- فيّ، وذلك في السنوات الأولى من عمري، ولكنني أستنتج بأنها كانت سخيةً معي في تسيير الرؤى وفي إثار الدهشة وفي طرح الأسئلة التي ملأتُ بها نسيجي الطفولي آنذاك، لم أقف ممانعاً، أو مستنكراً، لما كانت تقدمه لي تلك المدينة، لم يكن لي اعتراضٌ على قسوتها أحياناً، وعلى أساطيرها التي تُهبط روحي إلى القاع من الخوف والوجل، ولم أستنكر براءة طفولتي أمام رجال يعصرون الحياة لكي يعيشوا، فيبدون مثل عمالقةٍ تكسّرت عظامهم وعرقت وجوههم بالنار.
كنت مفتوحاً على كل شيء، مثل بابٍ واسع، دون رأيٍ ومن غير محاكمة، وحينما كنت أكبر فتنهار أمامي أعمدة العالم والأسرة ومُثل المجتمعات وروابط العلاقة وقيم الجمال، كنت أحس بأن العالم هو هكذا لأستنبط منه سر العمر ومعنى الزمن.
وهل يمكن القول بأن الوعي الذي قدّم لنا العالم، فيما بعد، بضمن مواصفاتٍ وتحديداتٍ قد خرّب فينا الرضا، وهل للزمن الذي عرفناه بقسوةٍ، وهو يمضي إلى نهايته، تأثيرٌ على التناقض وعلى الشعور بالانكسار الذي نواجهه في أحايين كثيرة ليأخذ منا البهجة أينما نذهب وحيثما نحلّ.
ربما هو الاقتراب من النهاية، يقطر سمه على رضانا وعلى بهجتنا ويخمد تفاعلنا لكي يؤسس فينا، على المدى الطويل، استعداداً لمواجهة المصير.
ماذا أستطيع أن أكتب عن مكاني الأول –كركوك، وقد كبرت وأخذت أحاكم الأشياء-، تحولت إلى “رجلٍ فطنٍ راجح العقل” أتعامل مع قوانين العالم والمجتمع، ولا أقدر على أن أحيا خارج بؤرته المغناطيسية.
لم يعد لي، وأنا بعيدٌ عن الطفولة –عن الحياة الأولى الحرة والمنفلته من قبضة التحديد- إلا الامتثال للحلم وللوهم لأدافع بهما عن نفسي وأُطلق الهوى منّي ليتنقّل هنا وهناك، يعود أحياناً إلى مكاني الأول ويأخذني معه.
قد تبدو كركوك الآن مدينةً أشبه بمدنٍ أخرى كثيرة، بل يمكن مقارنتها والحطّ من شأنها، والبدء باتهامها، لكنني لا أريد ذلك، فهي مكانيَ الأول الذي أنزّهه، وليس بوارد أن أحاكمه وفق منظورٍ عقلانيٍ أو أخلاقي، أومن خلال منظومةٍ من الأفكار التي تريد التحديد والتغيير.
لا تريد الطفولة أن تُحدّد وتُنتقد، إنها تريد المواجهة والمعانقة والاكتناز بالحياة، وأن تجمع الأسرار التي يطلقها المكان لتكون ذخيرةً للغبطة، لذلك، أنا الآن، عندما أُريد الإحاطة بكركوك، ربما أختزل التجربة الدينامية التي كانت تتفاعل آنذاك بيني وبينها. حيث لا يمكن تكرارها، وهل يمكن لرجلٍ هاجر الطفولة أن يعود إليها؟!. ومع ذلك فإن الكتابة عنها مغرية، وهي محاولةُ للاقتراب منها.
(4)
كركوك مدينةٌ قديمةٌ أُنشئت قبل التاريخ الميلادي بقرون، في سهلٍ يتوسط الأراضي المتموجة التي يبدأ بها الشمال العراقي، كانت روح المدينة قلعتها الترابية العالية الواسعة، أقيمت داخل أسوارها الحارات والأماكن، بقايا أسوار القلعة ومداخلها القديمة لا زالت قائمة، تنزل منها بطرقاتٍ وسلالم عريضة إلى كركوك التي أُضيفت إليها مع الزمن. وتختصر المدينة العصور بحيث يمكن تأمّل البابليين والآشوريين، مثلما تتأمل الأتراك العثمانيين والصفويين والفرس، كل هذه الأرواح تعيش في المدينة القديمة وتحمل آثارها وأساطيرها. وعندما تزخ الأمطار على أطراف المدينة تظهر للعيان لُقىً من خزفٍ قديمٍ مهشّمٍ وتماثيل صغيرة تحدق، ربما، بنقاط السيطرة العثمانية على رؤوس بعض التلال المحيطة بكركوك. وثمة مخافر موزّعة بين الجبال المحيطة يمكن للمرء أن يتأمل الجنود العمالقة الذين هُزموا وجاعوا في “سفر بر” فدخلوا الأزقة منكسرين يلتسمون الصدقات لسدّ رمقهم.
قلعة المدينة حاضرة، قلّما يفكر قاطنوها بتحوّلات التاريخ، لقد أصبحوا جزءاً منه، بل هم يصعدون السلالم إلى المرتفع الذي يضم آلاف البيوت والشوارع الضيّقة وحاراتها المتسمة بصفتها الخاصة التي تجمع أسماء المهن والقوميات والأديان والطوائف، مثلما تجمع أسماء الأساطير والأنبياء. تصعد إلى القلعة لتدخل “يدّي قزلر” –البنات السبع وحارة الحلوانيين والحجّارين والصفّارين والبنّائين، وإلى “بريادي” و”جقور” ، وإلى حارة النصارى واليهود والعرب وعقد الأكراد، هذه الأقليات المتعايشة وتلك المهن المستمرة منذ قرون بنت ملامح مدينةٍ عتيقة، ثم وسّعتها لتضفي عليها ملامح خاصة، قد لا توجد في غيرها من المدن.
عند أقدام القلعة يجري نهرها، ويسمى بلغة أهلها “خاصه صو”، وهو نهر “العظيم” المتكوّن من فروعٍ عديدة يغذيها بالمياه ثلج الجبال وسيول الأمطار المنحدرة من الشمال ومن الشرق الجبلي البعيد.
نهر كركوك ماردٌ وملاكٌ في نفس الوقت، يهدر في الشتاء وبداية الربيع القصير، ويجف في الصيف إلا من جداول صغيرةٍ تسعى بين الحصى بماءٍ رقراق، نهرٌ أحمر المياه من جرّاء انجراف التراب الأحمر من الجبال، ويقف معظم الناس ليراقب غضب النهر في فيضانه وفي هديره الذي يُسمع في المدينة ويوقظ النيام، يقف الناس ليراقبوا عربدة النهر الذي يجرف معه كل شيءٍ يصادفه في طريقه البعيد، يجلب جذوع الأشجار ويدحرج سقوف الأكواخ ويدفع في خضمّه خرافاً وبغالاً وحيواناتٍ أخرى، ولتصطدم بأعمدة الجسر الحجري القديم الذي يفصل القلعة عن المدينة الجديدة، وكثيراً ما تؤشر الأيادي، والوجوه ساهمةٌ إلى مهد طفلٍ يتدحرج بين طيّات الماء الأحمر، وتفيض المياه في بعض الأعوام لتغطي الجسر الحجري تاركةً خلفها، عندما تجف غريناً أحمر يغطي الطرقات، وعندما يتصلّب الغرين ويفخُر بحرارة الشمس يكون مادةً للرقيّمات التي حفر عليها الأجداد كلماتهم وأساطيرهم وأسرارهم.
وكثيراً ما يعم الحزن على الناس لمصير آخرين كانوا في البعيد حينما جرفت السيول بيوتهم وحاجياتهم ومصادر رزقهم، ويُحتمل أنها جرفت ناساً وأطفالاً لفتهم بخضمّها الأحمر ناقلةً إياهم إلى البحر البعيد.
يتعلم الناس في كركوك معنى المسافات والامتدادات عبر النهر الذي يأتيهم من الجبال ويذهب بعيداً، ويعرفون بأن هناك أماكن وناساً يعيشون بعيداً عن مدينتهم، دون أن يسافروا إليهم، وهم بذلك يتعرّفون على الحزن المجرّد، غير المشخّص، الحزن الذي يشارك أحزان الآخرين البعيدين عنهم، حزن من أصابتهم الكارثة هناك.
يستدعي هذا النهر دائماً بطوفانه تاريخ العراق القديم ويستحضره في الذاكرة، تاريخ غضب النهرين وفيضانهما، ذلك الذي دمّر إنجاز حضاراتٍ مختلفةٍ رافقتها حروبٌ وحريقٌ وغزوٌ من الشمال ومن الجنوب، وضعت الإنسان العراقي وحيداً بين الماء والنار، ودفعته لكي يقف ساكناً أسير حزنه ينوح بعيداً عن محاولة تخليص نفسه من مصيره الحتمي ومما يهدده.
قرأت ترنيمة أمٍ تنعي وليدها الذي تحمله بين يديها وتعصره إلى صدرها، ثم تقف عاجزةً بين احتراق ستائر القصر وأثاثه، وكانت المياه أيضاً تقتحم القصر والجنود يتقاتلون ويسقطون موتى، قلت آنذاك، إثر قراءتي لترنيمة الأم: لمَ تبكي بترنيمتها وتنعي وليدها عاجزةً دون أن تتحرك وتهرب فتنقذ نفسها ووليدها من الفيضان ومن النار ومن اقتتال الجنود، قلت: لماذا تكتفي بالبكاء والنواح، تجسّد ما يحيطها بالغناء الحزين، ولا تهرع لتخلّص وليدها من الموت ومن الكارثة.
لم أكن أدرك آنذاك، في يفاعتي، ما في الحزن والكمد من سرٍ يشلّ المرء عندما يسلم نفسه للقدر، هذا الذي يعيد مأساته ويكررها، مرةً بعد أخرى، ويغلق كل الدروب، فلا يبقى إلا إطلاق العاطفة الحزينة بالشعر وبالترنيمة السوداء، وبذلك يكون الموت مجرد رحيلٍ لا مناص منه إلى أحضان القدر وهلا يقتضي سوى طقوس مرافقة، وهل أعمق من الشعر ليعبّر عنه ويرافق ذلك الرحيل.
إنه الماضي، ماضي كركوك، بقلعتها ونهرها وبغرينها، وبما تثيره في بحر الزمن، فتضعنا قبالة الأجداد، الأجداد الذين يحتشدون في المدينة، يأتون إليها من كل صوب، كلٌ يحمل حقيبة زمنه ليفتحها لمن يريد، يمضي في أطراف المدينة كلكامش وأنكيدو، مثلما ينشغل أتونابشتم في بناء سفينته استعداداً للطوفان، تتخاصم خارج القلعة وداخلها آلهة، تريد من هي في الأعماق “تموز” لكي تغطيه بالعتمة في الأرض السفلية، آلهةٌ تشحذ للأقوام وللرعية سيوفاً وعرباتٍ ودروعاً للحرب، وآلهةٌ أخرى سمحةٌ تكتب على المسلة حروفاً تسلمتها من السماء، وتعبّد الشوارع لمواكب النذور تبارك بها المدينة.
(5)
يتحدث سكنة كركوك، من القوميات والأديان والإثنيات والطوائف، باللغات السائدة فيها جميعاً: التركمانية والعربية والكردية والآشورية، كلٌ يحترم خصوصية الآخر، وفي بعض الأحيان يُجمعون على تقديس نبيٍ أو وليٍ مشتركٍ للمدينة، كما أنهم يشتركون في مناسباتٍ دينيةٍ أو قومية في الغالب.
وربما هذه السماحة وهذا التمازج وإمكانية التعبير باللغة العربية، عبر معرفة لغاتٍ عديدة، لها بنيتها ونظامها الداخلي، هي واحدةٌ من الخواص التي طبعت النصوص الأدبية لـ “مجموعة كركوك” في الستينيات: جليل القيسي وسركون بولص وجان دمّو وفاضل العزاوي وأنور الغساني ومؤيد الراوي، وهم قد امتلكوا في كتاباتهم لغةً أكثر قدرةً على التعبير، واتسمت نصوصهم بدينامية وبحداثة ملحوظة، فضلاً عن تجاوزهم إلزامات الأفق القومي والديني الضيّق، وقد تمكنوا من الاستشراف السمح على الثقافة العالمية من دون تعصبٍ، ويبدو أن هذه الصفات لدى المجموعة حفّزت بعض مثقفي حزب “البعث” وبعض القوميين بأن يسوق الاتهام بابتعاد هؤلاء والتنكر للإرث العربي والإسلامي(!)، ولم تستطع المجموعة –ما عدا القيسي الذي استنكف عن النشر مؤخراً- أن تمكث في العراق، حيث رحل كلٌ إلى منفاه في بلدان أخرى.
(6)
خارج كركوك القديمة، على الضفة الأخرى من النهر العريض، تنتشر مناطق وحارات متباعدة، تفصل بينها بساتين وحدائق، والحدائق هذه عامرةٌ بأشجار التوت والحمضيات والرمان والسدر وبشجيرات الكروم وصفوف من الدفلى، بينما تحيط بمعظم البساتين أشجار الزيتون المعمّرة، تسقط ثمارها الدهنية السوداء والبيضاء لتترك بقعاً داكنة اللون على التراب. وثمة أيضاً حقولٌ متفرقةٌ لأشجار الزيتون متروكة منذ أمد، يجني الناس من ثمارها دون رقيب، وتوحي البساتين المنتشرة خارج الأحياء السكنية المتراكمة البيوت والأزقة الضيقة بالريف الهادئ الذي يلتجئ إليه الناس هرباً من الضيق ومن جو الصيف الخانق.
وتبدو كركوك مدينةً متفردةً بأنهارها وبجداولها، أينما تمضي يرافقك نهرٌ أو جدول، تسبح في بعضها بطاتٌ تدهن ريشها، وتقترب منها العصافير والطيور غارسةً مناقيرها الصغيرة في جداول الماء، وتدخل تلك الجداول إلى كل بيت، ثم تخرج منه لتدخل بيوتاً أخرى، وتمضي في كثيرٍ من الأزقة والشوارع لتفضي أخيراً إلى البساتين، وكنّا نسمي المدينة “مدينة السواقي”. أينما تذهب يكون بمقدورك أن تغمس قدميك في الماء، وأن تغسل وجهك في حر الظهيرة، تلك الظهيرات الحارة التي تصعد فيها اللقالق والبواشق وطيورٌ أخرى إلى كبد السماء متلمّسةً البرودة هناك.
كانت أنهار كركوك سمحةً وسلسة، تُملأ بمائها الجرار والأواني، وتُرشُ به الأحواش وقرميد البلاط ليأتي فيء الأشجار سميكاً مختلطاً برائحة التراب، بارداً في الأمسيات.
كانت المياه تأتي من شمال ومن غرب المدينة حيث تبدأ المرتفعات، وهي مياهٌ جوفيةٌ، قبل أن تصل كركوك تسير في سواقٍ وأنهارٍ تمشي تحت الأرض، باردةً عذبةً، وهناك آبارٌ كثيرةٌ على طول تلك الممرات الجوفية، يمكنك أن تشاهد من فوهات الآبار القريبة من المدينة مياهاً رقراقةً قريبةً تسعى في باطن الأرض، ولأجل استمرار تدفق وجريان الماء كانت تُكرّى تلك الآبار على نحوٍ دائم، بأن ينزل عمالٌ مختصون بالكري إلى تلك الآبار ليفتحوا مجرى الأنهار ويخلصونه من تراب ومن حصى الانهيارات، ولدى اقتراب هذه الأنهار الجوفية من شمال المدينة تتفجّر في نهرٍ متدفقٍ يغذي الطواحين الكثيرة المنتشرة في المدينة، ويتفرّع إلى فروعٍ عديدة تسقي البساتين والبيوت.
ويذهب الأطفال واليافعون، بوجلٍ كبيرٍ، إلى فوهات تلك الآبار ليرموا فيها حجراً ولتتطاير من داخلها رفوفٌ من حمامٍ وحشيٍ وقطا وزرازير وخفافيش لاذت ببرودة المياه والظل وقت الظهيرة في عمق تلك الآبار، وقد ترافقت دوماً زيارة تلك الآبار بشعور الخوف والخطيئة من جراء الشائعات بأن تلك الآبار شغِفةٌ بابتلاع الأطفال.
أفق كركوك الشمالي أحمرٌ في الليل، وعندما تتراكم الغيوم هناك يتوسع اللون الأحمر، ذلك أن احتراق الغاز الفائض من آبار النفط ومن فوهاتٍ متعددة يلوّن أفق المدينة فيكون قانياً في ظلام الليل، وعلى مقربةٍ من تلك الفوهات النارية تشتعل ألسنة لهبٍ صغيرةٍ في مساحةٍ من الأرض تبدو مثل أسماكٍ حمراء صغيرة تتراقص فوق التراب، وتتنقل أسنة اللهب هنا وهناك في المساحة التي توجد فيها، ينطفئ بعضها ليظهر هناك، وهكذا يتراقص اللهب باستمرار، هذه النار الأزلية تسمّى منذ القدم بـ “بابا كُركُر”، والألسنة النارية ظاهرةٌ موجودةٌ قبل أن تقوم المدينة بقلعتها، وذلك من جراء انبعاث الغاز من تحت الأرض حيث يحترق بمجرد تلامسه مع الهواء، ومن المحتمل أنها كانت الدليل لاكتشاف الغاز والنفط في المدينة.
لا يعرف الناس هذه الظاهرة الجيولوجية، لذلك ينظرون إليها بقداسةٍ معينة، وتثير زيارة الناس والتجمّع حول النار الأزلية جواً عتيقاً يعود بالمرء إلى أجيال سحيقة، فيما يثير لدى البعض طقوساً أشبه بطقوس اكتشاف النار، وبأجواء عبدتها، وأمام النار الأزلية يقف الناس بخشوعٍ، وينوي كل فردٍ ويبطّن مطلبه من النار، وينذر النذور بنبش التراب لعل هذا النبش يطلق لساناً صغيراً من اللهب فيتحقق مراده، هكذا هم، أناسٌ يخلون إلى نفوسهم، وبخشوعٍ تامٍ يُسرّون عن نواياهم: ما إذا يعود الغائب، أو تحظى البنت الباكر بحبيبها، أو تحبل المرأة ويأتي حملها ذكراً، إنه مكانٌ يتوحّد فيه الفرد مع أفكاره وعواطفه ويمارس التأمّل في نواياه بكثيرٍ من الخصوصية والقدسية.
(7)
كانت كركوك، قبل ظهور النفط فيها والبدء باستخراجه، مدينةً سمحةً لم تُسجّل فيها حوادث عنفٍ غير معهود، وما عدا في الأساطير والحكايات لم تُسفك الدماء أو تُخرب العوائل بحياكة المؤامرات، ولا يتذكّر أحدٌ بأن سجن المدينة كان يضم أكثر من عشرة أشخاص سرعان ما يُخلى سبيلهم ويعتذرون لمن أساؤوا إليهم، لقد اقتنع سكان المدينة بما رزقهم الله، وهم في الغالب حرفيون وكسبة، وكانت البيوتات الكبيرة المالكة تفتح أبوابها للآخرين وتجود على الفقراء، روحٌ من التضامن والتكافل الاجتماعي تسود بين شرائح المجتمع غير المتناحر، ربما كان الكل يعرف الكل، وتمضي الحياة هادئةً قنوعة.
وتتناغم الحياة فجأةً كل يوم أربعاء في الأسبوع لتوقظ بهجةً استثنائيةً لدى الناس، وما يسمى بـ “الأربعاء الأحمر” هو مناسبةٌ لخروج الناس والعوائل إلى ضواحي المدينة وعلى متكئ التلال المغطاة بالعشب وبشقائق النعمان وسنابل الحشيش والورود البرية، تراهم يمضون إلى هناك بسلالهم وبأوانيهم وبعدة الشاي والسمّاور، ليفرشوا الأبسطة وليستمتعوا بالطبيعة والرفقة الجماعية، وليعمٌقوا معرفتهم بالآخر.
وكانت أكثر المناطق ازدحاماً هي التلال العالية على خاصرة المدينة الشمالية، التي كنا نسمّيها “تانكيلار”: جبال الخزانات، المحاطة باللبلاب وبورود عبّاد الشمس ومتسلقات الليف.
(8)
لكن المدينة أخذت فجأةً بالتحول وبتبدّل معالمها كما لو أصابها مسٌ من الجنون، عندما شرعت شركة النفط “آي بي سي” بالعمل على استخراج تلك المادة السائلة السوداء من جوف الأرض.
جاءت الشاحنات الطويلة تحمل أنابيب عملاقة وتنفث دخاناً يجعل الناس يعركون عيونهم ويعطسون، وارتفعت أبراجٌ حديديةٌ، بينما بدأت حفاراتٌ تغرز أسنانها الحديدة بالأرض، وجرافات تدفع التراب دفعةً واحدة بقدر ما يدفعه عشرات الرجال، واقتُطعت مساحاتٌ مستويةٌ من الأرض قامت عليها صفوفٌ من الخزانات المطلية بالدهان الفضي يمنع الاقتراب منها. وظهرت وجوه بيضاء ترتدي قبعات معدنية وتعمل بسراويل قصيرة في ربط الأنابيب ودفعها بحفارات عملاقة إلى باطن الأرض، سُوّيت أماكن واسعة بالأسلاك، وبدأ الحراس المسلحون بالعصي يحرسون تلك الملكيات، قبل أن يتحولوا إلى شرطةٍ رسميين. كما شُيّدت محطةٌ لسكة حديد تمضي إلى مراكز استخراج النفط، تنقل عرباتها العمال الذين يزداد عددهم باضطراد، وهم يأتون إلى المدينة من أماكن بعيدة، يتزاحمون على العمل.
كان سكان المدينة يرصدون ما يحدث بنوعٍ من الدهشة الممزوجة بالخوف والقلق، ويتلمّسون التغيير الحاصل ويسمعون ضجة الحياة اليومية الجديدة التي تكسر الهدوء الذي استمر دهراً، وظهر في المدينة عمالٌ من أبنائها يُشار إليهم بملابسهم الزرقاء وبأحذيتهم الجلدية الطويلة، ولكن العمال المهاجرين من أماكن أخرى إلى المدينة كانوا الأبرز بين المشتغلين الجدد في شركة النفط، وهم يعودون إلى أكواخهم في أطراف المدينة، أو إلى غرفٍ استأجروها في الأحياء الفقيرة.
هكذا تبدّلت معالم المدينة وتغيرت خارطتها الهندسية بآلاف البيوت التي شُيّدت فيما بعد على أراضٍ جديدة، خُرّب بعض البساتين وقّطّعت أشجار بساتين الزيتون بينما أُهملت بساتين أخرى لتباع كقطع أراضٍ للبناء الذي أخذ يتوسع بشكلٍ مضطرد، وأصبح بعض الأماكن محاطاً ومحاصراً وممنوعاً من الوصول إليه، بينما شُيّدت أماكن خاصة للموظفين الانجليز ولخبراء النفط بشوارع واسعة وبدور مبنيةٍ بالطابوق المفخور وبنباتات مشذّبة على طول شوارع واسعة نظيفة تحمل أسماء وأرقاماً وحروفاً انجليزية، وظهرت حافلات خضراء خاصة لخدمة عوائل الانجليز.
وفي خضم جنون المدينة باستخراج النفط وارتفاع الأبراج الحديدية وازدياد فوهات الأنابيب التي يحترق بها الغاز، بدأ الأفق الشمالي للمدينة يحمرّ ويزداد احمراره كل يوم. بينما تكاثر الغرباء في الطرقات وفي المقاهي، وأخذ نمط الحياة يتحوّل شيئاً فشيئاً، والقلق يعم الناس فتأتي أفكارٌ متناقضةٌ تحرم الكثير من النوم الهادئ.
لم يكن القلق والدهشة فقط هي التي عمّت سكان المدينة، بل جاء الخوف والوجل من اختلال إيقاع الحياة السابقة، وأصبح التساؤل عن المصير وعن الأسرة والصداقة والأخلاق موضع توجّس.
كل صباحٍ ترى عمال النفط –هذه الظاهرة الجديدة- يخرجون مبكرين من بيوتهم، قبل شروق الشمس، يتجّه بعضهم صوب القطار الذي ينتظر في المحطة، ويعلن مراتٍ عديدة بصفيره الحاد عن انتظاره وعن موعد مغادرته المرتقبة، متوعداً العمال بتركهم إن تأخروا، وكان عمالٌ آخرون يسعون في الشوارع ويعبرون البساتين إلى أماكنهم حيث الماكنات والمحدلات والجرافات وأدوات العمل ليشرعوا بالكدّ ويكسبوا رزقهم، وكان العمال في جميع الحالات يمضون متعبين مخدّرين بوجوه شاحبة وعيون ثقيلة الأجفان لشحة النوم، وهم يقضون يومهم حتى غروب الشمس ليعودوا بذات القطار الذي ينفث الدخان والبخار الأبيض، حينئذٍ تزدحم الطرقات مجدداً بهؤلاء الكائنات عندما تؤذن الشركة بنفيرها اليومي انتهاء موعد العمل. كلٌ يحمل صرة طعامه الفارغة ويسعى كشبحٍ إلى بيته وقد حل الليل.
أصبح للمدينة وقتٌ محددٌ يتلازم صفير القطار المتكرر في الفجر الذي يعلو على صوت المؤذن، وبنفير الشركة الذي يغطي المدينة مساءً لدى الغروب مثل عويلٍ طويل، هكذا أصبحت مدينةكركوك مختلفةً بالزمن المعلن دوماً، وبالأصوات الهادرة من المكائن والشاحنات والمطارق، واكتسى بعض شوارعها وساحاتها بالنفط الأسود، وبينما يحاول الكثير من سكان المدينة أن يستوعب ما يحدث ويريد التآلف معه، يتساءل البعض ممن جذورهم في الماضي: أية مدينةٍ أصبحت تلك التي قبعت في التاريخ طويلاً. وهل تتواصل مع الزمن بقلعتها وقطع نقودها وآثار جرارها، وكيف سيحدّق مواطنوا بابل وآشور وأكد بعيونهم الواسعة المزدانة بالتأمل والصبر، وباستكناء الأساطير والملاحم إلى مدينتهم الجديدة التي أصبح النفط يمضي في شرايينها بدل جداول الماء الصافي وبدل مواكب النذور المسيّرة للآلهة.
(9)
كنت طفلاً لم يفاجأ إلى قليلاً بما هو غير معهود، لم أرَ جنوناً أو طوفاناً أو ظاهرةً غير عادية، ولكنني في ذلك اليوم، في ظهيرته الحارة التي شرّدت المارة من الشوارع وأدخلتهم البيوت والحوانيت المظللة، فوجئت بحشودٍ من الرجال تصرخ ويتعالى صراخها باضطراد، كتلةٌ غاضبةٌ معروقة الأجساد مبللة القمصان تمشي متلاحمةً متراصةً مثل أحجار الجبل المثبتة بالجفصين، تزمجر في بداية شارع “الأوقاف” الشارع الوحيد في المدينة، لم أرَ في حياتي هذا العدد الغفير من الرجال وهم يجتمعون ويتراصّون معاً، ويندفعون في موكبٍ غاضبٍ واحد.
كانوا بالنسبة لي يبدون رجالاً آخرين، ليس كما عرفتهم واعتدت عليهم آباء أو أولياء يحنون على زوجاتهم وأطفالهم ممتلئون بالحنان، يجلبون في المساء إلى بيوتهم ثلجاً مدلّىً بالمناديل، أو يجلبون فواكه طازجة لوجبة المساء، رأيت رجالاً يغلون من الغضب تلفهم عاطفةٌ واحدةٌ تتفجّر، كنت آنذاك مندهشاً وخائفاً ومتوجساً من أن يحدث أمر غير طبيعي، كنت مقتنعاً بأن هؤلاء بصرخاتهم المتقطعة المكررة سيهدون بنايات الشارع الذي أقف فيه، وعندما اقتربوا مني أزاحني أحد المتفرجين وقال: “إنهم عمال النفط، يتظاهرون من أجل مطاليبهم”.
لقد مكثت تلك الصورة في ذاكرتي وأنا أحاول استكناء جذور ذلك السر الذي يجمع الرجال المتفرقين ويوحّدهم في لحظةٍ ما بالغضب، يلاشي خلافاتهم في الحياة العادية ليحولهم ويصوغهم في قوةٍ واحدة، قوةٌ لو تهيّأت لها أسباب التدمير تكون جاهزةً لاستخدامها فتصبح عمياء يمكن إطلاقها صوب أي هدفٍ كان، وباتجاه أي مشروعٍ بغض النظر عن مضمونه، لم أعرف في الواقع كنه ذلك السر، بيد أنني رأيت تمثّله في الروح الغاضبة ضد العسف، مثلما رأيت نتائجه في ممارسة القتل الجماعي وإفناء الآخرين فيما بعد.
(10)
بعد سنوات، كان المساء قد حل، والمساء يرتدي دوماً غلالةً من الحزن، كان التوتر يسود الحارة والقلق عميق لدى الناس، هناك أخبارٌ عن محاصرة الشرطة لعمال النفط المضربين منذ أيام، يأتي أحدهم ليخبر بعض العوائل في الحارة، تخرج النساء بعباءاتهن، يدلفن هذا البيت أو يمضين إلى غير هدف، القلب هناك مع الأبناء والأزواج، ولأن القلب ينبئ بالكارثة هذا المساء، فقد جاء الصراخ والعويل ونحيب النسوة عندما حدثت الكارثة، رأيت النساء بعباءاتهن المتطايرة السوداء يركضن دون وجهة، يبحثن عن شيءٍ ما، يلطمن ويشقن عن صدورهن كما يحدث عندما يموت لهن شخصٌ قريب، وتيقّنت من حلول الكارثة، كارثة جماعية من خلال مظاهر الحزن الجماعي. سرعان ما ظهر رجالٌ مرتعبون يتراكضون مثل طريدةٍ تخلّصت من فخاخ نُصبت لها، تحدّث بعضهم في غيابٍ تام عن القتل وعن هجوم الشرطة عليهم غيلةً وغدرا، رأيت ملابس ممزقة وبعضها ملطخٌ بالدم، يقف واحدٌ منهم ليصرخ في البيوت وفي الناس الذين فتحوا الأبواب ليشاهدوا ما حدث، ويأتي آخر مذعوراً لكي يقتحم باباً ويختفي في الدار. وقد سرت شائعةٌ تقول إن الشرطة تلاحق العمال إلى بيوتهم.
كان الأمر بالنسبة لي حينذاك تهويماً داخل الكارثة وأنا أشعر بالرعب ذلك المساء. لم أعرف التفاصيل ولم أدرك طبيعة المواجهة وأسبابها بين العمال وبين شركة النفط، وعرفت فيما بعد أنه كُسر إضراب عمال “كاور باغي”. وهو أول إضرابٍ منظم يخوضه عمال النفط من أجل مطاليبهم. وكان هؤلاء العمال قد امتنعوا عن العمل وتجمعوا منذ أيامٍ في حقلٍ واسعٍ لأشجار الزيتون يدعى “كاور باغي” –بستان النصارى-، يقع عند مرتفع يتناثر عليه عددٌ من القبور، وقد استدرجتهم الشرطة ووعدتهم بدراسة مطاليبهم، لكنها ما فتئت هجمت عليهم من المرتفع وهي راكبة الخيول مطلقةً النيران عليهم، وحاصرتهم من الجانب المفتوح، خارج حقل الزيتون، قواتٌ أخرى جاءت في شاحناتٍ خضراء نزلت وصوّبت عليهم نيران بنادقها.
لم تكن مجرد إشاعةٍ ما تناقله الناس عن وحشية الهجوم والقتل، ولكن عمل الضمير الجماعي لقاطني كركوك على تأليف كتابٍ شفاهي يصف المشهد بتفاصيل دقيقة لوقائع المواجهة، ويضع صوراً قابلةً للتخيل عن ثقوبٍ في صدر العمال وعن برك الدماء وعن قطع الأعضاء.
وجاءت الأساطير فيما بعد مقترنةً بالحدث لتصف القتلى بأوصاف الأولياء والقديسين، وقيل إنه ينبغي دفنهم في الموقع نفسه على تلة “دامر باش” –الرأس الحديدي-، ومن المؤكد بأن القبر الذي سيضمهم هناك في أعلى التلة سيكون رحيماً بهم، وحينما ستنطبق الأرض على الجثمان ثلاث مراتٍ ليتخلص من حليب الأم من الأنف سيتم ذلك برأفةٍ وبحنان فلا يحس أولئك الموتى بالعذاب. وستذهب أرواحهم بعد ذلك إلى الراحة الأبدية، ولربما تجول بين أشجار الزيتون بعيدةً عن حقول النفط.
وعندما قُطعت أشجار الزيتون، وجُرّفت الأراضي لتُبنى عليها مدرسةً ابتدائيةً، قيل إن الخوف الذي استمر عقوداً كان الدافع الحقيقي للتغيير في المنطقة، بغية مسح آثار الدماء التي كانت تبرز للعيان كلما نزل المطر وغسل التراب في حقول الزيتون، بيد أن أرواح القتلى ما زالت تجول هناك ليلاً وتنزل أحياناً من فوق التلة لتدخل صفوف الطلبة، ويفاجأ الصغار في الصباح بجملةٍ مكتوبةٍ على سبورتهم: “ذكرى كاور باغي في القلوب”.
(11)
لم يكن النفط قد غير مدينة كركوك على هذا النحو المجنون إلا بعد استخراجه وحفر مئات الآبار من قبل شركة نفط العراق “آي بي سي”. وقبل ذلك كانت تطفو كمّيات منه على نحو طبيعي فوق مياهٍ معدنية، تخرج من باطن الأرض وتشكّل بركاً متفرقة. ويقول المسنون بأن العثمانيين قد استعملوه ثم منحوا حق تسويقه لعوائل من المدينة، ولم يكن التسويق في الواقع إلا نقل النقط الأسود الخام بما تجود به تلك البرك والأنهار وبيعه للناس.
كان الناس يذهبون إلى تلك البرك البعيدة عن المدينة ويقطعون مسافاتٍ طويلةٍ للاستحمام في مياهها المعدنية، أو لملء بضع قوارير تفيدهم في علاج أوجاع المعدة أو بعض القروح والجروح، وكان البعض يلتهم قليلاً من التراب الحامض متذوقاً به طعم السمّاق معتقداً بأنه ينهي ألم الأسنان أو انتفاخ المعدة، على أية حال كان العمل الدؤوب يتم من قبل باعةٍ محترفين يذهبون في قوافل من الدواب تعلّق الأجراس على أعناقها ليغرفوا من النفط الأسود بطاساتهم المعدنية ويملأوا به براميلهم المحملة على البغال. ولقرون طويلة أُضيئت اللمبات المعدنية في البيوت من ذلك النفط، وحرّقت الأخشاب وسُخّنت الحمامات. وكان أحياناً يضاء به بعض مفترقات الطرق عندما تحظى المدينة بحاكمٍ عادل.
وكثيراً ما أحالت التأملات بخصوص النفط وغرفه من تلك البرك التي تقع بين التلال الداكنة برائحتها الحادة، مثل رائحة البيض الفاسد، تحيل الذاكرة الجماعية إلى ناسٍ قدامى هم من عصورٍ مختلفةٍ غسلوا أيديهم بتلك المادة السوداء، وتركوا لنا جراراً مكسورةً ونقوشاً على لوحات طينية تظهر أحياناً في تراب القلعة أو في أطراف المدينة، لتعلن عن أرواحٍ تجوب، أرواح أجداد يحنون علينا بكثيرً من العطف والقلق، ويقولون لنا: اتركوا إشارةً منكم للزمن الآتي، ولكن ما الذي يمكن أن يُترك غير أبراج النفط وخزاناته البيضاء، وغير تلك الأنابيب التي تخرج من المدينة وتمضي إلى كل صوب.
(12)
كان علي عربتلي واحداً من أولئك الناس الذين ينقلون النفط الأسود على دوابهم ويوزعونه على البيوت، منشغلاً بالماضي منتقداً الحاضر، كان يقول: ما أقوم به في هذا الطين الأسود قام به آباؤنا منذ آلاف السنين، وكان يردد دائماً بأن عمله لا يعدو سوى أن يكون من عمل الحمير، وبأنه كبير ولا يستطيع ببضعة براميل أن يعيل عائلته الكبيرة العدد، ويبدو أن علي عربتلي فكّر ليل نهار ليطور وسيلة نقله للنفط، وقد تمكن إبان الحرب الثانية، وفي نهايتها تقريباً، أن يربط عربةً مسطّحةً تمشي على عجلتين تجرها دابته المتعبة، وهكذا أصبح بوسعه تحميل العربة بعدد أكثر من البراميل، ولم يبد بوجهه النحيل والحزين قادراً على تغيير سحنته سواءً غضب أو فرح أو اشمأزّ من شيء. ولم يعبأ في خضم الحرب، وقد وصل بعض مظاهرها ونتائجها إلى كركوك، بما يمر به من جنود الانجليز، ومن وحدات السيخ والكوركا الهنود، كما أنه لم يكن ليعير أي اهتمام بوجود الثكنة العسكرية الطينية التي بُنيت على سفح التلة التي يمر بها ويشاهد رجالاً غريبي الهيئة ذوي عماماتٍ ضخمة ولحىً معقودة بشواربهم، ولم يفكر بأن يستبدل دابته المتعبة ببغلٍ قوي من وحدة البغال العسكرية القادرة على حمل مدفعٍ ثقيلٍ بعجلاته.
ولكن مع انتهاء الحرب وبدء استئناف استخراج النفط منع الانجليز، وهم السادة الجدد الناس من غرف النفط الأسود، فانكفأ علي عربتلي في الدار وقلق بشدةٍ على مصير أسرته الكبيرة العدد. استطال وجهه وأطلق لحيته، كان كبيراً في السن بطيء الحركة لا يقوى على العمل في البناء، وهو القطاع الوحيد المزدهر. وعمل سكان المحلة على إقناع الحاج شكور بأن يعطيه حانوتاً صغيراً علّه يتمكن من إعالة عائلته، وأخذ علي عربتلي في الحانوت الصغير المعتم الشبيه بجحر الدببة يبيع اللبن والسكر والسكاكر وألواح من الورق الملون.
كان يأتي إلى الحانوت ويعود منه بعربته المنبسطة، ينزل منها بصعوبة، ويشد دابته إلى جذع شجرة متيبسةٍ أمام الحانوت، وأخذ يمسك الناس ليتحاور معهم، بل ليشكو لهم همومه، وكان حواره الدائمي، سواءً مع الآخرين أم مع نفسه، هو ندب الحظ وسرد مظاهر الخراب في الأنفس، وكيل الشتائم لشركة النفط.
وفي كل مرةٍ كنت أذهب إليه لشراء البصل أو الملح كان يوقفني ويقول لي: “ما زلت صغيراً يا بني، تبصر الآن حياةً تختلف عن الحياة التي عشناها، كانت حياةً سمحةً ترفل بالرحمة”، ثم يستمر بشفقةٍ وقد أطرق رأسه: “يا إلهي، ما الذي ينتظركم بعد سنوات.. خراب وخراب، ربما تمتد تلك النيران المشتعلة من النفط إلى بيوتكم”.
احذروا من تلك الأنابيب اللعينة، أشعلوا فيها النيران.
وفي ظهيرةٍ ما سمعت ولولة النساء وبكاء الأطفال، وعندما خرجت من بابنا الكبير رأيت عائلة علي عربتلي، بناتاً وذكوراً وأحفاداً، يبكون مع أمهم التي طيّنت شعرها وهم يقودون العربة المسطحة وعليها جثة علي عربتلي مسجّاةً تغطيها ملاءةٌ من الخيش، وقد فاضت روحه إلى باريها في ركن من حانوته بين البصل وصحن اللبن الكبير الذي يبقبق من جراء حرارة الصيف.
(13)
نبأ الموت أسرع انتشاراً في كركوك من أي نبأٍ آخر، ربما بسبب الإحساس الخفي بأنه موتهم أيضاً، وهم يقفون قبالته بهذه المناسبة. أو على الأقل هو صورتهم المقبلة، ولكي يعتادوا عليه يذهبون إلى الميت، يأكلون من طعامه، ويتحدثون عنه كما لو كان حاضراً يجلس بينهم، بينما النساء، على عكس الرجال الذين يتظاهرون بالصلابة، يلطمن ويشقن الصدور ويمزجن تعاستهن وشقائهن بهذا الرحيل، وتأتي “العدّادة” لتصف محاسن من رحل، فتثير مزيداً من النحيب، وفي ذلك المشهد والكمد ممثله تضفي العدّادة صفاتاً وحياةً لم يتصف بها الميت ولم يعشها.
لكنها ساعة الوداع ليتخيّل كل مصيره ويفتح جروحه أمام قبره الخاص، ويشعر بأن التراب الثقيل يملأ عينيه هو، وسوف تأتي فيالق من الديدان إلى وليمتها في هذا البدن الجميل.
وأنا أتحدث عن الموت، أخافه حقاً، وأرى مع مرور الأعوام حكمة الزمن عندما يوهن الجسد، ونحن نكتشف ذلك ونحس بأنه لم يعد مثلما كان، قادراً على الحركة الطليقة، أو متمكناً من التلقائية التي اتصفنا بها في عمر الشباب، إنه الموت غير المعلن الذي يهدم فينا الحياة جزءاً فجزءا، لم أرَ في حياتي جسداً يوارى تحت التراب، وقد تحاشيت ذلك وهربت منه دوماً لكلي لا أرى عائلتي وأصدقائي الذين تلامست معهم وعشقت دفئهم يرحلون وأكون شاهداً على دخولهم إلى شقٍ في التراب ثقيلٍ عليهم، لا يستطيعون النهوض منه، ولربما –وأنا أكتب عن الموت- أريد أن أعتاد عليه وأن أحاول تطهير نفسي من إثم وداع الذين أحببتهم دون أقبّلهم من جبينهم عندما بردت أجسادهم ودخلوا تلك المتاهة التي لم يخرج منها أحدٌ حتى الآن، وقد يكون هذا الإلحاح في الكتابة عن الموت ضرباً من وهم المواجهة وخداعاً مني يتمثل حقيقته القاسية.
(14)
كان رجلٌ وسيم طويل القامة يأتي بين حينٍ وآخر إلى الدار الملاصقة لدارنا، نشاهده نحن الصبية، فنكف عن لعبنا في الزقاق، لنتأمله وهو يخطو بهدوء ويدخل الدار، هو غريبٌ بالنسبة لنا، لا يسكن الحارة التي نسكن فيها، لم نكن نتساءل من أين أتى، ومن هو، وأين يعيش، ولم نكن نعرف أيضاً أي صلةٍ تربطه بالضابط العسكري الذي يقطن الدار المجاورة. كان رجلاً حسن الهندام يتسم بالرصانة والهدوء يحيّي من يصادفه بكبرياء واضح ويمضي دون أن يتحاور معه، يدخل الدار في الغالب بمفتاحٍ في جيبه، دون أن يكون الضابط في الدار.
هرعنا ذلك المساء إلى الدار الملاصقة لدارنا عندما علا الصراخ وركض الناس إلى هناك. كانت أبواب البيوت قد تُركت مفتوحةً والناس يسعون إلى مصدر الصراخ، وصلت إلى هناك ودخلت الزحمة، ومن بين أجسام الرجاء والنساء شاهدت رجلاً يبكي وينوح ممزق القميص يكشف عن صدرٍ أبيض، يلوح بيده ويقاوم للانفلات من قبضات الرجال الذين يمنعون اندفاعه من مدخل الدار إلى الحوش وهو يقول:
اتركوني لكي أرى أخي، حبيبي.
وبقوةٍ هائلة يتخلص ويفلت من الطوق ليقتحم حاجزاً خشبياً أصفر اللون يستر مشهد الحوش، فيكسره ويحطمه بغضبٍ نائحاً:
يا إلهي إنها خطيئة، كيف ولماذا يقتل نفسه.
إنها خطيئة لا يغفرها الله.
واستطاع أن يفلت من الزحام ويدخل باحة الحوش ثم إلى الحديقة.
كنت قد تسللت ووقفت على أنقاض الحاجز الأصفر المهشم وتمكنت أن أرى أخاه الضابط مضرجاً بدمه فاقداً الحياة يتكئ على ساعده الأيمن ملقياً على الأرض بملابسه العسكرين والنجوم تلتمع على كتفيه، بينما يجهش الأخ بالنحيب معانقاً الرأس المدمّى، متسائلاً:
لماذا، لماذا..
هذه خطيئةٌ يا أخي.
وكان الرجال قد تركوه هناك ليطفئ غليله من البكاء، وهم يعرفون حزن الأخ على أخيه. لست أدري لمَ تعلّق في ذهني طويلاً ذلك اللون الأصفر للحاجز الخشبي المهشّم وملابس الضابط القريبة من الصفرة ولمعان النجوم الصفراء فوق كتف العسكري النائم على الأرض، كما لو أنه سيستيقظ ليغسل الدم عن صدغه المفتت.
وكنت كلما أتذكر الضابط المسجّى والملطخ بالدم، أخاف الموت وأتخيّل لونه الأصفر، بل أعتقد، مخففاً من وقعه بأنه مجرد غياب مؤقت ورحيل إلى مكان آخر، مثل سفر صديق، أنتظر عودته في وقتٍ ما.
كان الضابط يعيش وحيداً في الدار المجاورة لنا، وهي دار واسعة مبنية من الحجر، يمر بها نهرٌ بُنيت حافاته بالصخر، يخترق حديقةً واسعةً مزروعة بأشجار الرمان والبرتقال والتوت. وتمتد على النهر مساحةٌ عريضة تظللها عريشة كرم عتيقة تقوم على أرضية من البلاط المفخور، يتوسطها حوض ماءٍ بنافورةٍ صغيرة، وثمة كراسي حيث سقط الضابط ببذلته الصفراء برصاص مسدسه.
كان الضابط فتياً يرتدي البيجاما في أمسيات حديقته، ونحن نتلصص عليه، ونصعد جدار الحديقة لنقطف ليمونةً أو رماناً، وعندما تضج شجرة الرمان بالورود الحمراء نقطفها ثم نسحقها بأصابعنا لنلوّن خدودنا كالنساء.
يأتي الضابط كل مساءٍ في الغالب، راكباً حصانه المبقع برفقة سائسه الراكب، ويدق الحصانان بقوائمهما تراب وحصى الزقاق، يتوفزّ حصان الضابط أحياناً فيرفع رأسه بكبرياء وبغضب، ثم يضرب سنابكه بالأرض ليشد الضابط اللجام ويضغط بساقيه على البطن، وهو يرتدي حذاءً لماعاً طويل الرقبة، وفي الحركة المتوفزّة للحصان يتأرجح الضابط ويتماسك، فتتأرجح قطعة القماش الملحقة خلف قبعته السميكة المبللة بالعرق، وعندما يصلان الدار يترجل الضابط أولاً بخيلاء ثم يبدأ الجندي المرافق بربط الحصانين إلى قطعةٍ معدنيةٍ مثبتة أمام الدار.
لم يكن خيلاء وكبرياء الضابط إلا مظهراً لسكان المحلة، لأنه كان رجلاً من غير صديق، يجلس وحيداً قبالة حوض الماء ليتأمل أو ليحدّق طويلاً أمامه حتى يحل الظلام، ويمكث في أحايين كثيرة حتى الفجر من غير مصباحٍ يضيئ له الدار، لم يكن الضابط متزوجاً، ولم تربطه مودةٌ ظاهرةٌ بأخيه الذي انتحب عند رأسه المثقوب.
ولكن ما الذي حدا ببهذا الضابط أن يُطلق قطعة حديدٍ على صدغه، لم تكن هناك حروبٌ مشتعلة خسر فيها لينهي حياته على هذا النحو، بسبب من عذاب الضمير أو جراء كرامةٍ مثلومة، أليس الله وحده مسؤولٌ عن الأرواح، يرسل مندوبيه ليخرجوها من الأبدان، وهم يمسكون من حانت منيته من الخلف دون أن يتبيّن الضحية شكل وجوههم.
كيف يمكن أن يهدم رجلٌ صرحاً مشيداً بطلقةٍ واحدة، وأي سرٍ يكمن في الإنسان لأن يأتي بنفسه إلى نهايته، من دون أن يكون للنجوم على الكتف وللدار الواسعة وللحصان المبقّع أي دورٍ للاستمتاع بالحياة وردع شجرة الموت التي لا تفتأ تثمر في روحه الحردة.
(15)
عندما أكتب عن الموت، الحقيقة الأزلية الوحيد التي نحملها معنا، نواجهه، ونؤسس له منذ بدء وعينا بالحياة، لكي نعتاد عليه ونرضى به، نغلّف إياه بكثيرٍ من الوهم وبكثيرٍ من القبول والمحاججة والتذرّع بمنطق الزوال، مستعيدين الإرث والأجداد مقرّين بحقيقة انتهاء الأشياء، معترفين بمنطق الزمن الذي يمضي ويضع حداً نهائياً لكل حياة، ننظر إلى المقابر، ونتأمل تاريخ الأمر لكي نقتنع بأن النهاية هناك، نهايتنا نحن.
هذا الموت الذي لم ينجُ منه أحدٌ منذ الأزل، وقد حيكت بسببه ومن أجله الأساطير والملاحم.
هذا الموت الذي نعتاد عليه كلما ننام، وكلما نخوض في الحلم، أو في الوهم لنبتعد عن العالم قدر المستطاع ونقترب من الرحيل، ولكي ننأى عن صلابة الواقع وحقيقته المؤذية، مساومين أنفسنا على وضوح الأشياء لنغضّ النظر عن حقيقة الغياب غير محدقين في المصير.
وإني أرى اليوم، كلما أعود إلى كركوك، ذلك المكان الأول، أرى ضمن ما أرى وجوهاً اختفت وأشخاصاً رحلوا، ولكنهم في الاستعادة ما زالوا هناك، وطالما بمقدوري تجريد الزمن، واختصار أكثر من خمسة عقود تستحضر لي المكان، تبرز لديّ قوة الأشياء فيكون بمستطاعي أن أرى: ها هم أولئك معي في الغرفة التي أنا فيها، وقادرٌ على أن أحاور تلك المخلوقات التي تأتي إلىي، وليمتي اليومية، فوق منضدتي وفي مطبخي الذي أطل من نافذته إلى كثافة ظلام الليل، أنا فرحٌ بصداقتي لهم، وأعرف ذلك الغنى الذي منحوني إياه. مخلوقاتي الصغيرة التي أدرت معها وبها حروبي الليلية التي أنتصر بها وأمرّغ بالوحل من سيّج البلاد ويضع حراساتٍ ومخبرين على الحدود، وأبعثها لتكشف لي المعابر والطرقات التي طالما قادتني إلى تلك البلاد، ووضعتي في مكاني الأول، لأراه بكراً كما كان وبعيداً عن الخراب.
(16)
أغلق عينيّ لأبصر قره حسن يوصد حانوته الفارغ- بيته المضاء بفانوسٍ عكر الزجاج- ويحمل معه منضدة غسل الموتى المتكئ على حائط حانوته، ويذهب ليغسل جثة علي عربتلي.
كان قره حسن في خلوته، عندما لا يكلّف بغسل جثةٍ ما، يتخذ طريقه في زقاقه الضيق، يخطو فيه كالنائم ليصل في الظهيرة الحارة إلى بستان يغذيه نهرٌ يترك في جانبٍ من البستان مياهاً ضحلةً تعلوها أعشاب وورود برية، يتظلل هنا تحت أشجار الصفصاف ويراقب اللقالق وهي تخوض في المياه الضحلة وتتصيّد الضفادع والأسماك الصغيرة. ويعرف الجميع خلوة قره حسن، فيذهبون إليه في البستان، عندما يغيب عن حانوته ومنضدة الغسل ما زالت متكئةً هناك، وقد جاء اليوم أحدهم ليخبره عن رحيل علي عربتلي، لم يقل “إنا لله وإنا إليه راجعون” بل غمغم فقط: “سأكون هناك في المساء”.
يتدفق نهرٌ واسعٌ آتياً من الطاحونة ماراً أمام حانوت قره حسن، وهو يجلس صباحاً ليغسل يديه ووجهه دون أن يتوضأ، لم يجرأ أحد أن يسأله عن امتناعه عن الصلاة، مع أنه يسمع كل يومٍ خمس مرات الآذان من الجامع القريب منه، وعلى النهر يقع حانوته الصغير الضيق وهو يعيش فيه.
إنه مخلوقٌ متوحد يشعل فانوسه في الليل ليتخلل الضوء من خصاصة الباب الخشبي للحانوت، ويُسمع صوت “بريموسه” وهو يعد حساء العدس أو اللفت.
وتتكئ دوماً منضدة غسل الموتى، حائلة اللون أشبه بالرماد أمام حانوته.
وكلما كنت، أو كنّا، نفتقد تلك المنضدة من أمام الحانوت نعرف بأنها نُقلت إلى بيتٍ ما لتسجّى عليها جثة شخصٍ ما، ينشغل بها قره حسن بأن يمددها ويقلبها ويصب الماء عليها. لتُنقل من ثم إلى المقبرة.
كنت أبتعد عن قره حسن وأتوجّس منه، أشم فيه رائحة الموتى، أخالها رائحةً مزيجةً من العفن ومن أغطية قديمة عُطّرت بالقرنفل وببعض البخور والكافور الذي يُدهن به الموتى. وعندما كنت أمر بحانوته أتوجّس ثانيةً من الزقاق الضيّق، خاصةً عند حلول المساء، وأتخيّل الحانوت مملوءاً بالأشباح وبمخلوقاتٍ غريبة الهيئة هي صنو الموت، بينما هو يتحدّث إليها طوال الليل، وربما يأكل معها حساء اللفت الذي أعده للعشاء، منتظراً الصباح ليحمل منضدته على كتفه، ذاهباً إلى شخصٍ آخر ودّع الحياة.
ويتحدث بعض الناس عن قره حسن المُقل في الكلام، بأنه يعرف بمجرد النظر إلى الآخرين متى تحين ساعتهم، ولكنه لم يفصح لأحدٍ عن تلك المعرفة، وقد أُشيعت أقاويل متناقلة عن وحدته وعزلته وصمته، بالأخص في ليالي الشتاء الباردة الطويلة، بأنه يتحدث مع أشباح هي ملائكةٌ وشياطين يسرّون له أحياناً بأسماء تحدد له مهمة الغد، ويسلّمونه قائمةً بأولئك الذين سيموتون.
ولم يكن قره حسن يتجاوز في حديثٍ يُجبر عليه حدود الكلام عن مبعوثي الله، أولئك الذين يأتون لقبض الأرواح، ويقول إنهم كثيرون ومتباينو السحنات، منهم من يتّسم بجمال بنت من بنات “الكُرج” ومنهم من هو أقبح من عبيد البصرة، يرتعب من ينتظر الموت عندما يقف قبالته ويحدّق في عينيه، ولذلك قُضي على هؤلاء بأن يأتوا خفافاً من الخلف ويمسكوا برأس من ينتظر الموت من شعره دون أن يكون بمستطاعه التحديق في وجه من يقبض روحه، ويسهم قره حسن في حديث واثقٍ، مع من يجبره على التوقف، بأن الموتى يحاسبون ويُساءلون في القبر، وعليهم ألا يكذبوا في الإجابة على الأسئلة، لأن أي كذبٍ ينطق به لسانهم أمام الملائكة غير مُجدٍ، ومن يكذب بلسانه تتحرك يده لتقول: “حسناً أنا التي سرقت بهذا”. وكنا نحن الصبية والمراهقين ندير الحديث وجهةً أخرى لنسأل: “وأي عضوٍ سيتحرك في من زنى ليقول: “أنا الـ….””.
يقع حانوت قره حسن في نهاية منحدرٍ ضيق، تقوم على قمته طاحونة مائية لسحق الحبوب، يُسمع صوت جاروشتها الحجرية عن بعد، وتُرى أحياناً في فسحة مدخلها من يدير المطحنة وقد بدا أبيض مكسواً بالطحين, وقد تبدو مفارقة تلك المقارنة بين رجل المطحنة المكسو بالبياض وبين قره حسن الأسود الذي لا تتبيّن ملامحه عندما يحل المساء ويعكس سواد وجهه آخر خيطٍ من الشمس الغاربة. صحيحٌ أن قره حسن هو الرجل الأسود الوحيد في المدينة إلا أنه لم يُسمّ عبداً، ولم يحظَ بنظرات مستهجنةٍ أو غريبةٍ من قبل الآخرين. وتسميته بـ “حسن الأسود” جاءت لمجرد تمييزه عن غيره من الناس الذي يحملون الاسم الأول. وكان الرجل جاء إلى المدينة منذ وقتٍ طويل، وهو مطلوبٌ طالما هناك من يموت، ويغطي بعض القلق حياة من يفكر بأن قره حسن سيغلق حانوته وسيغادر المدينة. ولكن القلق الأكبر لدى الرجال ينجم عن التفكير في موته، حين لا أحد يتكفّل ويقوم بعمله، خاصةً أنه لم يدرّب خلفاً له.
لم يكن حسن قره ليعبأ كثيراً بمن سيموت وبمن سيبقى على قيد الحياة، ولم يتمنَّ قط أن يغسل من ظلم الناس، أو من حجب عن المعوزين صدقة، غير أنني سمعت من والدي بأنه قال مرة، وهو يمرّ بمحاذاة دار نيازي بيك سامعاً إياه يصرخ ويلعن الناس محتجاً على الله، كشأنه كل يوم:
“حسناً سأغسل هذا الرجل الخرف اللئيم عاجلاً أم آجلاً”.
(17)
كان نيازي بيك رجلاً عجوزاً يقعي في الدار الواسعة التي يملكها مع ولديه وابنته، عمل موظفاً في الحكومة منذ الاحتلال العثماني، وتقلد منصباً هاماً آنذاك، ثم استمر في وظائف أخرى بعد الاستقلال، إلا أن منصبه الأول منحه الاسم الذي نادوه به دائماً، كان يُقرن بنيازي بيك تسمية “دوز مديري” –مدير الملح-، وكان في وقته منصباً رفيعاً، وقد جمع ثروةً كبيرةً استعلى بها على الناس، وعُرف ببخله الشديد، ويروى عنه أنه مرةً واحدةً فقط أوصلته إلى بيته عربة تجرّها الخيول، وعندما نزل منها طلب الحوذي أجرته وحددها، فصاح نيازي بيك غاضباً: “إنها سعر شاحنة من الملح أيها الحقير”، ثم هوى بباسطونه وشجّ رأس الرجل.
لم تكن أسرته الصغيرة لتختلط بسكان الحارة، وربما فاتهم أو سيفوتهم قطار الزواج، توفيت زوجته منذ وقتٍ طويل، وقد شاخ بحيث لا يقوى على الخروج والمشي في الزقاق، بينما كان قبل سنوات يدق الأرض بباسطونه –عكازه الملوكي-، وينظر إلى الناس وإلى البيوت الطينية القميئة نظرة احتقارٍ شديد، أما الآن فلم يعد باستطاعته إلا المشي الوئيد متكئاً على عكازاته مغادراً غرفته إلى باحة الدار لينام على سريره الوسخ طوال ليالي الصيف، ثم يعود بنفس المشقة متعكزاً إلى غرفته، متلافياً شمس النهار المحرقة.
كنا نسمع نيازي بيك وهو يجعر بصوته ويرفع عقيرته بكلمات مبهمة، ثم يلعن بلغةٍ تركيةٍ سليمة. وفي أحايين كثيرة يجادل ويطرح أسئلة، كما لو أنه يتحدث ويخاصم الأشباح ثم يجدّف ويلعن الأنبياء والقديسين، وقد أطلق بوضعه وحواراته الكثير من الشائعات، كانوا يقولون بأنه مريضٌ في البدن مرضاً يؤذيه ويسحق تحمله، يلفظ كل أنفاسه الأخيرة، ولكنه سرعان ما يستردها ليبدأ مجدداً بلفظ أنفاسه، هكذا دوماً يقترب من الموت ثم يعود منه ليأتي الموت مجدداً ليقف على رأسه، إنه لا يموت لأن عزرائيل أو الشيطان لا يجرؤان على الاقتراب منه، لخرفه ولكونه وسخاً ملوثاً بالخراء، غير قادرٍ على الجلوس في دورة المياه.
وثمة أقاويل تفسّر وضعه وتقول بأن الحكمة الإلهية قضت بأن يعاني الموت، وبأن يقاسي الحياة، وهو قصاصٌ منه لأنه قتل زوجته الجميلة بديعة خاتون بعد أن اكتشف أنها تخونه في سفراته الطويلة للإشراف ولمعاينة أماكن الملح، ويؤكدون ذلك التباين الشديد بين الابنين وبين البنت، حيث أنها على عكس سمرة الولدين بيضاء مسترسلة الشعر وذات عيونٍ خضراء.
لقد اختفت، أو ماتت بديعة خاتون، زوجة نيازي بيك، بعد سنواتٍ من تبيّن ملامح طفلتها في السادسة من العمر، وبعد ما شعّ لون عينيها الخضراوين، ومن المحتمل أن يكون عذاب نيازي بيك طويلاً وعميقاً، وهو يداوي جروح الخيانة ويراكم الغضب والحقد تجاه زوجته، إلى أن غابت عندما وصلت البنت إلى العقد الأول من عمرها.
ولأن الناس لم يدخلوا من الباب الواسع لدار نيازي بيك، ولم يساهموا في العزاء أو في الذهاب إلى المقبرة، تكاثرت الأحاديث عن هذا الموت المبهم والغريب، وقيل إن الجثة وديعةً في ركنٍ من أركان الحديقة، تحت شجرة الخوخ التي تزهر كل ربيعٍ فتغطّي بورودها المكان، ليتسنّى نقل الرفات في وقتٍ ما إلى أنقرة البعيدة، ولكن القتل ذاته أطلق العنان للتخيلات:
قرر نيازي بيك فجأة أن يحبس زوجته الجميلة في غرفةٍ للحدائقي الذي طرده منذ مدةٍ طويلة، أخذ يجوّعها، يرمي لها كل مساءٍ كسرةً من خبز يابس وجرة صغيرة من ماء النهر الملوث، يدخل عليها ويضربها بالسياط، وهي تنحل يوماً بعد يوم، ويتحول صوتها إلى نأمة مكتومة، إلى أن فاضت روحها مع الأيام، ويؤكد البعض أنه سمع أحياناً عويلاً خافتاً مكتوماً يصدر من الحديقة ليلاً.
على خلاف هذا الموت البطيء جاء نيازي بيك بزوجته إلى الحمام، وكان قد أشعل الـ “بريموس” فملأ صوته المكانه، أوصد الباب عليها، مسكها من ذراعيها أولاً، ثم مزّق ثيابها، وبعنفٍ شديد فتح فمها وسكب في بلعومها قنينةً من الزرنيخ، أخذت الزوجة الجميلة تتلوى ويحترق جوفها، تصرخ وتضرب رأسها في الحائط، تقيء دماً وتقذف أحشاءها، وهو يوثقّها ويمنعها من الحركة ومن الصراخ، سقطت الزوجة على بلاط الحمام. رفست مراتٍ ملطخةً بالدم الأزرق وبقطعٍ من أمعائها لتموت، وليستحيل لونها الأبيض إلى لون الحبر.
قالت النساء: على الأرجح، أن بديعة خاتون المرأة الجميلة، كانت تذوي يوماً بعد يوم قبل أن يشاع عن موتها بالزرنيخ، وذلك، بالتأكيد من جراء سمٍ بطيء التأثير كان يسقيها به نيازي بيك في قهوة الصباح، وتؤكد النسوة بأنهن شاهدنها مرتين قبل أن تختفي. في المرة الأولى كانت قد نحلت واكتسى وجهها بصفرة الموت، وفي المرة الأخيرة بدت فيها جلداً على عظم، مزرقة الوجه، يتناثر شعرها كالعشب اليابس، لا تقوى على فتح الباب الواسع لدارتهم، هكذا يفعل السم بالإنسان، ونيازي بيك هذا الشيطان الرجيم الذي يكفر كل مساء، لا يتردد بحقده في أن يسقي السم لأي كائنٍ يكرهه، ويستدلون بذلك من تلصص الأطفال الذي شاهدوا في حوض حديقة نيازي أسماكاً ميتةً تطوف على الماء.
مهما يكن فقد مكث نيازي بيك وحيداً وقد شاخ، نسمع صوته الهادر يطلع من الحديقة حيث سريره الوسخ، متجاوزاً الأشجار والجدران، يُسمع الناس لعناته، كان لا يزال يجادل ويجدّف بالرب: لماذا يأخذ روحه ويترك كل هؤلاء الناس ثم يصفهم بأرذل الأوصاف. يناديهم ويسميهم بأسمائهم واحداً واحداً.
هذا يا رب رشيد رضا، قل لي ما نفعه في الحياة غير أن يستجدي، وهذا نصرة الأعرج وذاك فتحي محمد ورشيد شكر سارق الصابون، لماذا لا تذهب إليهم، وهل يستحق هؤلاء الحياة؟
كنا نعتقد بأن نيازي بيك يرى الله بصورةٍ ما ليخاطبه عياناً، وعندما كنا نتسلق عمود الكهرباء الملاصقة لحديقة داره ونتلصص من خلال أغصان الأشجار، لا نبصر الله ولا نرى كتلة النور هناك، لقد حجب الله وجهه عن الجميع، بينما كنا نرى نيازي بيك يتقلّب على سريره ويسعل حتى الاختناق، ثم يجأر لاعناً الدنيا والآخرة.
لا أريد أن أموت.
لا أريد أن أرحل من هذه الدنيا.
ويمشي قره حسن لصق الجدار عندما تكون مهمته قد انتهت في الحارة، حاملاً منضدته، يسمع الصوت العالي للعجوز، ولم يكن يعير كبير اهتمامٍ لما يحدث خلف الجدار، ولكنه متأكدٌ من أنه سيغسل نيازي بيك عاجلاً أم آجلاً، كما قال: يضعه فوق منضدته، يقلّبه، لكنه لا يعطره بالكافور.
(18)
بعيداً عن الموت، لكركوك رياضيوها الذين يربّون أجسامهم، ويتصارعون في مساحةٍ دائريةٍ واسعةٍ حفروها في الأرض لتكون ميداناً لتلاحم الأجساد المعروقة، يحملون الأثقال ويلعبون بـ “الميل”. يمررونه تحت آباطهم ويضعونه خلف ظهورهم ويرفعونه أعلى رؤوسهم، على نمط ما يفعل البهلوان. بل إن الناس تطلق عليهم هذا الاسم، وتقام الاحتفالات عندما يتصارع هؤلاء مع بهلوان يأتي من إيران أو من تركيا، ويجري النشاط بتشجيع المتصارعين وبقرع الطبول على إيقاعٍ خاص، حيث تُمهّد للمصارعة مشاهد لوي القضبان الحديدية أو كسرها على الصدور بمطرقةٍ ثقيلةٍ تهوي على أزميل.
أما المغنون فهم عشاق المدينة وشعراؤها المشبوبون بالحب، يكثرون في الخلاء وفي الأزقة بعد حلول المساء، يضعون الطاقيات مائلةً على رؤسهم ويقرأون أشعاراً شعبيةً متداولة، أو هم يؤلفونها، يرفعون أصواتهم المغمّسة بعاطفةٍ واضحة أمام دار الحبيبة بعدما يكرعون قنينة “عرق” يطيش برؤوسهم، وهم يغنون بالتركمانية:
حبّذا لو أكون صخرةً بأسفل القلعة
لأعقد الصداقة مع كل من يمر بي
وأكون أخاً لمن أخته جميلة.
وتنداح الأصوات الرخيمة بعاطفتها المعلنة في ليالي أصياف كركوك، مسموعةً في السطوح التي ينام عليها الناس، وليفكّر، وليستحضر كل منهم همومه فيكثر في اللحظة عشاقٌ، أو من يتخيل العشق، ويغمس قلبه في أحزان الحب ليغتني بتلك العاطفة النبيلة، ويطهّر نفسه من الخيبات، محدّقاً في السماء الصافية بنجومها الغفيرة.
(19)
ولكن أعمق مما في القلب من عواطف، تضع الشعر على اللسان وتطلقه بالأغنيات، هو الفكر الذي يبذر بذرته لتنبت الفلسفة، كان لكركوك فيلسوفها الذي يفكّر ويتأمل في الحياة، ويعتبر التفكير والتأمل وقوداً ضرورياً للمعرفة وإغناء الروح، كان فيلسوف كركوك يحب ويكره ما يحيط به من ظواهر، ويحلل ذلك لمن يسأله تحليلاً فكرياً، فيلسوف كركوك هو صلاح ده ده، رجلٌ ملتحٍ ذو أطراف قصيرة، يرتدي قميصاً أبيض طويلاً يغطي بنطاله الوسخ. وكان يقضي معظم وقته في بستانٍ بعيدٍ يمضي إليه صباحاً ويعود منه في المساء، ماشياً بخطواتٍ وئيدة على طول سور يحجب نهر “خاصه صو” ذاهباً إلى مكانٍ لا نعرفه. وكثيراً ما يقضي ليالي الصيف في سقيفةٍ بالبستان شيدها من صفائح معدنية صدئة، يكتب هناك ويؤلف ليكمل فلسفته في ما يسميه “المادية والروحانية” دون أن يعبأ بنشر كتابه المزعوم، كان صلاح ده ده رجلاً متقشفاً، بل معدماً، إلا أنه لم يستجدِ مطلقاً، وعندما كنا نسأله عن فلسفته يبدأ بالحديث الهادئ والرصين عن جوهر الحياة، ويقول أشياء كثيرة عن ثنائية الروح والمادة، ويؤكد بأن الحياة جرى تخريبها من قبل المادة التي طردت الروح، لقد حولت المادة الحياة والعالم إلى كورة زنابير، يقاتل الناس بعضهم بعضا، والأبناء ينقلبون ضد آبائهم.
وكان يكره ماركس وجمال آتاتورك كراهيةً عظيمة، ويرى فيهما الرذيلة والرمز الذي يثير الشر، لأنهما حاربا كل ما هو روحي، وهو يأتي على ذكرهما كلما تحدث.
لم نكن نعرف على نحو مفصّل من هو ماركس، وماذا فعل آتاتورك، إلا أننا ندرك كراهية التركمان لصلاح ده ده لأنهم في الغالب يكنّون الاحترام لزعيم تركيا الجديدة، ولم يكن صلاح ده ده يهاب تنكيل تركمان مدينته أو يخاف غضب الشيوعيين، لأنه عميق الإيمان بفلسفته، بينما يعتبره الناس مجرّد رجلٍ خرفٍ متشرد، يحشو رأسه وجيوبه بأوراق مدعوكة لا يُقرأ فيها شيءٌ منطقيٌ واضح.
وكان صلاح ده ده يملك منطقه في نقد الشعر، وينأى عن كتابة أنماط منه تُعنى بالمديح أو الغزل المفضوح أو بالحكمة، كان منطقه أن الشعر الحقيقي الذي يغني الإنسان هو شعر التصوف والعشق الموجه إلى الروح الخالدة، تلك التي هي مقترنةٌ بالله، والتي تُغطي الكون، وكان يذكر أسماءً مثل بالحق حامد وليلى العامرية والشيرازي وطاغور.
لم يكن صلاح ده ده يتوسّل إلى صداقة مع الآخرين أو يطلب مريدين لفلسفته، كان يفضّل العيش وحيداً، يتأمل في عزلته العالم بخرابه وجماله ليكمل فلسفته، يتأمل طويلاً في من يسأله عن أمر ما فيتركه ويمضي، أما بعض اليافعين فقد كان يتحدث إليهم بخجلٍ ملحوظ، ويفكّر أنهم لم ينغمسوا بعد في عالم المادة الدنسة، ولأنه كان يردد بأن الروح عظيمة باقية، تغادر الجسد حينما نموت، كنا نتمثّل تلك الأرواح بعد كل حديثٍ معه، لنراها ترفرف من حولنا، أو تجلس معنا على الكراسي الحجرية وتحت أعمدة الكهرباء منتظرةً لأن تحلّ بمولودٍ جديد أو أن تحلّ فينا.
*نص: مؤيد الراوي
*المصدر: العراق/ البيت، مجلة مشارف الفلسطينية العدد 22 أكتوبر 2003.