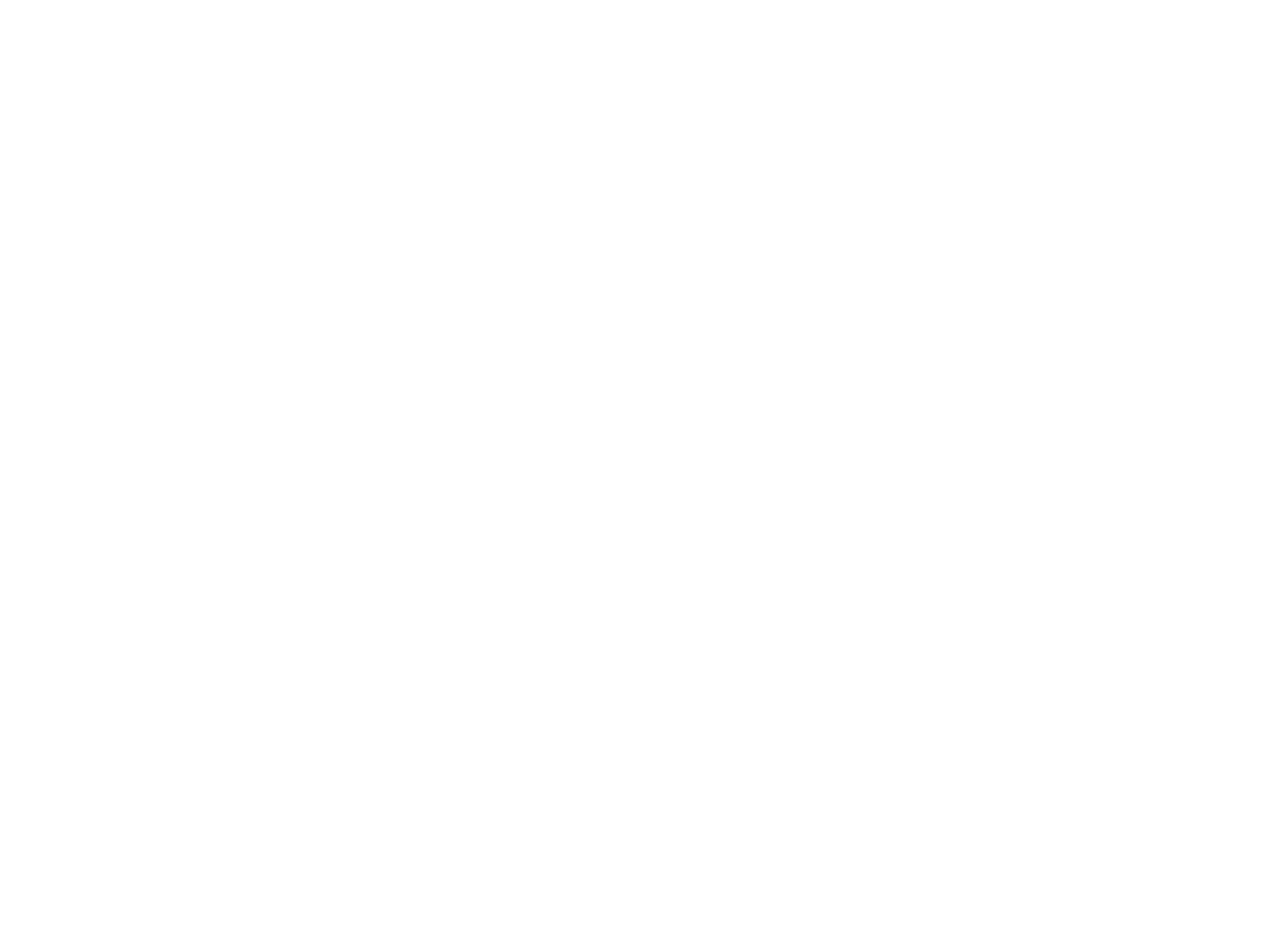الرياض الرمادية – رواية لمحمد الحكيم
الرياضُ الرمادية
نصوصٌ سرية تُنشر لأولِ مرة
محمد الحكيم
الإهداء
إلى منتصفِ الليل..
وإليها
أنخابُ الكتابة.
اسمي حنين محمد، وأنا لستُ كاتبةً، لكنني أمارسُ الكتابةَ ما بينَ حينٍ وآخر، كأسلوبٍ مضمون للبقاءِ على قيدِ الحياة، وهو ما جعل مثل هذه النصوص تجتمعُ بين أيديكم في كتاب، كما أكتبُ أيضاً وفاءً لمعلمتي في الثانوية، أبلة سلمى، ولصديقي زياد، الذي شجعني قائلاً:
– الكتابة ستُحرركِ من بدائية العهر في عالمٍ أصيلٍ فيه، لتصبحي عاهرةً مُحترفة، عندها سيصغي إليكِ العالم مُرغَماً.
وهذه النصيحة أولُ ما سيعترضُ عليه قارئي المتحفظ، ويلومني عليه قارئي العاقل، أما قارئٌ آخرَ أعرفه جيداً، فسيشغله الفضول ويتجاوز طبيعة النصيحة، ليسألني عن قائلها، أطمئنك يا عزيزي، سأحكي عنه لاحقاً، لكن لنركز الآن على مضمون النصيحة، من أجل المتحفظين والعاقلين، دعوني أسألكم بالله، أليس هذا العالم الذي نعيشه: داعراً، فاسداً، كأثقلِ ما يكون الفسادُ وطأةً وشدةً، ومع ذلك نحبُ أن نتظاهر بالخير؟ أليسَ هذا العالمُ عجيباً في معاييره؟ فالفاسدُ قد يكون رمز الخير في أحوالٍ كثيرة، حتى وإن كنا نُدرك زيفه وفساده.
نعم ثقافة الخير منتشرة بيننا، حتى بيني وبيني، لا أكادُ أنجو من ذلك، فأجدُ نفسي مضطرةً لأن أجيبَ حينَ يسألني والدي وأنا شاردة البال:
– حنين، هل أنت بخير؟
– نعم بابا، أنا بخير، الحمد لله.
وهذا دفعني أكثر من مرة أن أتساءل: أيُّ خيرٍ نعنيه حينما نحيطُ أنفسنا بأوصاف الخير من كل جانب، ونحمدُ الله عليه، فوجدتُ أنه الأمل، نعم، إنه الأمل بأن يكون الخير هو السائد، الأمل في الله صاحب الخير كله، وأن يكون نصيبنا من خيره وفيراً، ومع ذلك، كلنا يعلمُ جيداً مدى القهر والظلم الذي نعيشُ فيه، وكلنا يُدرك طبيعة الواقع المفروض علينا، فالفاسدون يجثمون على صدورنا كالموت، لا يُجدي معه سوى الاسترجاع، واستحضار معاني الابتلاء وتذكر جزاء الصابرين.
بل من عجبٍ أننا لا نستقبلُ الأخبار السيئة، والمصائب إلا ونُشهرُ في وجهها الخير، فلن أنسى صديقتي المؤمنة، وسأخبركم باسمها لاحقاً، عندما كانت تخفف عني عبء التشخيص الطبي الذي أفاد بأنني أعاني من التهاب مزمن في بطني، وأن سببه قد يكون ورماً سرطانياً في الكلية اليسرى، لم يشأ الطبيب أن يؤكدَ لي، وأنا لم أصر على المعرفة. عندها قالت صديقتي تواسيني بعاطفة حقيقية:
– خير خير يا حنين، كل شئ سيكون بخير.
نعم، نعم، كل شئ سيكون حتماً بخير، لو توقف الأمر على جهازي الهضمي، لكنه للأسف يتجاوز لرئتي، فلم أعد أستطيع التنفس، ولعيني، فلم أعد أرى سوى الرمادي، ولقلبي، فلم يعد يشعرُ سوى بالكره، وأصدقكم القول، أنا أمتلئ غضباً، أعرفُ أن من بينكم طبيبٌ نفسي في وسعه تقديمَ نصيحةٍ لطيفةٍ إلي، بعدما يستجوبني بعشرات الأسئلة، ومن بينكم رجل دينٍ سيقول لي حديث النبي عليه السلام: لا تغضب، ومن بينكم أخصائية أعرفها جيداً ستوجهني لاستغلال طاقة الغضب في ضرب كرة التنس أو حتى السباحة، أووه أيها القراء، أعرفُ أن من بينكم من يستطيعُ تخفيف غضبي، ويقول لي:
– خير.. خير يا حنين، سيكون كل شئ بخير.
حسناً، حتى لو حافظتُ على هذه الروح الإيمانية، لابدَّ أن أثور، أن أفجِّرَ غضبي، والثورة في نظري فرضُ كفاية، لابدَّ أن يقومَ بها أحدٌ ما، لابدَّ من الشرير الذي سينطق بالاعتراض الغاضب، لابدَّ منِّي يا أصدقائي. أرأيتم حنيناً غاضباً من قبل؟ قد تكونُ هذه فرصةٌ مناسبة للتعرفِ على شكله ومعالمه.
أعرفُ أنني خرجتُ عن الموضوع، هذه ليست بداية جيدةً لروايتي، لكنني أؤكد لكم، فقط أردتُ التعارف، أردتُ أن تعرفوني، ولا أعرف كيف يتم ذلك في الروايات، لذا أثرثر على سجيتي، لكن لنعد إلى أنخاب الكتابة.
أحب أن أخبركم، مع أنني لستُ كاتبة، إلا أن كتابتي كلها نخب الجمال.
نخبَ كل ما أؤمنُ به ولا أجده.
نخبَ المباشرة في السرد، و أجدني أفعلُ ذلكَ بكلِّ تمتعٍ نقديٍ أحصلُ عليهِ بالسخريةِ من واقعي وواقعِ من حولي في حالةِ كانَ بائساً ولو بمقدارٍ ضئيلٍ لا يعجبني.
أكتبُ نخبَ صديقاتي المدحوراتِ على قارعةِ الأيامِ ، يتسولنَ من الدنيا حظاً طيباً، أو رجلاً نصفَ شرير، ونصفَ ساذج، أو ينمنَ على حلمِ الاستقلال الذاتي المرتبطِ بالاستقلالِ المادي، ويجاهدنَ دائماً ليكنَّ بخير.
أكتبُ نخبَ انهيارِ الجمود، والثورةِ على العاداتِ البليدةِ المتحجرة.
أكتبُ صريحةً بما يكفي لأجرحَ، وغامضةً بما يكفي لاحتواء الكارثة، فلا كتابةَ تفي لفداحةِ ما تعانية المرأة العربية.
أكتبُ كمراهقةٍ في طورِ النضجِ، أضجرها كلُّ من حولها، محاولين قدرَ جهدهم تلقينها كيفَ تخضعُ لرجل ، وهي لا تريدُ ذلك .
أكتبُ نخبَ الأدوارِ المفقودةِ للمرأةِ في كلِّ العصور، أكتبُ كحكيمةٍ نالَت من الحكمةِ فجأةً ما لا يُقدرُ بكنوزِ قارون، كشاعرةٍ باشرت الرؤيا وانهالَ عليها إلهامُ البصيرة، كروائيةٍ منشغلةٍ بتحويلِ الواقعِ إلى فنٍ أدبي، كمؤرخةٍ تؤرخُ لأحداثٍ لن يذكرها أحدٌ بعدَ ذلكَ ، لأيامٍ لن تعودَ دورتها للوجود .
أكتبُ نخبَ الضباع وكلاب المرأة، نخبَ كلِّ من يريدُ انتهاكَ حُرمتي، هذه أنا عاريةٌ تماماً، مضطربةٌ كما ينبغي لضحية، سأغمضُ عينيَّ، وأدعُكم تنهشونَ لحمي دون أن أفسدَ عليكم المتعة بنظرةِ تقزُّزٍ واحدة، لكنني سأعلمكم بالطريقةِ الأصعب، كيف تتقززونَ من أنفسكم، إن كانت لديكم أنفس.
وأجدني في هذا العالمِ المريض الفاسدِ، لا أدَّخرُ جهداً في محاولةِ شرحِ الأمورِ من وجهةِ نظري ، رغمَ علمي التام بأني أسبحُ ضدَّ التيار ، وأسيرُ عكسَ اتجاه السير. وبأن كثيراً ممن سيقرأونَ كتابتي سيلعنونني معَ أولِ لفظةٍ تخرجُ من أفواههم ، ويحدقونَ بي معَ أولِ نظرةٍ تتهمني بها عيونهم. وسيحاولونَ ردعي بكلِّ الوسائل ، ويطاردونني بكلِّ الأماكن، ويمزقون أوراقي في ميدانٍ عام.
لكنني لن أكون هنا. ولن أذهبَ إلى هناك. سأختبئُ في أوهامِ الجميعِ حتى أبيدها ، وأصلي بعدَ ذلكَ من أجلِ أن يكونوا قد فهموا أني لستُ الشريرةَ كما يبدو ، ولكنني ضحيةٌ تعرفُ كيفَ تتألم بمنطق، وتحولُ ألمها إلى درسٍ وعبرة. بل وإلى نصوصٍ أكتبها بكل قطرةٍ من دمائي المهدورة، وأنفاسي الضائعة، وأحلامي المسروقة.
مدخلُ الكتابةِ: بابُ الليل
في الطريقِ إلى الليلِ، ليلِ الرياض، وليلِ الجملةِ العربية، وليلِ المرأةِ العربية، تواجهني عدةُ خيباتٍ تبدأُ معَ أولِ معضلةٍ نحويةٍ، تتحولُ مع الوقتِ إلى خيبةٍ وطنية، مُروراً بكلِّ التفاصيلِ الرديئةِ التي تَقودني هذه الليلة للعواءِ بألم، علَّ الرياحَ التي تنفثها هذه المدينة، تنقلُ حنيني للذئبِ الرابضِ في سفحِ الجبل، فيشعرَ بالاطمئنان على وجوده.
الحياةُ لا تتسعُ للكثيرِ كما قد تتسعُ ذاكرتي كأنثى، وكامرأةٍ تنحدرُ من قومٍ لَطالما اعتبروا المرأةَ سقطَ متاعٍ دنيوي، وفتنةً شريرةً لابدَّ من تقويضها وقمعها حتى لا يستفحلَ شَرُّها، سأحدثكم عن المرأةِ العار، بدءً من وأدِها والأفكار التي بررت لهذه الجريمة، وحتى جاءَ الإسلامُ فأوقفَ الفعلَ لكنه لم يُلغِ الفكرة، لم يُفند المنطلق القَبلي، لم يغسل العقول الحافية كأقدامها، لم يُداوِ المرض العُضال، إذ سرعانَ ما عَاد وأدُ المرأةِ بصورةٍ أخرى، وعلى هيئةٍ أكثر وحشيةً وقسوةً من قتلها ودفنها تحت الرمل وهي حيةً، أنا أتحدثُ عن ألفٍ وأربعمائة سنةٍ من عمرِ العالم، وهو وقتٌ قصيرٌ لم يَلبث أن انقضى بكل ما حدثَ فيه، وولدتُ أنا بعد أن ألغى الإسلامُ هذا الفعل، لأكتشفَ بوجودي في هذا العالم ألا شئَ انتهى حقاً، وأن الإسلامَ كانَ عابرَ سبيلٍ في هذا المكان، لم يلبث أن رحلَ وهوَ يعضُّ أصابع الندم على ما قضاه من وقتٍ وجهدٍ في هذه المنطقة من العالم. ألم يكن أجدرُ به المحاولة معَ آخرين، معَ شعوب المغول مثلا، مع أمةِ التبت، مع الهنود الحمر، مع أي جماعةٍ أخرى وأي مكانٍ آخر، لكن ليسَ جزيرة العرب، ليسَ نجد. وعجباً إذ يُصدِّقُ الوحيُ هذه الحقيقة فيقولُ الله في القرآن: الأعرابُ أشدُّ كُفراً ونفاقاً، وأجدرُ ألا يعلموا حُدودَ ما أنزلَ الله.
نعم الأعرابُ أكثر الناس تفوقاً في عدم صلاحيتهم لحملِ أي رسالةٍ فكرية، فضلاً عن أن تكون رسالةً سماوية، وأهلُ الجزيرةِ، لم ينفكوا يوماً عن كونهم عرباً أعراباً، إلا أن الإسلام هذبهم لفترةٍ من الوقت، فاستكانت نفوسهم وصَلُحت بالدينِ الحقيقي، لكنهم سرعان ما عادوا إلى طبيعتهم البدوية، مما يعني أن الدين قد رحلَ عنهم، مصداقاً لقول ابن خلدون، أن العرب جنسٌ لا يصلحُ إلا بدين، فإن كان الدينُ قد أصلحهم لبعض الوقتِ، ثم فسدوا، فذاك لأنهم قتلوا الدين، ودفنوا جثته تحت نعالهم.
هذه جزيرة العرب، لم تمكث فيها الحضارة إلا بمقدار ما مكثَ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تعد الجزيرة مرةً أخرى منارةً للدين أو العلم، بل انتقلت خيراتُ الدين وصلاحه إلى عواصم عربيةٍ أخرى، فتارةً بغداد، وتارة دمشق، وتارة القاهرة، وتارة قرطبة، لكن ليست الجزيرة، ليست الرياض، ليست أرض الرمال المتحركة التي تبتلعُ كل الخطوات.
لقد أصبحَ الوأدُ للمرأةِ العربيةِ فعلاً وُجودياً، تُطمرُ به المرأةُ طوالَ حياتها،لم يُلغَ الوأدُ كما يتشدَّقُ العلماء، ويسوقون الفضلَ للإسلام في تغييرِ عاداتِ العربِ الجاهلية، والإبقاءِ على محاسنهم، وتغييرِ سيئهم، كلا، لم يحدث أيها العالم، إنني لم أرَ أي تغييرٍ حاصلٍ منذ ولدتُ وحتى لحظةَ كتابتي لهذه النصوص. وسأحدثكم عن ذلك، عن قومي الأعراب في عصرِ الفضاء، نعم الحريةُ خطرةٌ، لكن لا يجبُ سلبها، كيفَ سيعيشُ الإنسان دونَ حريته. كيفَ يطوقونَ الأفكارَ في مهدها كي تُقمع؟
سأحدثكم عن قوميَ المسلمين عندما أصبحوا فارغين، وخاويين، عندما أصبحَ الإسلامُ هالةً تحيطُ بالمجتمع الأجوف، الفاسد، الذليل، الغارق في وحل. سأحدثكم عن الأعرابِ الذين ليسوا جديرين بمعرفةِ حدودِ ما أنزلَ الله، عندما أصبحو رجالَ هيئة، وأصبحو أوصياءَ على أخلاقِ الناس ودينهم وشؤونِ حياتهم، وسأحدثكم عن الأعراب عندما أصبحو وُصاةً على المرأة، فعادوا لممارسةِ جشعهم القديم، واستيقظت أمراضُهم القديمة التي انتقلت مع الدماءِ العربية الأصيلة كُسلالاتِ الضباع، ولم يُفلح أيُّ دواءٍ في التاريخ في شفاءِ هذه الأمراض، حتى القرآن الذي يعتبرهُ العربُ فخرهم وذُخرهم ودينهم كله.
خُلقتُ إنساناً أنثى لأكونَ خليفةُ اللهِ في الأرض، ولم أتصور يوماً أن هذه المهمة مقتصرةٌ على الإنسانِ الذكر كما يحاولُ الجميعُ إيهامَ المرأةِ المسلمة، أنا مُسلمةٌ لأكونَ عظيمةً في الدنيا والآخرة، خُلقتُ حُرةً لأكونَ صانعةَ عوالم، ولم أخلق لينيكني الرجل صانعاً من جسدي مائدته، ومن عقلي ممسَحةَ حذائه.
يُمكنني أن أقولَ اليومَ أن ذاكرتي التي تحملُ في أحشائها البكرِ بوحاً لم يخرج قبل اليوم، تتمشى في سياقٍ تعبيريٍ لم أفهمه بعد، ولم أتعود عليه، ولستُ مُستعدةً للخوضِ فيه، فأنا لم أختر أن أكونَ كاتبةً، هذا يُساوي بالنسبةِ لي أن أظلَّ على قيدِ الشعورِ بفداحةِ ما أكنه في داخلي، والتذكر الدائم لمدى خسارتي في هذا الوطن، ومدى العذاب والاغترابِ النفسي الذي تعيشُ فيه المرأة العربية، وهذا يعني ألماً لا ينقطع، فمعَ كلِّ مَخاضٍ تدفعني إليهِ الكتابة دون أن أستعدَّ في الغالب، أشعرُ بشعورِ امرأةٍ تم اغتصابها، واستخدامها من قِبَلِ مخلوقاتٍ سُفلية لإنجابِ كائنٍ بشع؛ كائنِ الكتابة.
ما أغربَ أن تُغتصبَ هكذا، أن تُدفعَ دَفعاً إلى الكتابةِ لأنه ليسَ لديكَ غيرها، فحتى الصراخ، حتى الإجهاض، لم يَبلغ يوماً مَرتبةَ الفضائحيةِ التي تُرضيني، لم يبلغَ حدَّ التعريةِ الكاملة التي تدفعُ بمصاصي الدماء – دمائي ودماء المرأة – عُراةً إلى ضوءِ الشمس.
لطالما عانيتُ من مقتي الشديد لما أحمله في داخلي، لما يُحيطُ بي من مظاهرِ البلادة الوطنية والدينية، لطالما تَمنيتُ استفراغ ما بداخلي، وركلَ ما يحيطُ بي، لم يكن لدي مانع يوماً أن تنزلَ ذاكرتي على هيئةِ جنينٍ مشوه، أو حتى قيحٍ ينزُّ من المخ، فلأنَّ الجرحَ مفتوحٌ، والعتمةُ لا ترحمُ النزف، فما أسهلَ أن يجترئَ الإنسانُ على وجودِهِ إلى حدِّ اقترافِ الكتابة. فالصراخُ خُروجٌ صوتي لانفعالٍ قد يظلُّ كامناً، أما الكتابةُ فهي الوصفةُ المثاليةُ تماماً لما يجبُ فَضحه، لا السينما، ولا الموسيقى، ولا الصوت، بإمكانهم أن يكونوا أكثر فَعاليةً.
أن أكتبَ كلَّ هذه الفوضى، وأعاني لوحدي حالةَ الكتابةِ عنها، أن أتوغل عميقاً لأجسَّ نبضَ المدينةِ الكئيب، وإيقاعها الصحراوي الجاف الذي يَطمِرُ كلَّ شئٍ بقيظِهِ ودوَّاماتِهِ الرملية. إنه ليسَ أمراً جميلاً، ولا فاتناً، أن أكتبَ عن عوالمَ سُفليةٍ تعيشُ في الذاكرة، أن أكتبَ عن الجفافِ الذي يسري في الدماء، أن أكتبَ عن تشقِّقِ شرايينِ القلب، عن ضياعِ الغريزةِ، وانفلاتِ التحكم، عن العطشِ الروحي، عن محيطي الرملي من الأفكار الاستسلامية التي عشتُ بها واعيةً لها، ما أشدَّ الوعيَ بأنك ضحية، غريزةٌ متوحشةٌ بَرِّيةٌ وُلدت وَكبُرت في قفصٍ حديدي، لكنني أدركُ أن هذه البداية، بدايتي، وبداية عهدي الجديد، لذلك سأكتبُ، بعدَ منتصفِ الليلِ كعادتي، ربما يمكنني أخيراً أن أصل إلى نهايتي المخبوءةِ في مكانٍ ما في عتمةِ الجملةِ العربية، وأنا لا زلتُ امرأةً تتلفعُ برداءِ الليل، تتشبثُ بحقها في الوجود، وفي القول، وحتى الصراخ الذي لا يُجدي نَفعاً في هذه الصحراء المترامية الأطراف.
ومعَ ذلك؛ ليست الكتابةُ أمراً سهلاً، ولا هوايةً يمارسُها المرءُ في أوقاتِ فراغه، إنها فنُّ تعريتنا أمام أنفسنا والآخرين بطريقةٍ لا تُهين، وهي أكثر فضائحيةً من أي شئ آخر مارسته في حياتي كأسلوبٍ للإخبار. لم تفلح سوى الكلمات في صياغةِ زمني كما أريده، وفي خلقِ عالمي كما أتخيلُه، وهذه هي تجربتي التي سأحملها للعالمِ كإنسانةٍ أُجبرت أن تلعبَ دورَ امرأةٍ عربية، ولم يكن بيدها لدفعِ ذلك سوى أن تكونه؛ لتَتَخلصَ منه. أحياناً نختارُ الألم كي لا نشعرَ بأننا فارغون.
أوراقي المبعثرةُ على سريري الذي يُعتبرُ مكتبي أيضاً، تقودني الآنَ في طريقٍ يصعبُ خوضُهُ ذَهَابَاً، ويستحيلُ الرجوعُ منه إياباً، فما إن واتتني فرصةُ نشرِ هذه النصوص، حتى علمتُ أن الكتابةَ قد اتخذت قرارَها، ولا حِيلةَ لي في الاعتراض، وكلُّ ما يُمكنُ عمله هو تَقديمها في موكبٍ لائق.
رُزمةُ أوراقٍ تمتلئُ ليلاً حالكاً، تُضيئه أضواءُ المجالس الخاصة، وتفوحُ فيه روائح الخمر، ويتكاثفُ دخانُ الشيشة ليشكلَ سحابةً بيضاء في سقفِ المجلس، وأنا أدورُ بعيني خلالَ حلقةِ السُّكرِ والرقصِ، وداخلي يدورُ لينزوي إلى الداخلِ أكثر.
في الرياض، تبدأُ الحقيقةُ في الظهورِ بعدَ التاسعةِ مساءً، ويمكنُ رؤيتها في توقِ النظرات، وإسراعِ السياراتِ في الطرقِ التي تؤدي إلى التجمعات السكنية الخاصة ( الكمباوند)، والشقق الفاخرة، ويمكنُ الإحساسُ بها خلفَ العباءاتِ السوداء التي يلاعبها النسيمُ أثناءَ عبورِ المسافة القصيرة من بابِ السيارةِ إلى بابِ الليل، لتختفي وراءَ تجاويفه المعتمة نساءٌ سُرعانَ ما يَخلعنَ الظلال السوداء، ليُصبحنَ أخيراً على طبيعتهن، أكثرَ نُضرةً رغمَ الصحراء، وأكثر توقاً رغمَ قسوةِ التجربة في مجتمعٍ لا يزالُ بإمكانه وأدُ المرأةِ وإلغاء كيانها والتخلصُ من وجودها.
تبدأُ النساءُ في حياكةِ الهواء وترطيبه استعداداً للسهرةِ، ويبدأُ الرجالُ في إدارةِ كؤوسِ الشراب، وسحبِ أنفاسٍ عميقةٍ من مِرجلِ المعسلِ الجالسِ معهم، لتبدأ الرؤوسُ في التماهي، والعقولُ في الضبابية، ولتبدأ ليلةٌ جديدةٌ من ليالي الرياض، ودائماً في هذه اللحظة، تبدأ أفكارُ كتابتي أنا، فأظلُّ أرقبُ على مَهلٍ كساعةٍ رملية، وأختزنُ الأفكار معَ ما أستنشقهُ من دخانٍ ورائحة.
كلما مضى الوقتُ أتأكدُ أن الرياض، رُغمَ أنها مدينةٌ مُلتزمةٌ ومُحافظةٌ في ظاهرها، وتتمشى فيها سيارات هيئةِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمتلئُ بالكائنات اللطيفة التي تستنكرُ الذنبَ وتستهجنُ المعصية، وتكتظُّ بالتحريمِ والحظرِ والمصادرة، ويحيطُ بعنُقِها سيفُ رقابةٍ صارم، ترتدي العباءةَ التي يقولون أنها شرعية، وتلتزمُ بالطقوس التي يقولون أنها إسلامية، إلا أنني أتأكد كلما مضى الوقتُ ألا شئَ من هذا حقيقي، فالرياضُ ككل مدينةٍ محتلةٍ بالقمع ومربوطةٍ بدائرةِ المحظورات، تُمارسُ انفصامَاً مَرَضِياً حَاداً، فتتلبسها بالنهارِ سحابةٌ لا تلبثُ أن تنقشعَ في الليل، كغيومِ الصيفِ الكاذبة، عندما ترحلُ وكأنها تسخرُ من أوهامِ السراب.
بِدايةُ الكتابة
نحن في الرابع عشر من ديسمبر 2003.
في هذا التاريخ، بدأ عصرُ كتابتي، وانتهى عصرُ الصمت، كما بدأت النصوصُ تؤرشفُ نفسها تلقائياً في الذاكرةِ، لأقومَ بينَ وقتٍ وآخر بالتخلصِ منها على أوراقٍ أحياناً، وأحياناً أكبها كَبَّاً في جهاز كمبيوتر محمول يرافقني أينما سافرت.
تقول تذكرة سفري بأن الوجهة هي لندن. حسناً إذن، ما دامت كل المدن في النهاية ستمنحني وجهتي، فلا فرق سوى ما تقوله لي تذكرة السفر، بأن الرحيل اختارني إلى لندن هذه المرة. وما دمتُ سأكتبُ أخيراً ما تمنيته طويلاً، فلأدع للبدايةِ أكثر من طريقة، وأكثر من فاتحة، حيث ستكون النهايات متعددة أيضاً.
فلتأخذني البداياتُ كما تشتهي، ولتُسلمني النهاياتُ إلى رحيلٍ لا يكونُ إلا حياةً، وإلى وطنٍ لا يكونُ إلا فكرةً، وإلى حبيبٍ لا يكونُ سوى أنت. لتأخذني النهاياتُ إليكَ، فمعكَ فقط تعلمتُ أن أكونَ كوناً يتمدَّدُ ليحيطَ بنا، وزمناً يتسعُ لأبدٍ ما، ولوعدٍ ما، ومعكَ فقط، سأعيدُ كتابتي بشئٍ من شهوة البوح .
معكَ سأسجلُ اعترافاتي المريضةَ بالزمن، المتلفعة بالصمتِ في كهفِ الذاكرةِ العميق، الواجمة من ذهولٍ ودهشةٍ طالما أضنيا واقعي الملتبس، ومعكَ أيضاً سأتشجعُ لتعريةِ زهور عمري البائسة، وتعريضها لضوء الشمس. سأكتبُ انتقاماً من الأعوامِ التي مضت بلا مَجدٍ، واحترازاً من الهباءِ القادمِ بلا رحمة.
يمكنني أن أقولَ أخيراً، أن هذا العالم الذي أعيشه ليس عالمي، الآن اهتديت إلى ذلك بكل وضوح، بكلِّ ما في جوارحي من قدرةٍ على الإنكار، لطالما كنتُ غريبةً في عالمٍ يمنحني كل ما يريده، ولا يمنحني ما أريده. لطالما كنتُ دخيلةً على قواعده وتقاليده، متطفلةً على أهله، ولذا يمكنني أن أكتب الآن بكلِّ وضوحٍ أيضاً، عاريةً من غبش الأفكار وتضليلات الوهم رمادية اللون، بائسة المزاج. يُمكنني أن أعيشَ من الآنِ فصاعداً بينَ دفتي كتاب، في عالمٍ لا تسكنه إلا الشخوص التي أصنعها، دون أن يَمسني منها أذى، ودون أن يسيلَ دمي الإنساني مرةً أخرى.
فيا أيتها الكتابةُ خُذيني إليكِ
خُذيني إلى نفسي،
خذيني إلى وطني هُلاميِّ الشبه.
خُذيني إليكِ مع الزمان
خُذيني إليه مع المكان
خُذيني إلى صِغري
لأزرعَ في ليالِيَّ الأمان
الرياضُ ككلِّ مدينةٍ منافقة، تفصلُ بينَ عالمِ الرجالِ والنساءِ من أجلِ إشباعِ رغباتها في الشذوذ الجنسي، أو ربما استدرجته لكي يتواجد.
***
العاشرة صباحاً بتوقيتِ الرياض.
فنجانُ قهوةٍ معَ عددٍ قديمٍ من جريدةِ الرياض. ليسَ من عادتي متابعة الجرائد، لكن لا أدري ما الذي ألقى بهذه الجريدة في يدي، لعلَّ أخي تركها خلفه عندما كانَ هنا قبلَ أيام.
شَهوةٌ تضطرمُ بينَ أفخاذٍ عارية، ويدٌ تلوكُ الفراغَ البكر، يتلوَّى جسدٌ لامرأةٍ أثناء استحمامها تحت مياهٍ تقصفها بشدةٍ، ولا ترتوي، تغوصُ في أعماقِ حوض الاستحمامِ لتختنق من الارتواء، فلا تموتُ ولا ترتوي، تُنهي تراجيديا الموقفِ سريعاً، تجففُ جسدها، تضعُ معطر الجسد الناعمِ الذي يتركها تصطلي من رقةِ جسدها وتتعذبُ بأنوثتها، تختارُ ملابسها الداخليةَ بإحساسِ الاستعدادِ لحبيبٍ لن يأتي، إنها العاشقةُ الوحيدةُ لنفسها، تعيشُ في مدينةٍ لا تشبهها، تَخرجُ إلى مَطرٍ يهطلُ ليغسلها، وتردِّدُ الأغنيةَ الشعرية، أغنيةَ حزنها الوحيدة:
مَطرْ، مَطرْ، مَطرْ،
أتعلمينَ أيّ حُزنٍ يبعثُ المطر؟
تنكفئ على نفسها صامتةً، تتأملُ في قطراتٍ شاردة، تُدركُ أنها تعيشُ الإجابةَ وليست بحاجةٍ لناقدٍ يُفسر معنى القصيدة: أنشودةُ المطر.