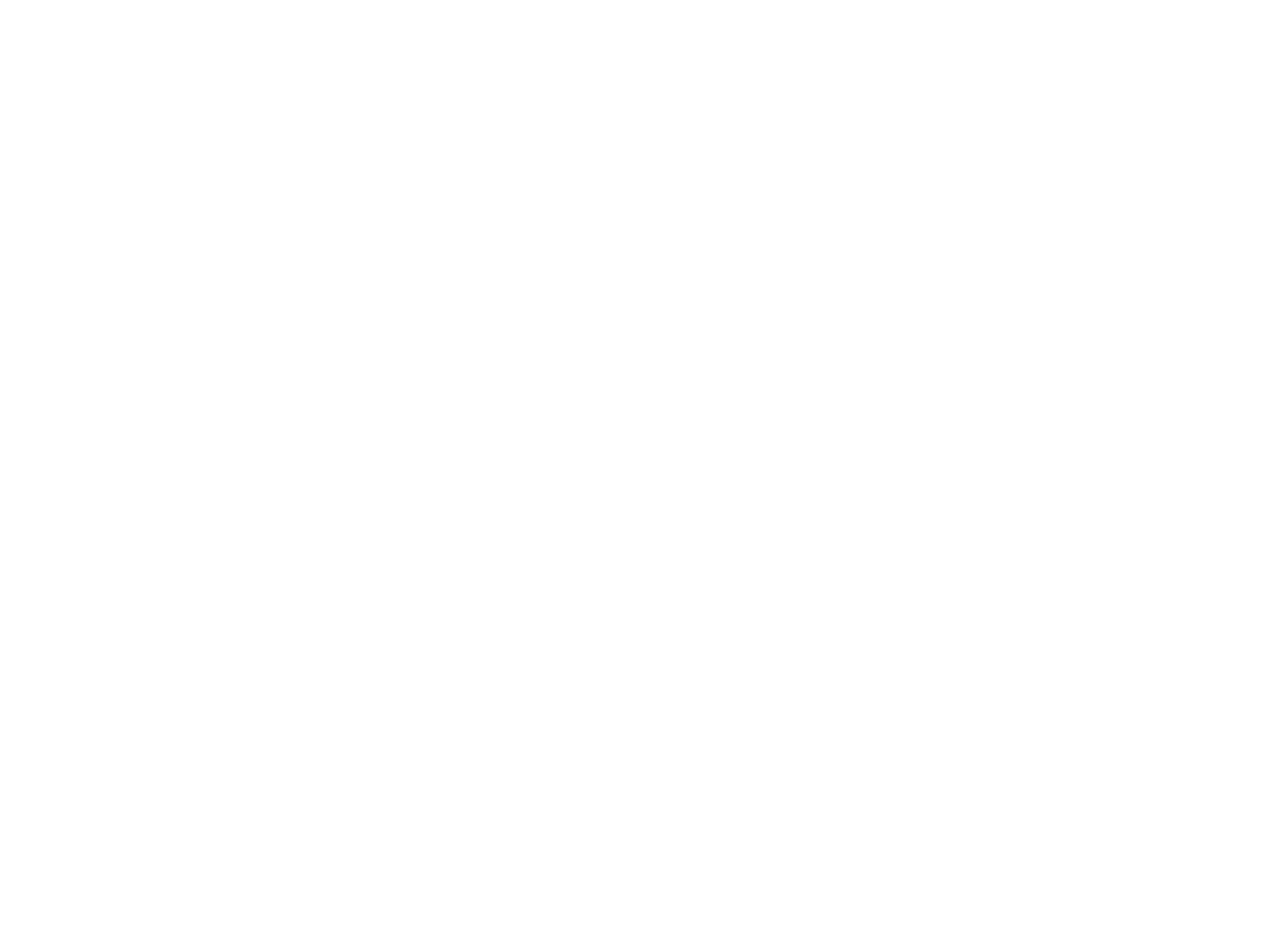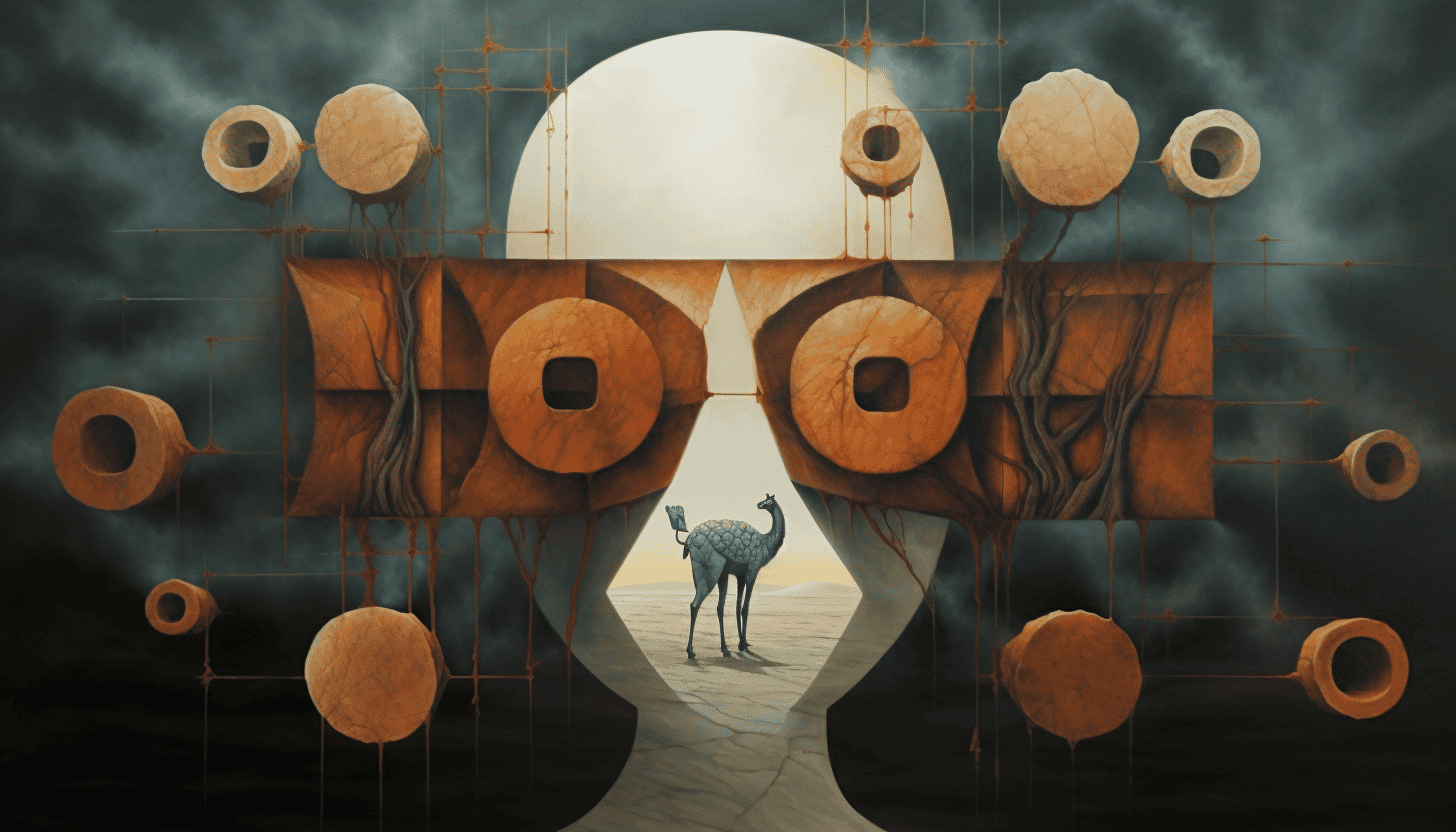

أشعلتُ الفحمَ في جَفْنَة الشواء، المنتصبة على سيقانها الثلاث. كان وعْدُ امرأةِ الأنواء ـ العرَّافة، وهي تقلِّب أمصارَ الأرض طيَّاً بين يديها ـ يديِّ التلفاز العالِم، أن تمنحني ميثاقَ نهار مؤدَّب، غائم قليلاً بطباع الشاعر فيه، فأئتمنتُ النهارَ على شهواتي إلى الشواء. أربع عشرة ساعة مرَّغتُ أضلاعَ الضأن – ـ العظمَ المُريَّشَ باللحم في زيت زيتون من أرض كريْت، مضاعَفِ العُذريَّة، وفي نبيذ أحمر إسبانيٍّ – ـ دموعٍ من رثاء العرب ممالكَ استعادها أهلُها الفرنجةُ بعد نهب. وبين إشراق الزيت وفيض النبيذ أكرمتُ أضلاعَ الضأن بالصعتر اليابس، والثوم المطحون – ـ أبي الفصائل العَسْقوليَّة؛ والفلفل الأسود، الخشن قليلاً -ـ إذا عُضَّ اعترفَ.
أنا الأوحد، قطعاً، من يتدبر في جليد أرض سْكُوْغُوْس -ـ الضاحيةِ شواءً. في حديقة بيتنا القرميديِّ السطح، قرب شجرة بقي اسمُها سرَّاً على استقصائيَ الأسماءَ، عقدتُ للدخان بيْعةَ الإنسان الأول منذهلاً من ذلك الائتلاف الساحر بين اللحم والنار. أشبار من الثلج تغطي الأرض بفراء قَسَمِها ـ قَسَم البياض على فكرته كَلَونٍ. فتحتُ الممرَّ، لليوم الثاني، بالمجرفةِ المعدنِ، من باب البيت إلى مدخل الحديقة، بعرض متر. تكاد الشجرةُ السرُّ أن تجثو في الغمر الأبيض. أثارَ جيراني أن أسألهم، أبداً، عن طيور سْكُوْغُوْس (الضاحيةِ الغابة الجنوب من عاصمة مملكة أسوج)، وشجر أرض سكوغوس. بدوا أنْ لم يفطنوا، من قبل، إلى مساءلة أنفسهم في أسمائها. وقد تمادت اعترافاتهم بالسَّهو عن تحصيل علوم نافلة كهذه، إذْ تماديتُ استقصاءً لسلالات الزهر البريِّ الغامرة ربيعاً وصيفاً. سألتُهم مراجعَ في الحيوان والنبات مصوَّرةً لأستحصل، بأسمائها الأسوجية، مطابِقاتها الإنكليزية مروراً إلى العربية، فأُنْجدْتُ على نحوٍ قليل. وها، في يومي هذا، قرب الشجرةِ السرِّ، وشقيقاتها من العَفْص المائل إلى زرقة أنبتُّهنَّ بنفْسِي فاستطلْنَ ثلاثة أمتار، أُهرِقُ على البياض والبرد، معاً، سَقْسَقة الفحم الممتلىء بعافية عقلِه الرماد. غير أن السماء خَذلت وعْدَ عرَّافة الأنواء، وغدرت بميثاق النهار المؤدَّب: نَثيثٌ ثبتٌ خجولٌ تسرَّب من زقِّ بياضها عليَّ، وعلى الفحم، الذي لم يلجم زفيرَه في مجادلة الشحم العارف، ذي المنطق الماجن في تصنيف اللذائذ. شحم وفحم اقتربا، تحت بصري، من عقد اتفاقهما الخالد على اقتسام الهرطقة كطعْمٍ خالد.
لم أترك للسماء اقتحامَها خيالَ شهواتي أن يُفْسِدَ ما درَّبتُه من لحم، بشفاعة النبيذ والزيت، على الوفاء لدولة الذوق ونظام النكهة. رفعتُ مظلة بيضاءَ القماش عليها شعارُ الحلوى الموكول بالدعاوة القَدرية لبراعات الإنسان. جاري، الممثل الشيخ الأسوجي، أهداني المظلة البيضاءَ – ـ شاهدةَ حانوت الحَلْوانيِّ، الذي كانَهُ قبل عقود. وقد تخيَّرتُ حصانتَها البيضاء على حصانة مظلتي السوداء الأخرى، رِفْقاً بنقوش البياض على لوحه الأزليِّ؛ رِفقاً بثرثرات أعماقي الصامتة أنْ لا أُبدِّدها بالتذمُّر من فصاحة الطقس وركاكة سيدة الأنواء – عرَّافةِ المَعْبدِ التلفاز.
ثرثرات أعماقي، وحدها، بذورُ اتِّزاني في تراب الظاهر. كل يوم هو مرآةُ ذاته عندي، في انتقالي صباحاً من البيت إلى عَرْصةِ الحيِّ المسقوفة بالزجاج، أتبضَّع من مغانم البشر الموفورة، بدراية القانون، ما تصلح به حالُ البقاء على مراتبه: الرفاهة، والضرورة، وما لفّ لفّهما. مشياً أقطع مسالك الغابة، إلى هناك، في ثلاث عشرة دقيقة من سَقْط الوقت أو كريمه؛ شقيِّه أو رخيِّه، بحسب مزاج السماء، ونقمة الكواكب من الكواكب بُعْدَها وقرْبَها، وتأجيل الأبراج سعيَ العناصر إلى صلحٍ، أو التعجيل بخصومةٍ: ثلاث عشرة دقيقة ريحاً عَصْفاً، أو ريحاً رُخاءً؛ هطولَ ثلج؛ مطراً؛ لفحَ جليد؛ لا يستقيم فيها تساوي العدد حساباً. هي ألف أحياناً، ولَمْحٌ أحياناً؛ ثقل أحياناً، وخفَّة أحياناً. لكنها ثلاث عشرة دقيقة من ثرثرات أعماقي الخفيضة، التي يصعد بعضُ حروفها إلى شفتي كالمُكلِّم نَفْسَه، في عبوري مسالك الغابة، المرفهة بحفْظِ جلالها الوحشيِّ، بين البيوت المتناثرة سطوراً واضحةَ الإبتهال بقرميدها للفراغ العريق: لطالما كلَّمتُ دهاقنةً من الموتى في القِدَمِ – كُتَّاباً؛ رساميْن؛ معلِّمي شرائع. جادلتُ أصدقاء لم أسمع أصواتهم منذ عقود. خاصمتُ بعض مَنْ أعرف، وصالحتُ بعضَ مَنْ لم أعرف. وحيداً، في مسالك الغابة، أغدو أكثر تدبيراً للفكاهات المُرْتَجَلة، متألِّقَ البديهة، أُنجزُ العَدْلَ للعالم في ثلاث عشرة دقيقة، ثم لا ألبث أن أعود إلى عالمي – ـ مطبخِ البيت، حيث تجري سننُ حياتي كلها هناك، وفق ظبْطٍ لا تخرج فيه برهةٌ على شقيقتها. ربما أربح نَفْسي بضلال الطهو، الذي أُتقنُه، وأخسرُها بهداية تأملاتي التائهة في شؤونٍ لا تعني أحداً. هي وحدة كالقلعة لا يدخلها إلاَّ شريكة عقدَيْ عمري الأخيريْن، سِنْدِيْ، اليونانية الفلسطينية الأصل، وابني رانْ، ربيب الأحكام في مصادفاتٍ إنفحَّةٍ جمعته على أربعٍ: دمٍ كرديٍّ، ودمٍ يوناني، ودمٍ فلسطيني، ونصف كوز من دم لبناني عن أم جدته. لولاهما لنسيت التحدث بالعربية قطعاً. لا أحد آخر هناك.
في المطبخ، تحديداً، أضع خططاً للقيامة: قراءة في كتب مُرْهَقةٍ. قياسُ شفيرِ النحو وهاوية الصَّرْف. نَحْتُ علومٍ هاربة، تتماوج مع البخار في آنية الطبخ. إقامتي هي هنا، في مطبخٍ دولةٍ من الأفاويْهِ والتوابل تمتحنني وأمتحنها، مستطلعاً من النافذة، أبداً، دورةَ الأزل الصغير: جيران يعبرون الشارع، مُصَنَّفيْ الوجود والحقائق، بحسب قراءات لي في سطور الطرائف: لقد عمد أسلافٌ، أئمةٌ، مِنْ مُصَرِّفيْ الأعراق، إلى قياس خصائصها وفق مراتب الطهو في سيرة الطعام. فالأفريقانُ -ـ السودُ هم من مبالغات الحرارة في الإنضاج: احترقتِ القِدْرُ بمقادير العقل فيها، ببرهان بشراتهم. والصَّقالبةُ، والأَسوجُ الشقرُ هم من خمولٍ في الحرارة لم تبلغ بهم الإنضاجَ، ببرهان بشراتهم. والعُرْبُ نضيجٌ لم تخرج بهم مقاديرُ الحرارة على التقدير الواجب: خصَّصتهم القِدْرُ ببلاغة الشمس اعتدالاً لوناً، واعتدالاً عقلاً. لكنني لم أجد وصفاً للعِرق الأصفر، في سطور الطرائف عن الأئمة. بقي ساكنُ الشارع، الصينيُّ المفرط في تهذيبه، عصيَّاً على تصنيفه بخصائص الطهو. وقد غادر الحيَّ، على أية حال، فأعفانا من اللجاجة في المُشْكِل، الذي لن يُبْعد عنه شبهةَ الإنتماء إلى كَرَمٍ في محْتِدِ يأجوج ومأجوجَ – ـأَكَلَةِ الأسوار.
منذ إحدى عشرة سنة لم أحصل على صحيفة أقرأها. في المطبخ أتسلَّى يوميَ ـ- أيَّ يومٍ ـ – بتقليب صحائف الإعلانات الأسوجية تسقط بغزارة في صندوق البريد الخشبي، عند سياج الحديقة. أبادل المكانَ الصامتَ في يومي الصامت، مشافهاتٍ يدوِّنها حبرُ الملح، حتى عودة شريكتي من عملها، وابني من المدرسة المتساهلة في تربيةٍ مفرطةِ التهذيب: لا غضب. لا توبيخ. لا قصاص. هواءٌ غير ناضج عليَّ أن أوبِّخه فأُنْضِجَه. وها أنا، في نهاري هذا، أمام جَفْنَة الفحم السيد أصنِّف النكهةَ كتصنيف الوجود بلا نوازع في مطابقاتٍ ثقافةٍ للأمكنة، أو مقارناتٍ ثقافةٍ، أو تفارقٍ ثقافةٍ. لا شأن لاختباريَ النوازعَ فيَّ بثقافاتٍ تتقاطع أو تتوازى؛ تتطاحن أو تتهادن. أزمة “الحقِّ” في وجودي تتراجع، برمَّتها، إلى “أزمة طقس”. أرتدي أقلَّ القليل تحت معطفي، في الشتاء الأقسى هنا، بحصانة القيظ صيفاً، والجفاف شتاءً توارثتُهما من الشرق حتى كرهتُ الفصولَ هناك، مبتهلاً إلى عالمٍ جليدٍ تنزف منه الأرضُ بقاءَها الأصلحَ والأردأَ. إنما أخطأتُ الحسابَ، في الأرجح: مملٌّ أن ينكسر البصرُ، أبداً، على جدران من الشجر اللفيف. معذِّبةٌ ريحُ الجليد؛ الثلج المبكر والمتأخر؛ العصفُ الدائم؛ المطرُ ربيعاً وصيفاً رطبيْنِ ضارييْنِ في رطوبتهما. كرهتُ صيف قبرص، وربيعه الحائر، وخريفَه المتَّصل بشتاءٍ جفافٍ، والمياه المقنَّنة كعبثٍ بالروح. وها أنا في حيرة أمام جَفْنَةِ الشواء، التي يعلوها شَبِكٌ تعلوه عظامُ الضأن المُريَّشةُ لحماً: مطرٌ لا يثير. شجرٌ لا يثير. جمالُ طبيعة مذهلٌ من وراء النافذة لا يثير خارجها. إنها استفاقةُ خيالي على ثُغَرِه الطاحنة. بل أنا وخيالي نغدو مؤجَّليْنِ إلى تدبيرٍ لا يحتكم فيه أحدٌ إلى شيء؛ تدبيرٍ فات أوانه.
عصافيرُ قُرْقُفٌ تحوِّم حول البيوت الخشب الصغيرة صنعتُها بآلاتي، وعلَّقتُها إلى السياج العالي بين بيتنا وبيت الجار. قُرْقُفٌ مشدوه قليلاً بهذا الغدر اللاموصوفِ – غدرِ الشواء بالثلج، في نهارٍ يعلنُ مذهبَ الشحمِ صرْفاً بأرض أُوْدِنْ الجديدة – إله المحاربين الأسلاف، رعاة الرَّنَّةِ، والأيائل، وإوزِّ البحيرات.
عَرَقٌ من عيار 45% كحولاً ينتظرني في الداخل. عَرَق تركيٌّ غلبني على أمري مُذْ لا أملَ في عَرَقٍ نبيلٍ من لبنان يربو على 54% قيراطاً ذَهباً أبيضَ في مزاجه. بقيةُ يومٍ ينتظرني في الداخل: قيلولة بعد الشبع. قراءة. صمتٌ كثيرٌ. تطريزٌ عائليٌّ على قماش المصادفات العائلية. كتابةٌ في المساء تتشاجر الصور والكلمات في أسطر الشعر فيها، فلا أتوسَّط لِلَجْمها. كتابة يُضرِبُ شخوصُ الرواية فيها، أحياناً، فلا يحضرون. عشاءٌ خفيف من أُمم الخضر اعتباطاً. نبيذٌ رفيقٌ، وفيلم، وربع ساعة قبل الثانية عشرة، لا أُجاوزها، مغادراً كهفَ الحياة إلى عراء النوم اليقظان.
رُبع ساعة مؤجَّلٌ. لا أعرف لِمَ أدَّخر هذا الربعَ فلا أضع قدمي في برزخ منتصف الليل؟ ربع ساعة مؤجَّلٌ حتى الموت.