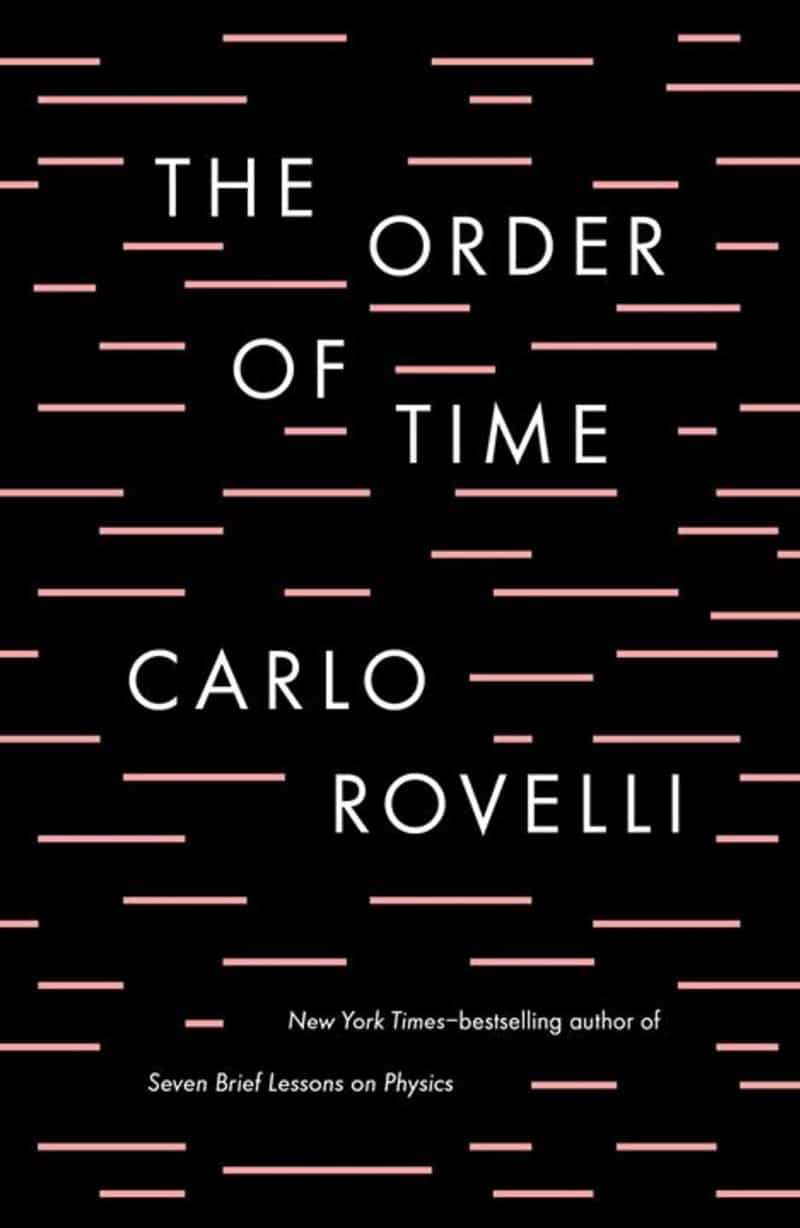أتوقف ولا أفعل شيئا. لا شيء يحدث. أفكر في لا شيء. أنصت إلى مرور الزمن. هذا هو الزمن، مألوف وحميمي. مستولٍ علينا. تسارع الثواني والساعات والسنين يرمي بنا باتجاه الحياة ثم يجرُّنا جرًّا إلى اللاشيء … نسكن الزمن مثلما يسكن السمك الماء. كينونتنا كينونة في الزمن. موسيقاه الجليلة غذاء لنا، تفتح أمامنا العالم، تؤرِّقنا، وتفزعنا، وتهدهدنا. يتكشّف الكون عن المستقبل، مجرورا بفعل الزمن، ويوجد وفقا لنظام الزمن. فأي شيء يمكن أن يكون أكثر إطلاقا ووضوحا من هذا السريان؟
الواقع في كثير من الحالات يكون شديد الاختلاف عما يبدو عليه. فالأرض تبدو مسطحة لكنها في الحقيقة كروية. تبدو الشمس وكأنها تدور في السماء في حين أن من يدورون في الحقيقة هم نحن. ولا الزمن أيضا في حقيقته هو ما يبدو عليه.
لنبدأ بحقيقة بسيطة: الزمن يمر في الجبال أسرع مما يمر في مستوى سطح البحر. صحيح أن الفارق ضئيل لكن من الممكن قياسه بساعات دقيقة يمكن شراؤها اليوم ببضع آلاف من الجنيهات. يمكن التحقق من هذا الإبطاء بين المستويات على بعد مجرد سنتيمترات قليلة: فالساعة الموضوعة على الأرض تتحرك ببطء أقل قليلا من ساعة موضوعة على منضدة.
ولا يقتصر الإبطاء على الساعات: فكلما انخفضنا، تباطأت جميع العمليات. صديقان يفترقان، فيعيش أحدهما في السهل ويذهب الآخر ليعيش في الجبال. يلتقيان من جديد بعد سنين: فمن أقام منهما في السهل عاش أقل، وكبر أقل، وصياح الديك في ساعته كان أقل. كان الوقت المتاح له أقل، نباتاته نمت أقل، أفكاره أتيح لها كي تتكشف وقت أقل … ببساطة، الوقت المتاح في المنخفضات أقل منه في المرتفعات.
فهم أينشتين هذا الإبطاء في الوقت عند المستويات المنخفضة قبل قرن من امتلاكنا الساعات ذات الدقة اللازمة لقياسه. تخيلَ أن الشمس والأرض عدّلتا المكان والزمان المحيطين بكل منهما، تماما كما أن الجسم المغمور في الماء يزيح الماء من حوله. هذا التعديل في بنية الزمن يؤثر بدوره على حركة الأجسام، ويجعلها “تسقط” أحدها نحو الآخر.
ما معنى هذا “التعديل” في بنية الزمن؟ معناه بدقة هو إبطاء الزمن الذي تكلمت عنه فيما قبل: الكتلة تبطئ الزمن حول نفسها. والأرض كتلة ضخمة ومن ثم فهي تبطئ الزمن المجاور لها. وهي تفعل ذلك في السهول أكثر مما تفعله في الجبال، لأن السهول أقرب إليها. ولذلك فإن الصديق المقيم في السهل يشيخ بمزيد من البطء.
وإذا سقطت الأشياء، فالسبب في ذلك هو هذا الإبطاء في الزمن. وعنما يمر الزمن على وتيرة واحدة، في الفضاء القائم ما بين الكواكب، لا تسقط الأشياء. بل هي تطفو. أما هنا على سطح كوكبنا، في المقابل، فتميل حركة الأشياء بصورة طبيعيا إلى حيث يمر الزمن بمزيد من البطء، كما يحدث حينما نجري على الشط باتجاه البحر فتجعلنا مقاومة الماء لسيقاننا نسقط في الموج على رؤوسنا. فالأشياء تسقط إلى أسفل لأن الزمن في الأسفل بطيء بسبب الأرض.
في معمل فيزياء، تجري ساعتان إحداهما على الأرض والأخرى على منضدة بسرعتين مختلفتين. فأيهما تخبر بالوقت؟ هذا سؤال عديم المعنى. فقد نسأل بالمثل أيهما الأكثر حقيقية: قيمة الاسترليني في الدولار أم قيمة الدولار في الاسترليني. ثمة زمنان يتغيران بالنسبة لأحدهما الآخر. ليس بينهما من هو أكثر حقيقية من الآخر. لكنهما ليسا زمنين فقط. فثمة جيش من الأزمنة، ثمة زمن لكل نقطة من المكان. والكمية الواحدة من “الزمن” تذوب في شبكة عنكبوتية من الأزمنة. فنحن لا نصف كيف يتطور العالم في الزمن، إنما نصف كيف تتطور الأشياء في الزمن المحلي، وكيف تتطور الأزمنة المحلية بالنسبة لبعضها بعضا.
والأمر لا يستوجب أكثر من جرامات قليلة من عقار “إل إس دي” لتوسيع تجربتنا بالزمن حتى تبلغ نطاقا ملحميا سحريا. تسأل أليس “كم يبلغ الأبد؟” يرد الأرنب الأبيض “أحيانا ثانية واحدة”. من الأحلام ما يدوم ثانية يبدو فيها كل شيء متجمدا إلى الأبد. الزمن مرن في تجربتنا الشخصية. الساعات تطير كأنها دقائق، والدقائق بطيئة بطئا قاهرا كأنها قرون.
قبل أن يقول لنا أينشتين إن ذلك غير صحيح، كيف بحق الشيطان ترسخ في عقولنا أن الزمن يمر في كل مكان بسرعة ثابتة؟ لم تكن تلك بالقطع هي تجربتنا المباشرة بمرور الزمن بالوتيرة نفسها، دائما، وفي كل مكان.
فمن أين جاءنا ذلك؟ نحن منذ قرون نقسِّم الزمن إلى أيام. وكلمة time [أي الزمن] مشتقة من جذر “دي” أو “داي” الهندوأوروبي القديم، ومعناه يقسّم. منذ قرون نقسم الأيام إلى ساعات. غير أن الساعات على مدار هذه القرون كانت أطول في الصيف وأقصر في الشتاء بسبب الساعات الاثنتي عشرة التي تقسم الوقت بين الشروق والغروب: فكانت الساعة الأولى هي الفجر، والساعة الثانية عشرة هي الغروب، مهما يكن الفصل.
الساعات الشمسية، والساعات الرملية والساعات المائية كانت موجودة بالفعل في العالم القديم، في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي الصين، لكنها لم تكن تلعب الدور القاسي الذي تلعبه الساعات اليوم في تنظيم حياتنا. فلم يحدث إلا في القرن الرابع عشر في أوربا أن بدأت حياة الناس في الانتظام بقوة الساعات الآلية. تقيم المدن والقرى كنائسها، وتضع على أبراجها الساعات لتضبط إيقاع الأنشطة الجماعية. ويبدأ بذلك عصر الزمن المنتظم بقوة الساعة. وتدريجيا ينسرب الزمن من أيدي الملائكة إلى أيدي علماء الرياضيات مثلما يتبين في كاتدرائية ستراسبورج حيث ثمة ساعتان شمسيتان يرفعهما على الترتيب ملاك (في حالة الساعة الشمسية التي ترجع إلى عام 1200) وعالم رياضيات (في حالة الساعة الشمسية التي وضعت سنة 1400).
يفترض أن فائدة الساعات تكمن في حقيقة أنها تخبر بالوقت نفسه. ومع ذلك هذه الفكرة أيضا أحدث كثيرا مما قد نتخيل. فعلى مدار قرون، وطوال الوقت الذي كان السفر فيه يتم على صهوات الخيول، وعلى الأقدام، وفي العربات، لم يكن من سبب لضبط الساعات معا بين مكان وآخر. بل كان السبب وجيها لعدم القيام بذلك. فمنتصف النهار، هو بتعريفه، حينما تبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها. كان لكل مدينة أو قرية ساعتها الشمسية التي تسجل لحظة بلوغ الشمس تلك النقطة الوسطى، بما يتيح للساعة المعلقة على برج الجرس أن تضبط معها بحيث يراها الجميع. ولكن الشمس لا تصل منتصف النهار في اللحظة نفسها في فينسيا أو في فلورنسا أو في تورين لأن الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب. فمنتصف النهار يأتي أولا في فينسيا، ثم يأتي متأخرا بقدر غير قليل في تورين، ولقرون ظلت الساعات في فينسيا متقدمة بنحو نصف ساعة عنها في تورين. فكان لكل قرية صغيرة “ساعة من الزمن” خاصة بها. فكانت سعة محطة قطارات باريس تؤخر ساعتها قليلا عن بقية المدينة في نوع من مراعاة المسافرين المتأخرين.
في القرن التاسع عشر يصل التلغراف، وتنتشر القطارات وتزداد سرعتها، وتظهر مشكلة مزامنة الساعات بين مدينة وأخرى. فمن الخَرَق تنظيم جداول القطارات لو أن لكل محطة توقيتها المختلف.
الولايات المتحدة هي صاحبة أول محاولة في معايرة الزمن. ففي البداية اقترحت تثبيت ساعة معينة من الزمن تكون مطلقة في العالم كله، فتعتبر مثلا الساعة الثانية عشرة هي لحظة منتصف النهار في لندن، فيكون منتصف النهار في الساعة 12:00 في لندن ويكون قرابة الساعة 18:00 في نيويورك. ولم يلق الاقتراح ترحابا كبيرا لارتباط الناس بالوقت المحلي. في عام 1833 تم التوصل إلى تسوية بالتوصل إلى فكرة تقسيم العالم إلى مناطق زمنية، فتتم معايرة الزمن بالتالي في منطقة محددة. وبهذه الطريقة يكون الاختلاف بين الـ 12 على الساعة ومنتصف النهار المحلي مقصورا على ما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة. وتدريجيا لقي الاقتراح القبول من بقية العالم لتبدأ الساعات في التزامن في مختلف المدن.
يصعب القول بأنها مصادفة فقط أن يكون الشاب ألبرت أينشتيتن ـ قبل حصوله على وظيفته الجامعية ـ قد عمل في مكتب براءات الاختراع السويسري، حيث تعامل على وجه التحديد مع براءات الاختراع المتعلقة بمزامنة الساعات بين محطات القطارات. فربما هناك تحديدا خطرت له فكرة أن مشكلة مزامنة الساعات في نهاية المطاف مشكلة لا حل لها.
بعبارة أخرى، لم تمض إلا سنوات قليلة بين اتفاقنا على مزامنة الساعات وبين اللحظة التي اكتشف فيها أينشتين أن من المستحيل مزامنتها بدقة.
مجتزأ من كتاب ” The Order of Time ” نشر في جارديان ونشرت ترجمته في جريدة عمان.
ترجمة: أحمد شافعي.