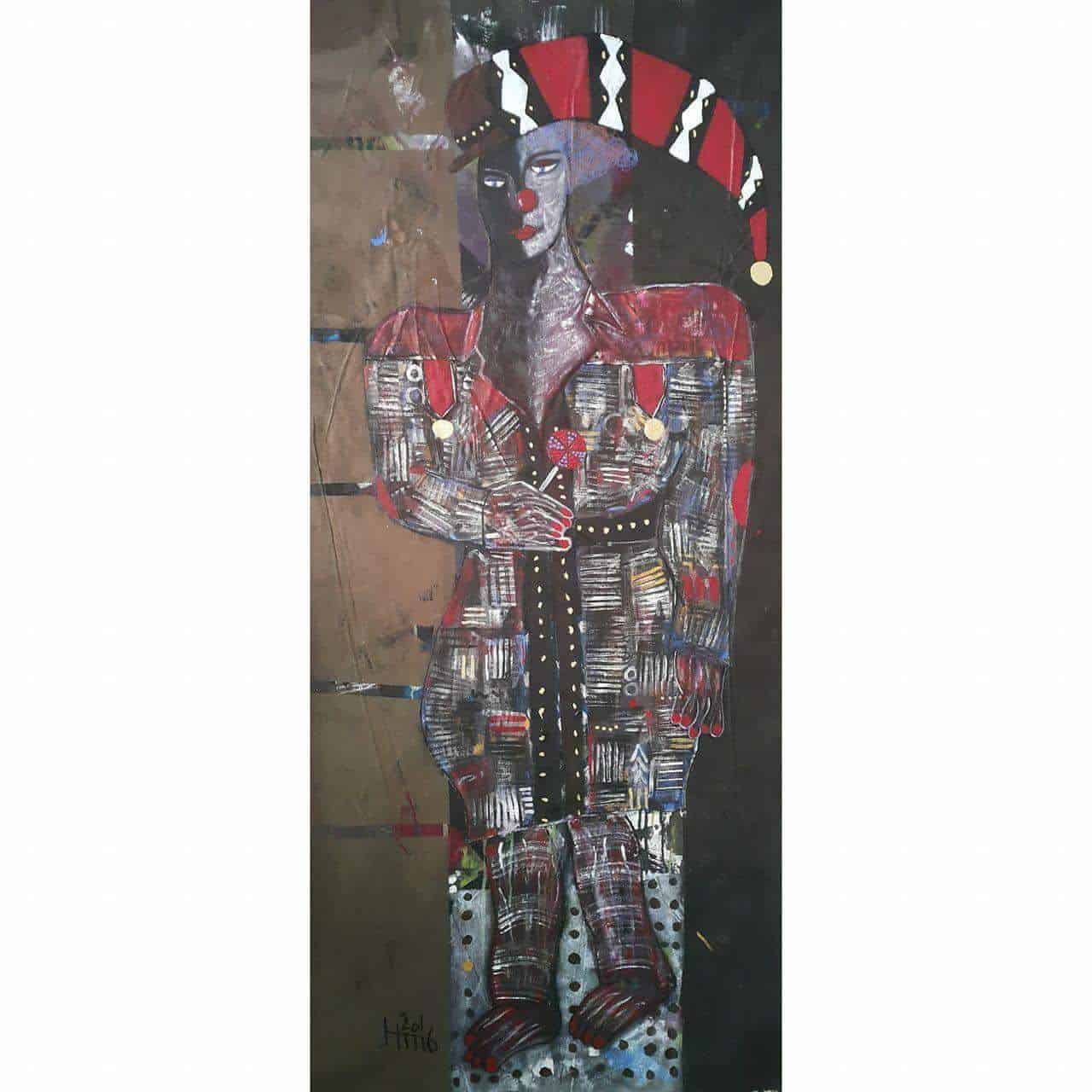1 – في عام 2006 صعد مصطفى محمد سطح مبنى في حارة الفيض بحلب وقفز في منور البناية تاركاً في جيبه ورقة فيها رسالة قصيرة تعفي غيره من أي ندم وأي شك، كان في الثالثة والعشرين، ولديه مخطوطات، كتابان أو ثلاثة. كلما أرى (سيرك)، سهرة كتاب في مطعم بعد قراءة، التقاط الصور التذكارية عند توقيع كتاب، يصعد مصطفى في رأسي ويرمي نفسه، ويظل يسقط ويرتطم هنا وهناك، ولا يصل إلى الأرض، ولا أكاد أصدق ذلك، فالحرب كانت ما تزال بعيدة، والموت كان ما يزال مجازاً، ثم لا أعرفه أصلاً، إنها اللعنة.
2 – السياسة أفسدت الكتابة السورية، نجا الشعر مع محمد الماغوط ورياض الصالح الحسين ومحمد فؤاد، ويظل ينجو حين يمجد الحياة دون اللغة والبلاغة، ولكن لا شفاء في السرد.
3 – في ريبورتاج بجريدة بلدنا ذكرت مرة وبحماسة شديدة أن (بشر وتواريخ وأمكنة) إصدار وزارة الثقافة والإرشاد القومي 1979 أفضل كتاب سوري على الإطلاق، رغم أنني لم أغير رأيي بالتجربة الاستثنائية لمنذر مصري، فأظنه سيضحك، وهو يذكر أسماء كثيرة، وكثيرون منهم من إخوته بالرضاعة، الأكراد، وربما سيراوغ بمكر قبل أن يقول إن الشاي ليس بطيئاً مصدقاً حكمة نادل يوناني كان يشتكي من أننا نحن البشر متعجلون.
4 – أكثر تصنيف للشعراء، يعتمده الشعراء أنفسهم ثم يتحايلون عليه، هو التصنيف وفق العمر، فمن هو أكبر منك سناً لا يقرأ لك، ومن هو أصغر منك سناً لا تقرأ له، أما أبناء الجيل الواحد فهم أعداء، أفكر في المجايلين الأعداء وأتخيل حقل رمي واسع في صباح غائم وأرى إيمان إبراهيم، مقداد خليل، محمد دريوس، فايز حمدان، رائد وحش، جولان حاجي، قيس مصطفى، علي جازو، وأرى كل واحد يتحسس مسدسه وينظر إلى قدمه كميت بعد خمس دقائق.
5 – ليرمنتوف في (بطل من هذا الزمان) أقرب إلي من أي روائي سوري أو عربي، سرفانتس ورابليه العظيم لا نظير لهما، ساراماغو وماركيز وأوستر وكونديرا وكويتزي أعتبرهم أخوالاً وأعماماً من أفراد العائلة، من الرواية الروسية إلى الإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية وصولاً إلى الأمريكية، نظل ننتمي إلى أكثر من أب روحي، والأشد سطوة في ممارسة الأبوة، هو الأكثر ألماً من الأبوة في الحياة. ومن لا أب له في الكتابة: كافكا.
6 – شتاء 2013 وصلت أربيل مع عائلتي الصغيرة واصطحبت معي مع أوراقي الثبوتية، الكتابين الشعريين اللذين طبعتهما بنسخ محدودة، كفعل عبثي ربما، إذ كنت متوقفاً عن الكتابة منذ 2005 سوى ست قصائد، وبدأت أكتب في صفحتي على الفيسبوك ومدونتي على الووردبريس لتتحول الكتابة إلى فعل وجود لأظل أقتنع أنني ما أزال حياً بعد أن نجوت، مصادفة ولحسن الحظ أو لخطأ في التوقيت، ثلاث مرات، ثم بعد الماراتون من أربيل حتى هولندا، براً وبحراً، عبر عشر دول، أصبحت الكتابة بمثابة الخطوات الأخيرة في الشارع الذي يقع بجانب الساحة في مركز مدينة زفولا الهولندية ويحمل اسماً غريباً، (النفس الأخير)، الشارع الذي يصل بين السجن وساحة الكنيسة الكبيرة حيث كان ينفذ حكم الإعدام، وأصبحت أكتب كمحموم، أكتب اليوميات والنصوص المفتوحة والقصائد والقصص القصيرة وأشياء أخرى، أكتب كحي ميت أو كميت حي، دون خوف ودون مهادنة، وكما أعيش بمزاجي السيئ، بغضب وتذمر وقدرة هائلة على التدمير، تدمير كل شيء حتى نفسي.
7 – لم يعد الموت مجازاً بعد الحرب – القذرة لا تكفي، كل منا حدق في الظلام، كل منا قضى شهوراً لا يرى سوى نقطة عمياء، رأى ميتاً على الأقل، كل من فقد شيئاً، خسرنا جميعاً، حتى لم نعد نعرف ماذا يعني ألا تكون خاسراً، لكنها الحرب نفسها التي كانت نزهة الشر نحو هواء آخر خارج (بلاد الأشياء الأخيرة)، حيث لم يعد لدي ما أخسره ودون ضياع في الترجمة، أصبحت حراً أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: المجلة العربية.