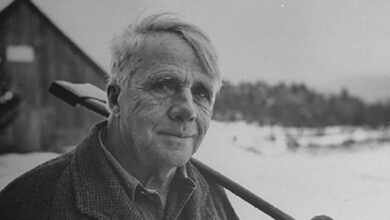أصلَّي
أهدي هذه الكلمات التي تحمل الجمال و المأساة إلى الذي أحببت حباً أخوياً هو في الغالب أقوى من الكل.
هذا الإهداء المشبع بالبحر الذي أحببناه كلانا كما لو كان بيتنا، إليه أهديه.
بيد أن أكسول سبقني، ذلك لأنه و بصرامة أنجز قدره؛ فقد ذراعيه و ساقيه ثماني سنوات مباشرة بعد أن كتبت إليه هذه الأسطر.
إذا ما بتأن قرأ قارئي المحترم ما سيلي، فسيعرف في النهاية ما حدث لرائعي أكسل.
نسخة مصوَّرة
يأتي من البحر
كان أتى من البحر
أتى من البحر
لا يزال
مدثراً بهالة زرقاء، بلآلئ الزبد السرمدية، بكل أصدافه و أخيراً، الطحالب الخضراء أو قناديل البحر المتلألئة المنتشرة في القاع، بالأسماك المتوازنة ذوات المنشار، رسل الحقائق المحرمة على البشر.
بحر النجوم المكتنفة بالأسرار، الصخور المتآكلة من الانتظار، القواقع الصدفية، بحر قوارب الرعب.
كان لابتسامته، حين يجتاز عوماً المضيق الشاسع، ألق لا حدود له كمضيق بويرتو دو لا بالوما الذي لا ينسى، هناك، على الجبهات الشرقية للأوروغواي الشرقية.
و سرعان ما كان أكسول ينطلق في حواره الأرضي، ذلك لأنه هناك، في الوحدة المعدنية للماء، الذي ينساب على جسده، كان يتلو مزامير النبوءة، تلك التي لم تكن سوى الواقع المشتهى للمحيطات.
قلنا إنه كان يأتي من البحر، مستعداً لكل شيء، مسروراً، موزعاً حركات حفاوة، حنوناً يمد ذراعيه الطويلتين إلى إيميليا و هو يردد:
ـ لا تستطيعين تصور ما أشعر به هناك، لا، أنتِ لا تستطيعين.
تذكرتْ أن الوقت كان زوالاً، و بحنان قدمت له فخذ حمل مشوي، يقطر دماً. جائعاً، تناول أكسول الغنيمة بين يديه، تشممها، لكن اندفاعه أخذ شيئاً فشيئاً يتلاشى، تردد، أهمل قطعاً ريانة في صحنه.
ترك المائدة و قد فقد الشهية، ذلك لأن تلك الخفة، و تلك اللقاءات مع ذاته، و تلك الرغبة الرائعة في الحياة ( في العوم) هجرته، تاركة إياه تائها وسط أشياء يومية، على مقربة من الأرض و الأحجار.
و تأتي ساعات الشمس و القيلولة. يتأمل اميليا غافيةً إلى جانبه، شديدة الاستدارة، كثيرة الحيوية، مدثرة بأكثر من حجاب، مذهبة بهذه الشمس و هذه الأرض، حالمة و بكل تأكيد، بفواكه و أشجار، أو بأفخاذ حملان.
و متسللاً، فر أكسول، تاركاً ذاته تنزلق في حرص على الأرض المعشوشبة، و حينها كان يرشف اليود و الملح.
كان النسيم البحري يوقظ فيه ضميره الفاتر النشاط. كان يشعر بأطرافه واحداً واحداً و بكثافة،
و يودعها في النهاية إلى تلك الفسقية الهائلة و الشاسعة، ما وراء بحار الأحلام في جنان الطفولة.
كان أكسول قد أخذ يسترجع نشاطه. التجديف بالذراعين بداية، ثم مصب المضيق، الفضاء العريض و ها عرض البحر كله في ملكه، غياب تلك اللحوم المدماة، نسيان الأجساد الممتلئة،
و الحجب، و أيضا المتع اليومية العذبة، توديع تلك الألوان الآسرة، للزهور، لفروع الشجر، للعصافير، للثياب، مزينات البيوت، الأدوات غير المستعملة التي تفرض علينا تواصلا يوميا، و التي تولد فينا الاحتياجات.
أكسول، الآن، يمرح، يغطس، يشق برأسه خارجاً سطح الماء، يبتعد، يسبح في اتجاه عرض البحر، يلتحق بالأحواض المتتابعة، يترك ذاته، دون حركة، تطفو على الماء، يتأمل المضيفات الشفافات، الكائنات الذهبية و الفضية، قناديل البحر العمياء ذوات الرؤوس الرائعة و الشعور من الخيوط
الحصوية، و التي لا تزال دلالتها منيعة عليه.
كان أكسول لا يعود إلا مع نزول الليل، مردداً، مسمياً، مناديا وجوها غير معروفة. كان محميا بالسماء، بقلنسوة قطنية شديدة الزرقة بحيث أن أكسول يتعذر عليه رؤية الظل.
كانت اميليا جزعة، شيء ما غريب كان يحدث، شيء لم تتمكن بعد من معرفة كنهه.
كان أكسول يردد تلك الأسماء، لكن لم تكن ترى سوى ظله مشكلا بقعة على الحائط الحجري، و أما حديثه المنفرد فكان غير مفهوم.
اعتقدت أنها تبينت وسط تلك الأسماء كلمة نيبتون. لكن ربما لم يكن ذلك سوى مجرد وهم.
أما أكسول فلم يكن يزعجه إلا أنفه، ذقنه و عيناه الجاحظتان. كان لا يسمع سوى أصوات آتية من إيميليا التي لا مثيل لها، و لا يرى إلا حركات منعزلة.
حينئذ تقبل عليه. و يثور ضد يد النار تلك التي تلمس كتفه، ضد رؤية تلك الحفيرات، الأعين المتلهفة و أكيدا الممتلئة بفكرة عقد مقارنات، بأطعمة، بأطاييب متنوعة، بحيطان أو بـبـيوت من طين و حجر.
كم هو صعب اكتشاف إلى أي حد يمكن لليل أن يجعل الروح ملولبة، و إلى أي مدى هي السماء
معتمة و النجوم في الأعالي تفتح ممرات، و تقدم إلينا، في سخاء، ليلها الخالص، ساكبة إياه خلسة على الشرم إلى أن تصير المشاهد مشهدا واحدا.
أكسول جامدا و أكثر فأكثر غير ذي بال، متمددا على ملاءات غريبة، يتحسس جلده الخشن. كان قد نام، و حلم بأن حراشف صلبة نبتت له تقيه من البرد، تعزله عن العالم.
عندما استفاق، مرعوبا، لم يستطع أن يحيد ببصره عن النافذة المشرفة على الشاطئ.
و قرر الهروب مثل سارق ليجد نفسه على مبعدة أمتار من الضفة الصامتة.
و بصيحة فرح كبيرة، احتفى بارتماءة في الماء أثارت شرارات فسفورية مضيئة.
سبح إلى أن وصل صخور الرأس. هناك، كان المحيط يطقطق بوداعات الزبد، بأعمدة إشارات السفن وصواري مقدمتها المائلة الساطعة، بالسفن التي لم تصل في الواقع أبدا، برفات الطيور التي تحضن البحر و ترقص في ألعاب ضوئية، في شكل نجوم دقيقة زاعقة.
و هذه المرة، عاد أكسول إلى الشاطئ منهكا، العينان شبيهتان بالزجاج، غريبتان عن طبيعتهما. أسرعت أميليا إلى أحضانه باكية، كما يفعل الناس.
يـبصر أكسول البيت جوار الماء. يريد الوقوف. كان أصلا يجد صعوبة في المشي. و بجهد جهيد يصل إلى العتبة الحجرية. كان يكشف و باستمرار عن ساقه اليمنى، محاولا رسم ابتسامة لم تكن سوى عبوسا أو في كل الأحوال ابتسامة زرقاء.
كانت ساقه تنحف، من البطة و إلى القدم، و البشرة تخضر، تفقد نسيجها.
والعروق، مثل شعرات، تتزاحم في كتلة خضراء شفافة ترسل رائحة الملح، اليود، و الرخويات.
لم تنطق أميليا ببنت شفة و هي تراه. و سرعان ما جمعت متاعها، الأشياء المحببة لديها.
تنورات داخلية، أعشاب، زهور و قدور تحت ذراعها،و انطلقت تركض متفوهة بأشياء لم يتمكن أكسول من فهمها.
و تجنبا للكثير من التعاليق، تم المناداة على أطباء و أخصائيين. فحصوه، جعلوه يعتمد أشكالا من الوضعيات، صوروه، استشاروا مختلف الأصدقاء في المهنة. هيأوا وصفات طبية ألغيت بعد ذلك، سألوه في مسائل عمومية، خصوصيات، أشياء حميمة.
منذ زمن طويل، و أكسول يبحث عن عبرات لا تأتي. ينساب عبر النافذة عطر النجوم و المد و الجزر. عبر النافذة شفرات لا حصر لها كانت قد استعملت.
أراد أكسول أن يتركوه لحاله، العينان اللتان يحمل الآن تستعطفان. كان يعرف جيدا أن في الخارج رداء الغروب الأقرب للنهار ينتظر هابطا على الشرم.
وأن الأمواج الصغيرة سيكون لها ألق يتراوح ما بين الوردي و الأزرق الغامق.
وصل أكسول الضفة بصعوبة، و قد أصيب بجروح في أكثر من موضع إلى أن غطاه الماء.
عاد الغسق إلى حالاته الأولى، شعر بها أكسول في وضوح. هو الآن، يسبح من الحسن إلى الأحسن. يذهب و يعود، و يقضي وقتا طويلا في الماء و يستطيع تأمل المدى الشاسع، اللعب مثل سمكة حقيقية، التخلص من كل السنوات المنصرمة. عندئذ، انسابت خلسة ذكرى نشأت خارج ذاته. و قرر أن يبحث عنها جدفا بالذراعين قليلا، لكنه لم يجد الذراعين. و سابحا في تموج، اقترب من الساحل. أبصر المنشآت البشرية، النساء و الأطفال في أعمالهم اليومية.
كان أكسول سيد حركاته. هذا العالم لم يعد ينتمي إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ماتيلدي بيانكي 1932ـ….
شاعرة و روائية و كاتبة قصة قصيرة من مواليد مونتيفيديو بالأوروغواي.