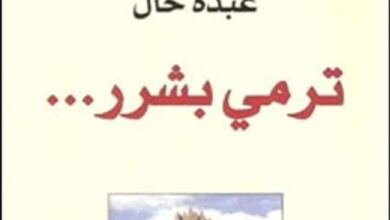أحيانًا أفكّر، بمتعةٍ حزينة، فيما لو كتب ذات يوم لهذه العبارات التي أكتبها، في مستقبلٍ منذ الآن لا أنتمي إليه، أن تحيا مقرونةً بالثناء، فَسَأكْتَسِبُ في النهاية الناس الذين “يفهمونني”، العائلة الحقيقية التي سأولد فيها وفيها سأغدو محبوبًا، لكن بعيدًا عن الوصول إلى الولادة فيها، سأكون قد متّ من زمنٍ طويل. سأغدو مفهومًا في الصورة المطبوعة فقط، حين لا يكون بإمكان الحبّ أن يعوّض مَن مات تلك المجافاة التي وحدها كانت من نصيبه عندما كان على قيد الحياة.
ذات يوم ربما يدركون أنني، أكملت، كما لم يفعل أيّ شخصٍ آخر، واجبي منذ الولادة كترجمانٍ لجانب من قرننا هذا؛ وعندما يفهمون ذلك عليهم أن يسجِّلوا أنني لم أكن مفهومًا في الحقبة التي عشتها، وأنني عشت، مع الأسف، بين أشكالٍ من الجفاء واللامبالاة، وأنه من المؤسف أن يكون هذا ما حدث لي. والذي يكتب هذا سيكون، في الحقبة التي يكتبه فيها، غير فاهمٍ ولا مدرك، مثل مَن يحيطون به، لشبيهي في هذا الزمن المُستقبلي، ذلك لأنَّ الناس فقط يتعلمون من أجدادهم الذين ماتوا. ووحدهم الموتى من نعرف تعليمهم القواعد الحقيقية للحياة.
في العشية التي أكتب فيها، توقّف المطر، مسرّة الهواء منعشةٌ للجلد. النهار آيلٌ للانتهاء، لا في الرماديّ، وإنما في زرقةٍ شاحبة. زرقةٌ غامضة تنعكس، حتى، في أحجار الشارع. يؤلم العيش، لكن من بعيد. لا يهمّ أن نحسّ، واجهةٌ أخرى تُضاء.
في نافذةٍ أخرى عالية هناك أناسٌ يشاهدون انقضاء الأعمال. المتسوّل الذي يلامسني لا بدّ أن يُصاب بالذهول لو عرفني.
في الأزرق الأقلّ شحوبًا والأقل زرقةً الذي يلتمع في المباني، تميل ساعة النهار اللامحدَّدة أكثر قليلاً نحو المساء.
رويدًا رويدًا، تهبط خفيفة، نهاية النهار الأكيدة… خفيفة، تنزل موجة الضوء الذي انقطع، كآبة المساء اللامجدي، ضبابٌ بلا غيمة ينفذُ إلى قلبي. خفيفًا، ناعمًا يسقط الشحوب اللامحدَّد اللامع للمساء /المائي/ – خفيفًا، ناعمًا فوق الأرض البسيطة والباردة. خفيفًا يسقط، رمادٌ لا مرئي، رتابةٌ ممضة، ضجرٌ بلا راحة.
658 دقيقة واحدة