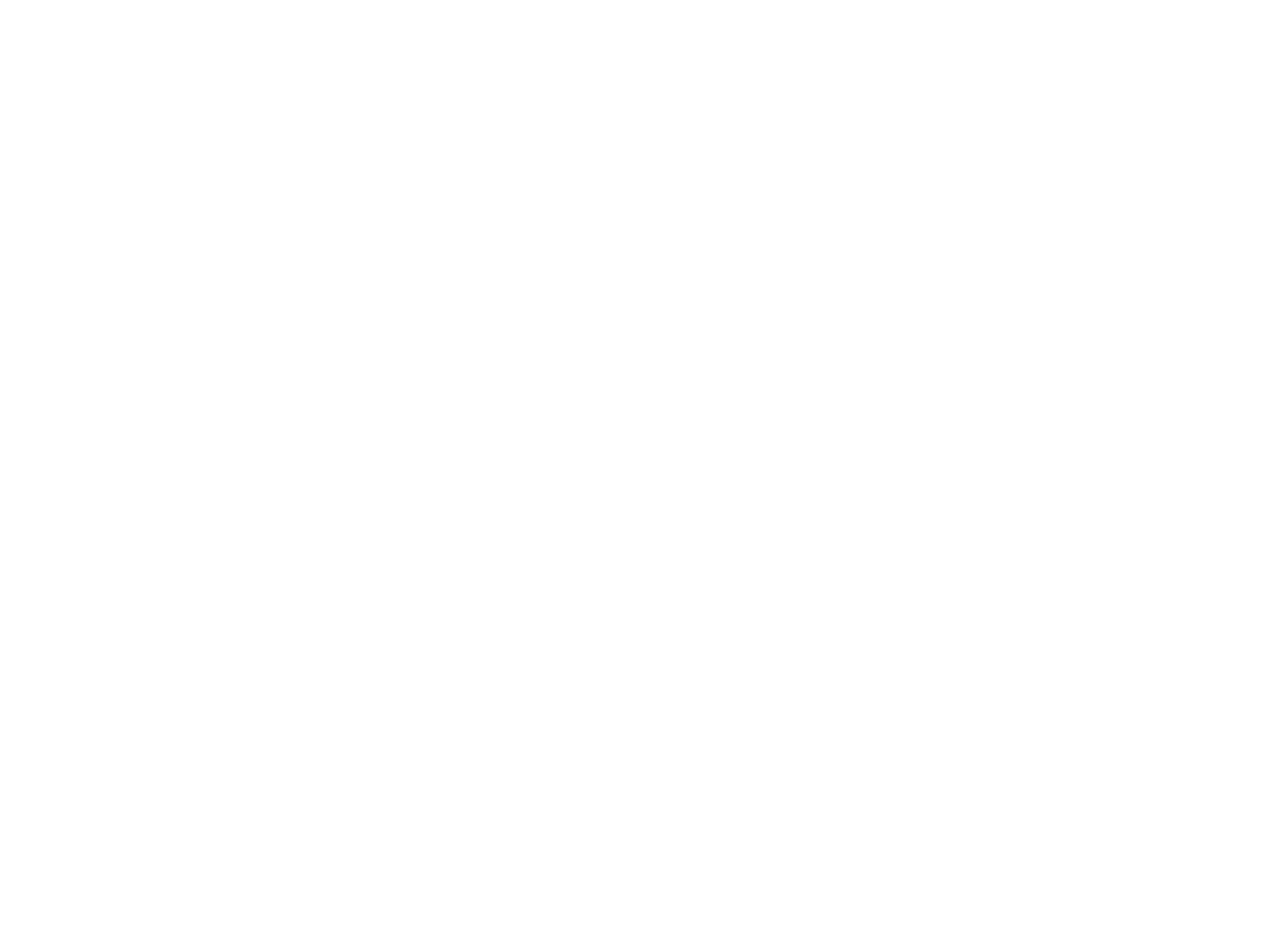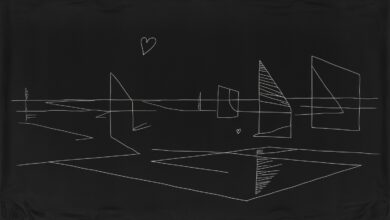طمأنة
غططتُ في النوم الليلةَ الماضية، وعندما نهضت،
ما زالت قبلتُها طافيةً على شَفَتيّ؛
وضللنا طريقنا معًا في المنام،
وكان يغطي نعيمَنا نورٌ هادئ،
نورُ القمر الخجول النادرةِ تحاياه.
موسراً كان الهواء بالندى، وبين الأشجار
فراشات مضيئة تلتهتب، فتختفي.
تتلامس وجنتانا، ويتغلغل نسيم الليل في شعرَينا،
ونَفَسَينا، غاديًا رائحًا، كلهيب شهوتنا.
نفذ صوتكِ الهادئ الهامس في أذني:
«أحلمٌ هذا؟ هل ندفنه؟ أم غشاوة نوم؟
إن الحبّ لَيَستعبد حتى الموت!
كلا، بل يبدو هكذا،
فلتتحلّ بالإيمان يا فؤادي الغالي؛
فهذا هو الأمر ولا أمر سواه!»
ثم نهضتُ وعلى شفتَيّ؛ قُبلة.
موت وشيخوخة
ادنُ منّي أيها الصديق القديم،
عطوفًا، مشتعلَ الرأسِ أبيضَه،
ولتَضُمّني إلى صدرك الحاني الرحيب؛
إذ باتت الحياة جافة باردة، ولكنّك
تبسط يدَيك بالبركة، فأغرق في بحر نعمائك.
كثيرًا ما حضرت، وكثيرًا من أغويت؛
لكنني أنحني لك احترامًا،
مبتهجًا، لاتّباع خطوِك المبارك.
آهِلٌ عالمُك بالبشر الواهنين؛
أما عالمي موات.
لقد حضّرت، طوال السنين، كفني.
إنك أنتَ الحبّ السامي —قبّلني، فإني لك.
شاعر وناقد
“ينبغي للشعر أن يكون بسيطًا، ومحسوسًا، وذا عاطفة؛ أما هذا الرجل فلا بساطة ولا إحساس ولا عاطفة؛ ولذلك هو ليس بشاعرٍ.”
لم يسمع أحد شدو العندليب قط،
إلا عندما هَمّ عالم طبيعة الدراسة والتفكّر في ماهيّة الطير،
وتصنيفه بالكتب والذاكرة،
كلا، فلم يفشل في رسم معالمه،
ولا رصد دقّة صوته، أنّى الأماكن يُسمع.
لم يلبث طويلًا حتى لَفَظَ تلك الكلمة —وفَجأةً—
أنصِت. إنه عندليب!
ما لشدوك من عذوبة،
حيث يسمو فوق المشقّة والكَبَد!
وإذ به يلمحُ دُخّلةً بُنيّةً، عاديةَ الملامح، غير خجلى.
فصرخ: «ليست لي هذه الخطيئة المميتة،
فلا طائرٌ هذا؛ لعدوله عن النشيد،
وإن كان كذاك، لأتاني بسلطانٍ مبين.»
ترجمة: محمد السعيد