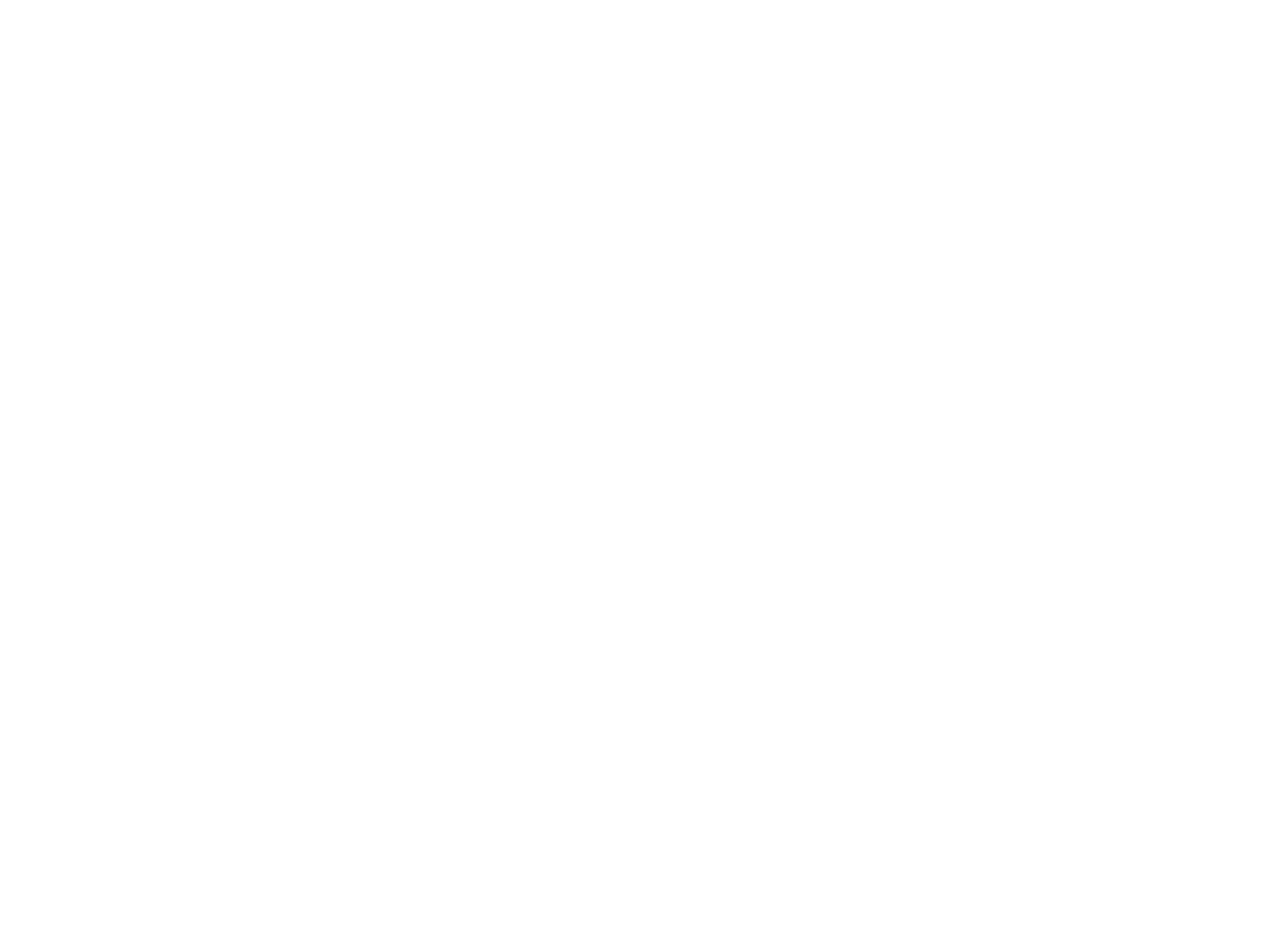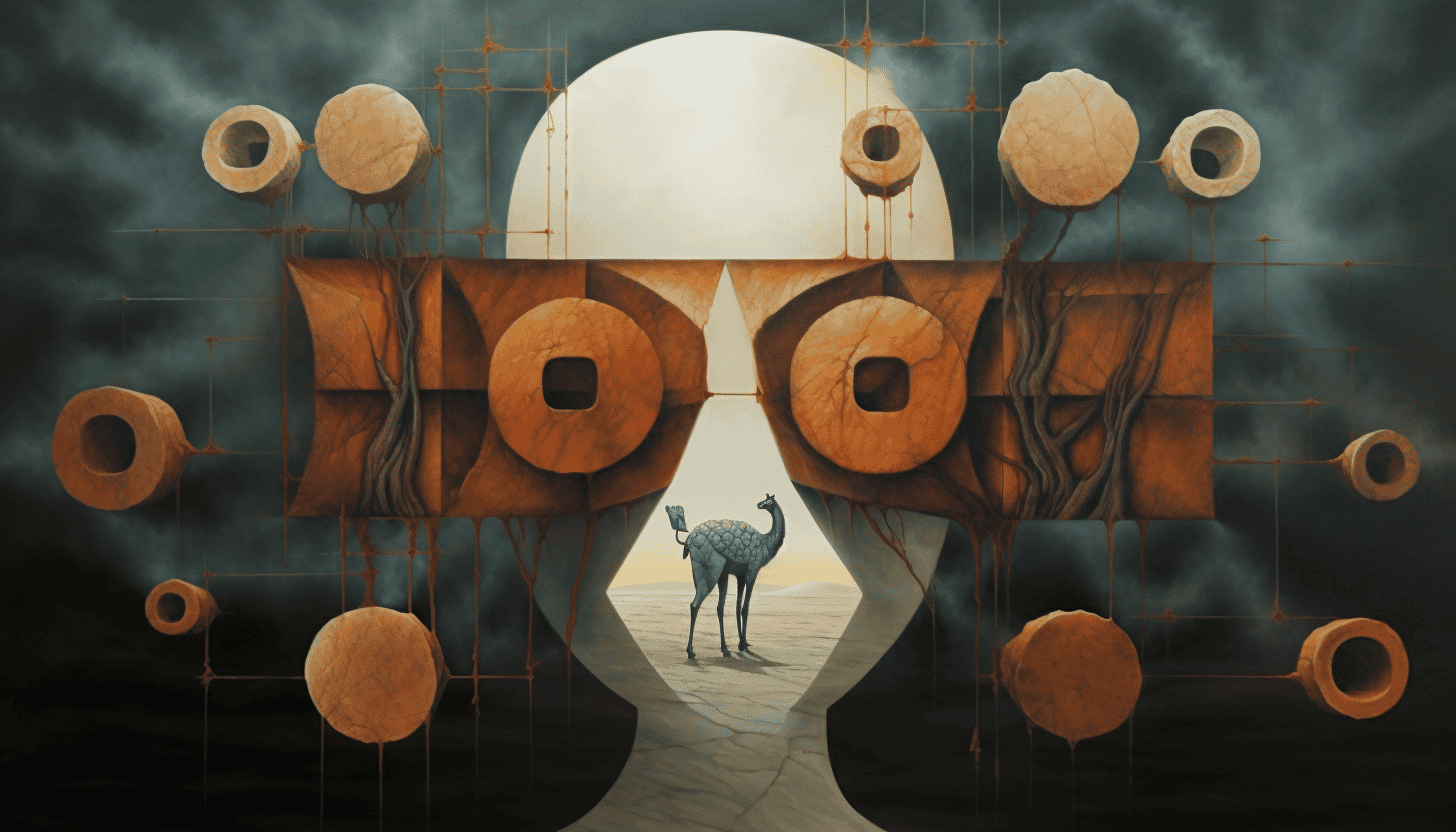

حين أتت السيدة المحسنة التي تنتمي لجمعية رعاية الأطفال لزيارتنا سألتنا، كما يفعل الجميع، لماذا ننجب كل هذا العدد من الأطفال، فانبرت زوجتي التي كانت تشعر بانقباض في ذلك اليوم لتعلن صراحة ودونما مواربة: “لو كانت لدينا الإمكانيات لذهبنا إلى السينما في المساء. وبما أننا لا نملك النقود فإننا نأوي إلى الفراش، وهكذا يولد الأطفال”. بدا الانزعاج على السيدة عندما سمعت هذه الملاحظة ومضت دون أن تضيف كلمة واحدة. أما أنا فقد عنّفت زوجتي قائلاً بأنه لا يصح الإعلان عن الحقيقة دائماً، وعلى المرء كذلك أن يعرف مع من يتعامل قبل أن يعلن الحقيقة. في سن الشباب قبل أن أتزوج كنت أتسلى في كثير من الأحيان بقراءة الأخبار المحلية في الجريدة حيث يصفون كل المصائب التي يمكن أن تحدث للناس مثل حوادث السرقة، والقتل، والانتحار، وحوادث الطرق. من بين كل تلك المصائب واحدة لم أكن أتصور على الإطلاق أن أواجهها وهي أن أصبح “حالة تثير الشفقة”، أي حين يثير شخص ما مشاعر العطف بسبب حظه العاثر دون أن يعزى ذلك لمصيبة محددة أصابته، أي أن حالته تعود لمجرد كونه على قيد الحياة، ليس إلا.
كنت شاباً حينذاك كما ذكرت، ولم أكن أعرف معنى إعالة أسرة كبيرة. غير أنني أرى الآن أنني تحولت تدريجياً إلى ما يعني بالضبط تعبير “حالة تثير الشفقة” وهذا ما يثير دهشتي. كنت أقرأ مثلاً: “إنهم يعيشون في حالة فقر مدقع”. حسناً، ها نحن نعيش في حالة فقر مدقع. أو يقولون: “وهم يعيشون في بيت ليس له من مقومات البيت غير الاسم”. وها أنا الآن أعيش في “تورمارانشيو”، مع زوجتي وأطفالي الستة في غرفة خالية إلا من مراتب كثيرة مفروشة على الأرض. وحين تمطر السماء يتدفق الماء فوق رؤوسنا كما يتدفق على المقاعد الموجودة في شارع “ربيتا”. أو قد أقرأ: “وما أن اكتشفت المرأة المسكينة أنها حامل حتى قررت أن تتخلص من ثمرة عاطفتها تلك”. حسناً، لقد اتخذت وزوجتي هذا القرار بناءً على اتفاق مشترك حين اكتشفنا أنها حامل للمرة السابعة. قررنا في الواقع أن نترك الطفل في إحدى الكنائس بعد أن يعتدل الطقس ويصبح أكثر دفئاً، أي أن نتركه لرعاية وإحسان أول من يصادفه العثور عليه.
بالمساعي الحميدة لمثل أولئك السيدات المحسنات دخلت زوجتي المستشفى لتضع مولودها. وما أن تحسنت حالتها حتى عادت مع المولود إلى “تورمارانشيو”. قالت حين دخلت الغرفة: “أتدري؟ على الرغم من أن المستشفى يظل مستشفى إلا أنني كنت أود أن أبقى هناك بمحض إرادتي بدلاً من العودة إلى هنا”. وما أن تفوهت بهذه الكلمات حتى أطلق الوليد صرخة لا تصدق، وكأنما فهم معنى كلماتها. كان طفلاً لذيذاً يانعاً له صوت قوي بحيث أخذ يمنع النوم عنّا جميعاً حين يستيقظ ليلاً ويبدأ في البكاء.
عندما حلّ شهر أيار وغدا الهواء دافئاً بحيث يسمح بالخروج دون ارتداء معطف انطلقنا أنا وزوجتي من “تورمارانشيو” إلى روما. كانت زوجتي تحتضن الطفل وتضمه إلى صدرها وقد لفته بكمية كبيرة من الخرق وكأنما ستتركه في حقل من الجليد دون أن يصيبه أذى. ما أن بلغنا المدينة، وكأنها تريد أن تخفي حقيقة أنها تمقت ما هي مقدمة عليه، فقد أخذت تتحدث دونما انقطاع وهي مبهورة الأنفاس وعلائم الإجهاد تبدو عليها وقد تناثر شعرها في كل اتجاه وبرزت عيناها من مآقيهما. تتحدث حيناً عن الكنائس المختلفة التي يمكن لنا أن نترك الطفل فيها، مؤكدة بأن من الواجب أن تكون كنيسة يرتادها الأغنياء. فمن الأفضل أن يتربى الطفل بيننا إن كان من سيلتقطونه فقراء مثلنا. وما تلبث بعد قليل أن تتحول لتقول بأنها تصرّ على أن تكون الكنيسة منذورة للسيدة العذراء لأنه كان لها ابن أيضاً وبذا يمكنها أن تتفهم أموراً معينة، وبذا ستمنحه ما يستحق من عطف. هذه الطريقة في الكلام أرهقتني وهيجت أعصابي- خصوصاً وأنني كنت أشعر بالإذلال أيضاً وأمقت ما أنا مقدم عليه. غير أنني كنت أحاول إقناع نفسي بأن علي أن أتمالك مشاعري وأبدو هادئاً لكي أساعدها على التماسك. تفوهت ببعض الاعتراضات مستهدفاً قطع هدير كلامها ثم قلت لها: “عندي فكرة… لم لا نتركه في كنيسة القديس بطرس؟” ترددت للحظة ثم أجابت: “لا، فهي كبيرة جداً وقد لا يرونه هناك… أفضّل تلك الكنيسة الصغيرة في شارع “كوندوقي” حيث توجد كل تلك المحلات الجميلة التي يرتادها الكثيرون من الأغنياء- إنها المكان المناسب!”
ركبنا الحافلة حيث جلست صامتة بين الآخرين، وكانت تعيد ترتيب الحرام الصوفي وتحكمه حول الطفل بين حين وآخر، أو تكشف عن وجهه بحرص وتتأمل وجهه. كان الطفل نائماً ووجهه محمرّ ومتورد في وسط كل تلك اللفائف. ثيابه رثة شأن ثيابنا، والشيء الجميل الوحيد الذي يرتديه هما القفازان المصنوعان من الصوف الأزرق، وكان في الحقيقة يفرد يديه على اتساعهما وكأنما يتباهى بقفازيه. نزلنا في “لارجو جولدوني” وعادت زوجتي تثرثر من جديد، ثم توقفت أمام واجهة أحد بائعي المجوهرات وقالت لي وهي تشير إلى المجوهرات المعروضة على رفوف مغطاة بالمخمل الأحمر: “هل ترى ما أجملها! الناس يأتون إلى هذا الشارع ليشتروا المجوهرات والأشياء الجميلة الأخرى. أما الفقراء فليس لهم شأن بهذا المكان. وفيما هم ينتقلون من محل إلى آخر يدخلون الكنيسة ليصلّوا للحظة من الزمن، وبعد ذلك، وبينما هم في مزاج رائق يجدون الطفل ويأخذونه…” قالت كل ذلك وهي تقف وتحدق بالمجوهرات وتشد الطفل إلى صدرها وعيناها مفتوحتان على اتساعهما، وهي تتكلم وكأنما تحادث نفسها. أما أنا فلم أكن أجرؤ على مجادلتها. توجهنا إلى الكنيسة، كانت صغيرة وقد دهنت بكاملها بحيث بدت وكأنها من المرمر الأصفر؟ وبها عدد من المحاريب ومنبر كبير. قالت زوجتي بأنها تتذكرها على نحو آخر، وأما وهي كما تراها الآن فإنها لا تحبها على الإطلاق. ومع ذلك فقد غمرت أصابعها في الماء المقدس، وصلّت ثم تابعت سيرها بخطى بطيئة حول المكان وهي تتفحصه بعينين مرتابتين وبعدم ارتياع وتضم الطفل إلى صدرها.
كان هنالك نور بارد ساطع ينبعث من قنديل يتدلى من قبة الكنيسة، وأخذت زوجتي تطوف من محراب إلى آخر وهي تتفحص كل شيء: المقاعد، والمحاريب والصور لتحكم فيما إن كانت مكاناً مناسباً تودع فيه الطفل.. أما أنا فقد كنت أتبعها وأسير على مسافة منها وأراقب الباب بحذر طوال الوقت.
دخلت فجأة فتاة شابة ممشوقة القوام ترتدي ثوباً أحمر، يزين رأسها شعر أشقر ينسدل كالذهب، ركعت الفتاة والتصقت حينذاك تنورتها بجسمها، وصلّت لفترة دقيقة واحدة فحسب ثم خرجت ثانية دون أن تنظر إلينا. أما زوجتي التي كانت تراقبها فقد قالت فجأة: “ليس هذا بالمكان المناسب، فالناس الذين يرتادونه هم، شأن هذه الفتاة، على عجلة من أمرهم كي يمضوا ليتسلوا ويتفرجوا على المحلات.. لنذهب! ثم خرجت على الفور.
عدنا أدراجنا إلى الشارع وسرنا مسافة ما عائدين بخطى مسرعة على طول شارع “كورسو”، زوجتي تتقدمني وأنا أسير وراءها. ما لبثنا أن دخلنا كنيسة أخرى قرب “بيازيا فينيسيا”. كانت هذه أكثر اتساعاً وبدت شبه مظلمة، تمتلئ بالصور واللوحات المذهبة والخزائن الزجاجية المزدحمة بقلوب فضية تتلامع في وسط النور المائل للعتمة. كان هنالك عدد كبير نسبياً من الناس داخل الكنيسة، وبنظرة عابرة تبين لي أنهم ممن يعيشون عيشة رخية، فالنساء جميعاً يرتدين القبعات في حين يرتدي الرجال ملابس مرتبة. كان هنالك واعظ يلوح بذراعيه يمنة ويسرة وهو يلقي موعظة من فوق المنبر والجميع يوجهون أنظارهم إليه. بدا لي الوضع حسناً إذ أن أحداً لن يلحظنا ضمن ذلك الجو. همست لزوجتي: “هل نحاول أن نتركه هنا؟” طأطأت رأسها موافقة فاتجهنا إلى إحدى الزوايا الجانبية التي يعمّها الظلام بحيث يصعب عليك أن ترى ما حولك. لم يكن هناك أحد، ولذا غطّت زوجتي وجه الطفل بزاوية الحرام الذي تلفه به ثم وضعته على أحد المقاعد، كما لو كانت تتخلص من لفة تعوق حرية حركة يديها، ثم ركعت وصلت لفترة طويلة وهي تضع كفيها على وجهها. أما أنا، ولأنني لم أجد ما أفعله فقد أخذت أتفحص مئات القلوب الفضية مختلفة الأحجام والتي تغطي جدران المصلى. وقفت في النهاية وقد علت وجهها إمارات الإصرار وسارت مبتعدة ببطء، وسرت وراءها على مسافة قليلة منها. وفي تلك اللحظة صرخ الواعظ قائلاً: “وقال المسيح: إلى أين تمضي يا بطرس؟” أجفلت عند ذلك وكأنما كان يوجه السؤال إليّ، وبينما كانت زوجتي تهم برفع ستارة الباب كي تخرج أفزعنا صوت انطلق من ورائنا يقول: “سيدتي! لقد تركت لفة على المقعد هناك.”
كانت تلك امرأة ترتدي السواد، من ذلك النمط من النساء المتدينات اللاتي يقضين نهارهن متنقلات بين الكنيسة وغرفة المقدسات. أجابتها زوجتي: “أجل، يا إلهي، شكراً لك فقد نسيتها”. ولذا حملت اللفة ثانية وخرجنا ونحن نشعر بأننا أقرب إلى الموت منا إلى الحياة.
قالت زوجتي بعد أن خرجنا: “يبدو أن أحداً لا يريد صغيري هذا.” قالت تلك الجملة وكأنها شخص حمل بضاعة إلى السوق متوقعاً أن يبيعها بسرعة ولكنه يفاجأ عندما لا يجد من يرغب بها، أخذت تسرع الخطى من جديد وتنهب الأرض بقدميها وهي تلهث بحيث بدت أقدامها وكأنها لا تكاد تمس الأرض. وصلنا إلى كنيسة “بيازا سانتي أبوستولي”، وكانت هذه مفتوحة. وما أن دخلت زوجتي ورأتها واسعة فسيحة ظليلة حتى همسة قائلة: “هذا ما نريده”. مشت تغمرها علائم التصميم واتجهت إلى إحدى الزوايا الجانبية، ووضعت الطفل على مقعد وأسرعت عائدة باتجاه المدخل دون أن تتمتم حتى بصلاة قصيرة أو تقبل جبين الطفل، وكأنما الأرض تلتهب تحت أقدامها. ولكنها، وما أن قطعت عدة خطوات حتى اهتزت الكنيسة بصوت بكاء يائس، فقد حان وقت رضاعة الطفل فيما يبدو، وحيث أنه دقيق غاية الدقة في مواعيده فقد أخذ يبكي من شدة الجوع. بدا على زوجتي وكأنها فقدت رشدها حينذاك إذ هرولت أولاً باتجاه الباب، ثم التفتت وهي ما تزال تهرول وجلست على أحد المقاعد دون تفكير وفتحت أزرار قميصها لتعطيه ثديها، وما أن أخرجته حتى التهمه الطفل وكأنه ذئب مفترس وأخذ يرضع بشراهة ويقبض على الثدي بكلتي يديه وقد توقف عن البكاء. ولكننا ما لبثنا أن سمعنا صوتاً يصيح بها: “لا يمكنك أن تفعلي ذلك في هذا المكان. اذهبي من هنا، اخرجي إلى الشارع!” كان هذا صوت قيّم غرفة المقدسات، وهو رجل عجوز ضئيل الجسم ذو لحية بيضاء، ضئيلة تمتد تحت ذقنه وصوت أكبر من جسمه. نهضت زوجتي وهي تغطي صدرها ورأس الطفل ما استطاعت ثم قالت: “ولكن العذراء تحمل طفلها بين يديها كما نراها في الصور كما تعلم.” أجاب بحدة: “هل تشبّهين نفسك بالعذراء أيتها المرأة الدعية؟”
حسناً، غادرنا تلك الكنيسة أيضاً ومضينا لنجلس في حديقة “بيازيا فينيسيا” حيث أعطت زوجتي ثديها للطفل ثانية إلى أن ارتوى وعاد إلى النوم من جديد.
كان المساء قد حل والكنائس تغلق أبوابها وقد حل بنا التعب والارتباك، ولم تعد في جعبتنا أية أفكار قابلة للتنفيذ. شعرت باليأس وأنا أفكر بكل ما حل بنا ونحن نقدم على أمر لا يجدر بنا أن نفعله، ولذا قلت لزوجتي: “اسمعي، لقد تأخرنا ولست أستطيع الاستمرار على هذا الحال.. علينا أن نقرر.” أجابت ببعض المرارة: “ولكنه لحمك ودمك! هل تريد أن تتركه كيفما اتفق، في أي زاوية كما قد يترك الناس لفة من الأحشاء لكي تأكلها القطط؟” قلت: “لا، لم أقل ذلك، غير أن هنالك أموراً على المرء أن يفعلها على الفور ودون تفكير، وإلا فإنه لن يقدم عليها على الإطلاق.” أجابت: “حقيقة الأمر هي أنك تخشى أن أغير رأيي وأعيده إلى البيت ثانية. أجل، أنتم الرجال جميعكم جبناء! أدركت بأن علي ألا أجادلها في تلك اللحظة، ولذا قلت لها بلهجة تتسم بالاعتدال: “لا تغضبي! إنني أدرك مشاعرك، ولكن تذكري بأنه مهما حل به فسيكون أفضل له من أن يشب في “تورمارانشيو” في غرفة دون مرحاض أو مطبخ، غرفة تمتلئ بالحشرات شتاء وبالذباب صيفاً. صمتت ولم تجب.
بدأنا نسير ثانية دون أن ندري إلى أي اتجاه نحن ماضيان. شاهدت شارعاً ضيقاً صغيراً دوننا، كان مهجوراً تماماً وينحدر من الشارع الذي كنا نسير فيه، ورأيت سيارة رمادية مغلقة تقف عند أحد المداخل. طرأت لي فكرة فتوجهت إلى السيارة وعالجت بابها فانفتح. قلت لزوجتي: “أسرعي! هذه هي فرصتنا… ضعيه في المقعد الخلفي.” فعلت ما قلت ووضعت الطفل في المقعد الخلفي وأغلقت الباب. فعلنا ذلك في لمح البصر ودون أن يرانا أحد، ثم تأبطت ذراعها وأسرعنا في طريقنا إلى “بيازا ديل كورينالي”.
كانت الساحة خالية وشبه مظلمة إذ لم تكن فيها إلا بضعة مصابيح مضيئة في أسفل البنايات، أما المصابيح الأخرى فكانت مطفأة. روما كانت تلتمع تحتنا أسفل السياج. توجهت زوجتي إلى النافورة تحت المسلة وجلست على أحد المقاعد وبدأت تبكي على الفور وهي تدير ظهرها لي. قلت لها: “ماذا بك الآن؟” أجابت: “أحسّ بأنني أفتقده بعد أن تركته! أشعر أن هناك شيئاً مفقوداً هنا حيث كان يمسك بصدري.” قلت في محاولة لتهدئتها: “أجل، لا شك بذلك، ولكنك ستتعودين على هذا الأمر.” هزت كتفيها وتابعت البكاء، وفجأة جفت دموعها كما يجف ماء المطر عن أرض الشارع مع هبوب الريح. قفزت ثانية من مكانها وقد تملكها الغضب وأشارت إلى إحدى البنايات المطلة على الساحة وهي تقول: “سأذهب إلى هناك فوراً وسأطلب رؤية الملك لأخبره بكل شيء.” صرخت فيها وأنا أقبض على ذراعها: “قفي، هل جننت؟ ألست تعرفين أنه لم يعد هنالك ملك بعد؟” قالت: “وماذا يهمني في ذلك؟ سأكلم من أخذ مكانه!” واندفعت راكضة نحو بوابة القصر، ولا يعلم إلا الله وحده ماذا كانت ستفعل لو أنني لم أقل لها في لحظة يأس: “حسناً! اسمعي، لقد فكرت في الأمر ثانية. لنذهب إلى تلك السيارة ونستعيد الطفل، أعني سنربيه بأنفسنا. ما الفارق؟ طفل آخر ليس إلا!” كانت تلك هي النقطة الحاسمة في القضية كلها حيث تغلبت تلك الفكرة على فكرة مخاطبة الملك. وقالت وهي تهرول باتجاه الشارع الصغير الذي كانت تقف فيه السيارة الرمادية: “هل تظن أنه ما زال هناك؟” أجبتها: “بالتأكيد! لم يكن ذلك إلا منذ خمس دقائق فقط.”
كانت السيارة ما تزال هناك بالفعل، غير أنه في اللحظة التي كانت تهم فيها زوجتي بفتح الباب برز من المدخل رجل قصير القامة في أواسط عمره تبدو عليه سيماء الأهمية فصاح بها: “توقفي.. توقفي.. ماذا تفعلين بسيارتي؟” أجابته زوجتي دون أن تلتفت وهي تنحني لتلتقط اللفة من فوق المقعد: “أريد ما هو لي!” ولكن الرجل قال بإصرار: “ولكن ماذا لديك هناك؟ إنها سيارتي، هل تفهمين؟ سيارتي!”
ليتك رأيت زوجتي حينذاك، فقد شدت قامتها واتجهت نحوه وهي تصيح: “ومن أخذ منك أي شيء؟ لا تخف! ليس هناك من سيأخذ منك أي شيء، أما سيارتك فإنني أبصق عليها.. انظر!”
وبصقت بالفعل على باب السيارة. قال الرجل بحيرة: “ولكن تلك اللفة؟” أجابته بانفعال: ليست لفة، بل هي طفلي. يمكنك أن تراه إن أردت!”
كشفت عن وجه الطفل كي يراه ثم تابعت تقول: “لن تنجب أنت وزوجتك طفلاً في مثل جماله حتى ولو ولدتما من جديد! لا تقترب مني وإلا فإنني سأصرخ وأطلب الشرطة لأقول لهم بأنك كنت تحاول أن تسرق طفلي!” ثم أخذت تشتمه وتهدده حتى أن الرجل المسكين كاد يسقط مغشياً عليه وهو يقف فاغر الفم أحمر الوجه. وفي النهاية سارت بخطى متهادية حتى وصلت إلى جانبي عند زاوية الشارع.
ترجمة حصة المنيف