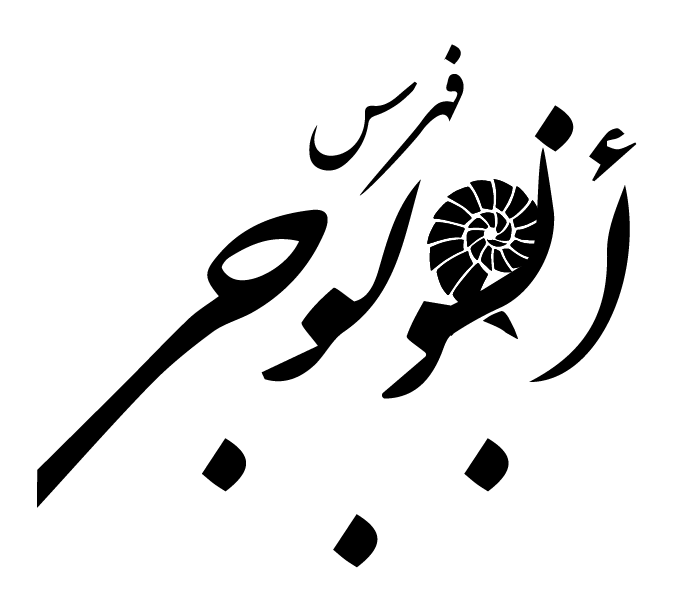في بلاد أخرى (1927)
ترجمة: موسى الحالول
في الخريف ظلت الحرب قائمة كما كانت، لكننا لم نعد نذهب إليها. كان الخريف في ميلانو بارداً وكان الظلام يحل باكراً. كانت المصابيح الكهربائية تُنار، وكان النظر في نوافذ المحلات على الشارع أمراً ممتعاً. كانت واجهة المحلات تزدحم بالصيد البري، وكان الثلج يتسلل إلى فراء الثعالب، وكانت الريح تداعب أذيالها. كانت الغزلان تتدلى متخشبة، وثقيلة، وجوفاء، وكانت الطيور الصغيرة تتطاير في الريح وكانت الريح تُقَلَّب ريشاتها. كان خريفاً بارداً، وكانت الريح تنحدر من الجبال. كنا نجتمع كلنا في المستشفى عصر كل يوم، وكانت هناك طرق مختلفة للمجيء عبر المدينة إلى المستشفى ساعة الغسق.
اثنتان من هذه الطرق كانتا بمحاذاة القناة، لكنهما طريقان طويلتان. لكنه لا مناص أبداً من عبور أحد الجسور على إحدى القنوات لدخول المستشفى. وعلى المرء أن يختار واحداً من بين ثلاثة جسور. على واحد من هذه كانت امرأة تبيع الكستناء المحمصة. كان الدفء يلفحك وأنت تقف أمام النار المنطلقة من موقدها الفحمي، وبعدها يلازمك هذا الدفء من خلال حبات الكستناء في جيبك. كان المستشفى قديماً جداً وجميلاً جداً، وكنت تدخل من بوابة، فتعبر باحة لتخرج من بوابة على الطرف الآخر. كانت الجنائز عادة ما تنطلق من الباحة. كانت تقوم خلف المستشفى مقصورات جديدة مبنية من القرميد، وكنا نجتمع هناك عصر كل يوم، وكنا جميعاً في غاية اللباقة ومهتمين بما يجري حولنا، وكنا نجلس في تلك الآلات التي غيرت مجرى الأمور كثيرا.
جاءني الطبيب وأنا أجلس في آلتي وقال، «ما هي هوايتك المفضلة قبل الحرب؟ هل كنت تمارس رياضة ما؟»
قلت له، «نعم، كرة القدم.»
«جيد،» قال. «وستستطيع أن تلعب كرة القدم مرة أخرى، وخيراً من أي وقت مضى.»
لم أكن قادراً على ثني ركبتي، وكانت ساقي بلا ربلة وتتدلى بشكل مستقيم من ركبتي إلى كاحلي، وكان المفروض أن تقوم الآلة بثني الركبة وتحريكها كما في ركوب دراجة ذات ثلاث عجلات. لكنها لم تنثن بعد، بل كانت الآلة تترنح عندما نصل إلى نقطة الثني.
قال الطبيب، «كل هذا سيزول. أنت شاب محظوظ. وستلعب كرة القدم مرة أخرى مثل الأبطال.»
في الآلة التي تلي آلتي كان يقبع ضابط برتبة رائد، وكانت له يد صغيرة كأنها يد طفل. غمز لي بعينه عندما فحص الطبيب يده التي كانت معلقة بين حزامين جلديين كانا ينطان ويضربان أصابعه المتخشبة، وقال، «وهل سأتمكن أنا أيضاً من لعب كرة القدم، سيدي النقيب الطبيب؟» لقد كان مبارزاً عظيماً جداً، بل
أعظم مبارز بالسيف في إيطاليا قبل الحرب.
ذهب الطبيب إلى مكتبه في غرفة خلفية وأحضر صورة تظهر يداً كانت قد ذبلت فأصبحت بحجم يد الرائد تقريباً، وبعد أن أُ ْخضعت لدورة علاج بالآلة صارت أكبر قليلا من يد الرائد. أمسك الرائد الصورة بيده السليمة وتأملها ملياً، ثم ُ سأل، «جرح؟.»
«بل حادث في مصنع،» قال الطبيب.
«رائع جداً، رائع جداً،» قال الرائد وأعاد الصورة إلى الطبيب.
«عندك ثقة؟»
«لا،» قال الرائد.
كان ثلاثة شباب في مثل سني تقريباً يأتون يومياً. كانوا جميعاً من ميلانو، كان واحد منهم يريد أن يصبح محامياً، والثاني رساماً، والثالث جندياً، وكنا أحياناً، بعد انتهاء جلسات العلاج الآلي، نترافق معا إلى مقهى «الكهف» الذي كان بجانب الصالة. كنا نختصر الطريق بالمرور من الحي الشيوعي لأننا كنا أربعة. كان الناس يكرهوننا لأننا كنا ضباطاً، وكنا نسمع أحدهم ينادي من مقهى «يسقط الضباط»! ونحن نمر. كان شاب خامس يرافقنا أحياناً، وكان يضع على وجهه منديلا حريرياً أسود لأن أنفه قد جِدعت وكان وجهه بحاجة إلى ترميم. كان قد ذهب إلى الجبهة من الأكاديمية العسكرية، وجرح خلال ساعة من وصوله إلى خط الجبهة لأول مرة. رمموا وجهه، ولكنه كان سليل أسرة عريقة جداً، فلم يستطيعوا أن يعيدوا الأنف إلى ما كانت عليه تماماً. ذهب إلى أمريكا الجنوبية وعمل في أحد المصارف. لكن هذا كان منذ وقت طويل، ولم يكن أي منا يعلم كيف ستؤول الأمور بعد ذلك. كل ما كنا نعلمه أن الحرب ستظل قائمة، لكننا ما عدنا نذهب إليها.
لقد نلنا جميعاً ذات الأوسمة، ما عدا الشاب صاحب الضمادة الحريرية السوداء على وجهه، حيث لم يطل مكثه في الجبهة ليستحق وساماً. كان الشاب الطويل ذو الوجه الشاحب جداً والطامح إلى سلك المحاماة ملازماً في سلاح المغاوير وحاز ثلاثة أوسمة من النوع الذي لم ننل منه سوى واحد. لقد عايش الموت زمناً طويلا، فأصبح منزوياً إلى حد ما. لقد كنا جميعاً منزوين إلى حد ما، ولم يكن هناك ما يجمع بيننا سوى لقائنا عصر كل يوم في المستشفى. بيد أننا كنا نشعر، ونحن نسير إلى مقهى «الكهف» عبر حارة «الزعران،» أو في الظلام، حيث الأنوار والأغاني تنطلق من المقاهي، أو عندما نضطر أحيانا إلى المشي في الشارع لأن حشوداً من الرجال والنساء وقفت لنا على الرصيف فلا نستطيع أن نشق طريقنا إلا بشق الأنفس، كنا نشعر أن شيئاً ما قد حدث، فربطنا برابطة لا يدرك كنهها هؤلاء الكارهون لنا.
أما نحن فقد فهمنا «الكهف» حيث الترف، والدفء، والاعتدال في الإضاءة الساطعة، والضوضاء، والدخان الكثيف في بعض الأحيان، والفتيات اللواتي يطوفن بالطاولات على الدوام، والصحف المصورة المعلقة على مشبك في الجدار. كانت الفتيات في «الكهف» يتفجرن وطنية، ولقد وجدت أن أكثر الناس وطنية في إيطاليا هن فتيات المقاهي، وأعتقد أنهن ما زلن كذلك.
كان الشبان في البداية لبقين جداً فيما يتعلق بأوسمتي، وكانوا يسألونني عما فعلته كي أستحقها. أخرجت لهم الأوراق، التي كانت مكتوبة بلغة جميلة جداً وتزدحم بعبارات «الأخوة» و«الإيثار» بيد أنها، إذا ما حذفت النعوت، كانت في الحقيقة تقول إنني نلتها لأنني أمريكي. تغيرت نظرتهم بعد ذلك تجاهي، رغم أنني بقيت صديقاً لهم رغم الغرباء. بقيت صديقاً، لكنني في الحقيقة لم أكن واحداً منهم بعد أن قرأوا الإشادة ببطولاتي، حيث إن الأمر كان مختلفاً معهم، وقد قاموا بأمور مختلفة جداً عما قمت به لكي ينالوا أوسمتهم صحيح أنني جُرحت، لكننا جميعاً نعلم أن الجرح في الواقع ليس سوى حادث عَرضي.
لم أخجل أبداً من شرائطي، بل كنت أحياناً أتخيل بعد انتهاء ساعة الكوكتيل أنني فعلت كل ما فعلوه لكي ينالوا أوسمتهم، لكنني عندما أعود ليلا إلى البيت عبر الشوارع المقفرة والمحلات المغلقة والريح الباردة تلفحني، وأنا ألازم السير تحت المصابيح، كنت أعلم في قرارة نفسي أنه ما كان في إمكاني قط أن أفعل
مثل هذه الأشياء، وأنني كنت شديد الخشية من الموت، وكنت في أغلب الأحيان أستلقي في فراشي ليلا وحدي ومخاوف الموت تتناهبني وأتساءل عما ستؤول إليه حالي إن عدت إلى الجبهة مرة أخرى.
كان الثلاثة أصحاب الأوسمة كالصقور الجارحة، ولم أكن صقراً، مع أنني قد أكون صقراً لأولئك الذين لم يعرفوا الصيد قط. كان الثلاثة أدرى بحالي، فافترقنا. لكنني بقيت صديقا للشاب الذي أصيب في يومه الأول في الجبهة، لأنه ليس في وسعه الآن أن يعرف إلام كانت ستؤول أموره، وبالتالي فإنهم سينبذونه أيضاً، كما أنني أحببته لأنني ظننت أنه لن ينقلب صقرا.
لم يكن الرائد، المبارز العظيم سابقاً، يؤمن بالاستبسال، وقد أمضى جل وقته ونحن في الآلات يُصَوب حديثي من الناحية النحوية. كان قد أثنى على حديثي المُتَمكن بالإيطالية، وكنا نتحدث معا بيسر شديد. وفي يوم من الأيام قلت إن الإيطالية تبدو بالنسبة إلي لغة سهلة تجعلني لا أهتم بها كثيراً، فكل شيء فيها سهل قوله. «نعم،» قال الرائد. «لماذا، إذن لا تدرس النحو الإيطالي؟» وهكذا بدأنا دراسة النحو الإيطالي، فإذا بالإيطالية لغة عسيرة جعلتني أخشى الحديث إليه بها قبل أن أتمكن من قواعد النحو.
كان الرائد يتردد على المستشفى بانتظام شديد. ولا أظن أنه فوت يوماً واحداً، مع أنني على يقين أنه لم يكن يؤمن بجدوى الآلات. في وقت من الأوقات لم يكن أحد منا يؤمن بجدوى الآلات، وفي يوم من الأيام قال الرائد إن الأمر برمته هراءٌ بهراء. كانت الآلات حينها جديدة، وكان علينا نحن أن نثبت جدواها. قال إنها فكرة غبية، ونظرية مثل كل النظريات. لم أتعلم القواعد، فقال عني إنني عار على البشرية وغبي لا يطاق،
أما عن نفسه فقال إنه كان أحمق حين تورط في هذا الأمر. كان رجلا صغير الحجم، وكان يجلس بشكل مستقيم في كرسيه، واضعاً يده اليمنى في الآلة، وينظر أمامه إلى الجدار بينما الحزامان المحيطان بأصابع يده ينتفضان صعوداً وهبوطاً.
«ماذا ستفعل عندما تنتهي الحرب، هذا إن انتهت؟» سألني، ثم أردف قائلاً: «تحدث بشكل نحوي صحيح.»!
«سأعود إلى أمريكا.»
«هل أنت متزوج؟.»
«لا، ولكني آمل أن أتزوج.»
«وهذا دليل ُ آخر على حمقك،» قال لي. بدا غاضباً جداً
«على الرجل ألا يتزوج.»
«لماذا، يا سيدي الرائد؟.»
«لا تقل لي، سيدي الرائد.»
«لماذا على الرجل ألا يتزوج؟»
«لا يمكنه أن يتزوج. لا يمكنه أن يتزوج،» قال بغضب شديد.
«إن كان يريد أن يخسر كل شيء، فعليه ألا يضع نفسه في مثل هذا الموضع. عليه ألا يجعل نفسه عرضة للخسارة. عليه أن يجد أشياء لا يمكنه أن يخسرها.»
تحدث بغضب ومرارة شديدين، وكان ينظر أمامه وهو يتحدث.
«ولماذا يخسرها بالضرورة؟.»
«سيخسرها،» قال الرائد. كان ينظر إلى الجدار. ثم نظر إلى الآلة أمامه وانتزع يده الصغيرة من بين الحزامين، وخبطها بشدة على فخذه. «سيخسرها،» قال بصوت أشبه بالصراخ.
«لا تجادلني»! ثم نادى على المسؤول عن تشغيل الآلات. «تعال وأطفئ هذه الآلة اللعينة.»
توجه إلى الغرفة الأخرى من أجل العلاج الضوئي والتدليك. ثم سمعته يطلب إلى الطبيب أن يستخدم هاتفه وأغلق الباب.
عندما عاد إلى الغرفة، كنت أجلس في آلة أخرى. كان يرتدي مئزره وقبعته، واتجه مباشرة نحو آلتي، ووضع ذراعه على كتفي.
«أنا آسف جداً ّ ،» قال وهو يربت على كتفي بيده السليمة.
«لم أقصد أن أسيء الأدب، لكن زوجتي ماتت لتوها. أرجو أن تسامحني.»
«أوه،»… قلت وأنا أشعر بالغثيان من أجله. «بل أنا الذي يأسف جداً.»
ظل واقفاً وهو يعض على شفته السفلى. «إنه أمر في غاية الصعوبة،» قال. «لا أستطيع أن أتقبل الأمر.»
راح يسدد نظراته التي تجاوزتني إلى النافذة التي خلفي.
ثم راح يبكي. «لا أستطيع أبداً أن أتقبل الأمر،» قال وهو يَغص
بدموعه. هكذا تخطى الآلات وخرج من الباب باكياً، مرفوع الرأس، يحدق في الفراغ، ماشياً بخط مستقيم على شاكلة الجنود، يعض على شفتيه، والدموع تنهمر على خديه.
قال لي الطبيب إن زوجة الرائد، التي كانت في ميعة الصبا ولم يتزوجها إلا بعدما أُخرج من ساحة القتال خروجاً لا عودة عنه، قد توفيت بداء ذات الرئة. لم يَطل مرضها إلا بضعة أيام. لم يتوقع أحد أنها ستموت. توقف الرائد عن المجيء إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام. بعد ذلك جاء في ميعاده، وهو يرتدي شريطاً أسود على ردن لباسه العسكري. عندما عاد، وجد صوراً كبيرة مؤطرة معلقة على الجدارتُ ظهر شتى أنواع الجروح قبل علاجها بالآلات وبعده.
ٍ أمام الآلة التي يستخدمها الرائد كانت هناك ثلاث صور لأيد َكيَدِهِ، فتم ترميمها تماماً. لا أعرف من أين حصل عليها الطبيب. ما كنت أعرفه دوماً هو أننا أول من استخدم هذه الآلات. لم يأبه الرائد كثيراً للصور، لأنه كان يسدد نظراته خارج النافذة.