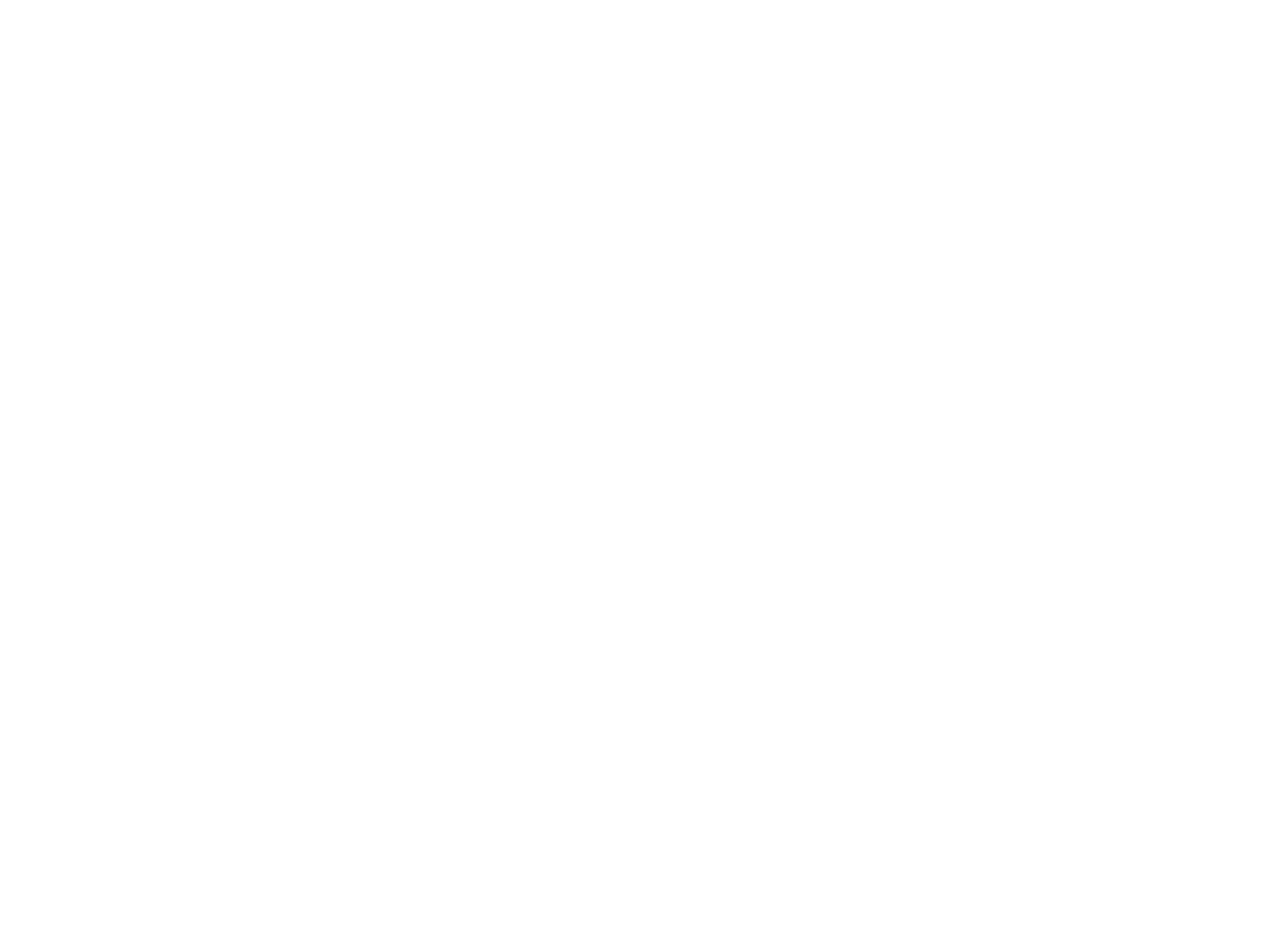أنا قاصة، وأودّ أن أروي لكم ما أحب تسميته بـ “خطر القصة المفردة”. نشأت في مدينة جامعية في شرق نيجيريا. تقول أمي إنني بدأت القراءة في الثانية من عمري، رغم أنني أظن أن الرابعة هي الأقرب للحقيقة. وهكذا بدأت القراءة باكرًا، وما كنت أقرأه كان كتبًا للأطفال بريطانية وأمريكية، كما بدأت الكتابة في عمر باكر أيضًا. وبدأت أكتب في السابعة من عمري قصصًا بالقلم الرصاص لها رسومات ملونة، كانت أمي المسكينة ملزمة بقراءتها. كنت أكتب قصصًا من نوع القصص التي أقرأها تمامًا، إذ كانت كل شخصياتي لها بيضاء البشرة وزرقاء العينين. كانت الشخوص تلعب بالثلج، وتأكل التفاح، وتتحدث عن الطقس وروعة سطوع الشمس. وهذا على الرغم من أني أعيش في نيجيريا ولم أسافر خارجها أبدًا. فلا يهطل فيها الثلج، ونحن نأكل المانغو ولا نتحدث عن الطقس أبدًا، لأنه ليس ثمة ضرورة.
كانت شخصياتي أيضًا تشرب بيرة الزنجبيل، بمعزل عن كوني لا أملك أدنى فكرة عما تكون، ولسنوات عديدة بعد ذلك انتابتني رغبة جامحة في تذوقها. لكن هذه قصة أخرى! ما يبينه هذا، برأيي، مدى انقيادنا وهشاشتنا في مواجهة القصة. وبخاصة بوصفنا أطفالًا. ولأن ما قرأته كان كتبًا شخصياتها أجنبية ، فقد اقتنعت أن الكتب بطبيعتها لا بد أن تحوي شخصيات أجنبية، ولا بد أن تكون عن أمور لا يمكنني إدراكها شخصًا.
لكن تغيرت الأمور حين اكتشفت الكتب الأفريقية. لم يكن هنالك الكثير منها ولم يكن يسهل العثور عليها بقدر الكتب الأجنبية. لكن بفضل كتّاب من أمثال شينوا أشيبي وكامارا لاي، خضعت لتحول عقلي في رؤيتي للأدب. فقد أدركت أن أشخاصًا مثلي- فتيات بشرتهن لها لون الشوكولاتة، واللاتي لا يمكن عقد شعورهن المفلفلة على هيئة ذيل حصان- يمكن أن يظهروا في الأدب أيضًا. فبدأت الكتابة عن أمور أعرفها.
لقد أحببت تلك الكتب البريطانية والأمريكية التي قرأتها، فقد حرضت خيالي، وفتحت لي عوالم جديدة. لكن النتيجة غير المنتظرة كانت في جهلي بوجود أشخاص مثلي في الأدب. لذا ما منحني إياه اكتشاف الكتاب الأفريقيين أنه أنقذني من امتلاك قصة مفردة لطبيعة الكتب.
أنحدر من عائلة نيجيرية تقليدية من الطبقة المتوسطة. كان أبي أستاذًا جامعيًا وأمي إدارية، وكان لدينا- كما كانت العادة- خادم يسكن معنا، ويكون عادة من قرية قريبة. في العام الذي بلغت فيه الثامنة، كان لدينا خادم جديد، اسمه فيدي. الأمر الوحيد الذي أخبرتنا به أمي عنه هو فقر عائلته الشديد. كانت أمي ترسل البطاطا الحلوة والأرز وثيابنا القديمة لعائلته. وحين لم أكن أنهي عشائي كانت تقول “أنهي طعامك! ألا تعرفين؟ الناس أمثال فيدي لا يملكون شيئًا”. لذا شعرت بشفقة هائلة نحو أسرة فيدي.
ثم ذهبنا في يوم سبت لزيارة قريته، وأرتنا أمه سلة جميلة من الخوص الجاف صنعها أخوه. فأصابتني الحيرة. لم يخطر لي أن أحدًا في عائلته يمكنه صنع شيء حقًا، فكل ما سمعته عنهم كان مدى فقرهم، وصار مستحيلًا لديّ أن أرى فيهم شيئًا سوى كونهم فقراء. كان فقرهم قصتي المفردة عنهم.
بعد سنوات، تذكرت هذا حين غادرت نيجيريا للدراسة في جامعة في الولايات المتحدة. كنت في التاسعة عشرة. وقد فوجئتْ بي شريكتي في السكن، فسألتني أين تعلمت تحدث الإنجليزية بهذه الطلاقة، واحتارت حين قلت لها إن اللغة الإنجليزية لغة رسمية في نيجيريا. وسألتني إن كان بإمكاني إسماعها شيئًا مما سمته “موسيقاي القبلية”، وخاب أملها بعد ذلك حين أخرجت شريط ماريا كاري. كما افترضتْ أنني لا أعرف كيف أشغل الموقد، ولكن ما صعقني كان شعورها بالأسى نحوي حتى قبل أن تراني. كانت نظرتها الافتراضية عني، بوصفي أفريقية، شيئًا من الاستعلائية والشفقة الحسنة النية. كان لدى شريكتي في السكن قصة أحادية عن أفريقيا، وقصة أحادية عن المأساة. في هذه القصة، ليس ثمة احتمال بشبه الأفريقيين بها بأية حال، ولا احتمال بالشعور بشيء أكثر تعقيدًا من الشفقة، ولا احتمال للتواصل بوصفنا بشرًا متساووين.
لكن علي أن أضيف سريعًا أنني أنا أيضًا متورطة بالقدر نفسه بالقصة الأحادية. قبل بضع سنوات زرت المكسيك من الولايات المتحدة، وكان المناخ السياسي في الولايات المتحدة ذلك الوقت متوترًا، وظهرت نقاشات عن الهجرة. وصارت كلمة “المهاجرين”، كما يحدث في أمريكًا كثيرًا، مرادفًا للأشخاص الذين يستغلون نظام الرعاية الصحية، ويتسللون عبر الحدود، ويلقى القبض عليهم عند الحدود وأشياء من هذا القبيل.
أتذكر أنني كنت أتجول في الأنحاء في يومي الأول في غوادالاهارا، أراقب الناس وهم يذهبون للعمل، ويلفون خبز التورتيا في السوق، ويدخنون ويضحكون. أذكر أنني شعرت بادئ الأمر بشيء من الدهشة، ثم غمرني شعور بالخزي. أدركت أنني كنت منغمسة جدًا بتصوير الإعلام للمكسيكيين للحد الذي صاروا فيه شيئًا واحدًا في ذهني: المهاجرون المتسللون. لقد تأثرت بالقصة الحأادية عن المكسيكيين، ولم أكن لأصبح أكثرخجلًا من نفسي عندها. هكذا تخلق القصة الأحادية، أظهِر الناس وكأنهم شيء واحد، وكأنهم شيء واحد فحسب، مرة بعد أخرى وهذا ما يصبحون عليه.
لكن الإصرار على هذه القصص السلبية فقط يعني تسطيح تجربتي، وتجاهل القصص العديدة الأخرى التي شكّلتني. تخلق القصة الأحادية أنماطًا، ومشكلة الأنماط ليس في أنها غير صحيحة وأنها ناقصة، بل أنها تجعل قصة واحدة القصة الوحيدة… لقد شعرت على الدوام أن من المستحيل الارتباط بمكان أو شخص جيدًا دون الارتباط بكل القصص حول ذلك المكان أو ذلك الشخص. تكمن نتيجة القصة الأحادية في أنها تسلب الكرامة من الناس، فهي تجعل إداركنا لمساواتنا بوصفنا بشرًا أمرًا صعبًا، إنها تؤكد على مدى اختلافنا بدلًا من التركيز على مدى تشابهنا.
أدرّس في ورشات الكتابة في لاغوس كل صيف، وقد أذهلني عدد الأشخاص المتقدمين، ومدى لهفة الناس على الكتابة وعلى رواية القصص. لقد أنشأنا أنا وناشري النيجيري مؤسسة لا ربحية تدعى صندوق فارفينا، ولدينا آمال عظيمة في بناء المكتبات وإعادة تأهيل المكتبات الموجودة وتأمين الكتب لمكتبات مدارس الدولة الفارغة، وفي تنظيم الكثير والكثير من الورشات، للكتابة والقراءة، لكل الأشخاص المتحمسين بسرد حكايانا الكثيرة. القصص مهمة، الكثير من القصص مهمة. لقد استغلت القصص للسلب والأذى، لكن يمكن أن تستغل القصص أيضًا للتمكين والأنسنة. يمكن أن تحطم القصص كرامة شعب، لكن يمكنها أيضًا إصلاح الكرامة المكسورة.
ترجمة: بثينة إبراهيم.