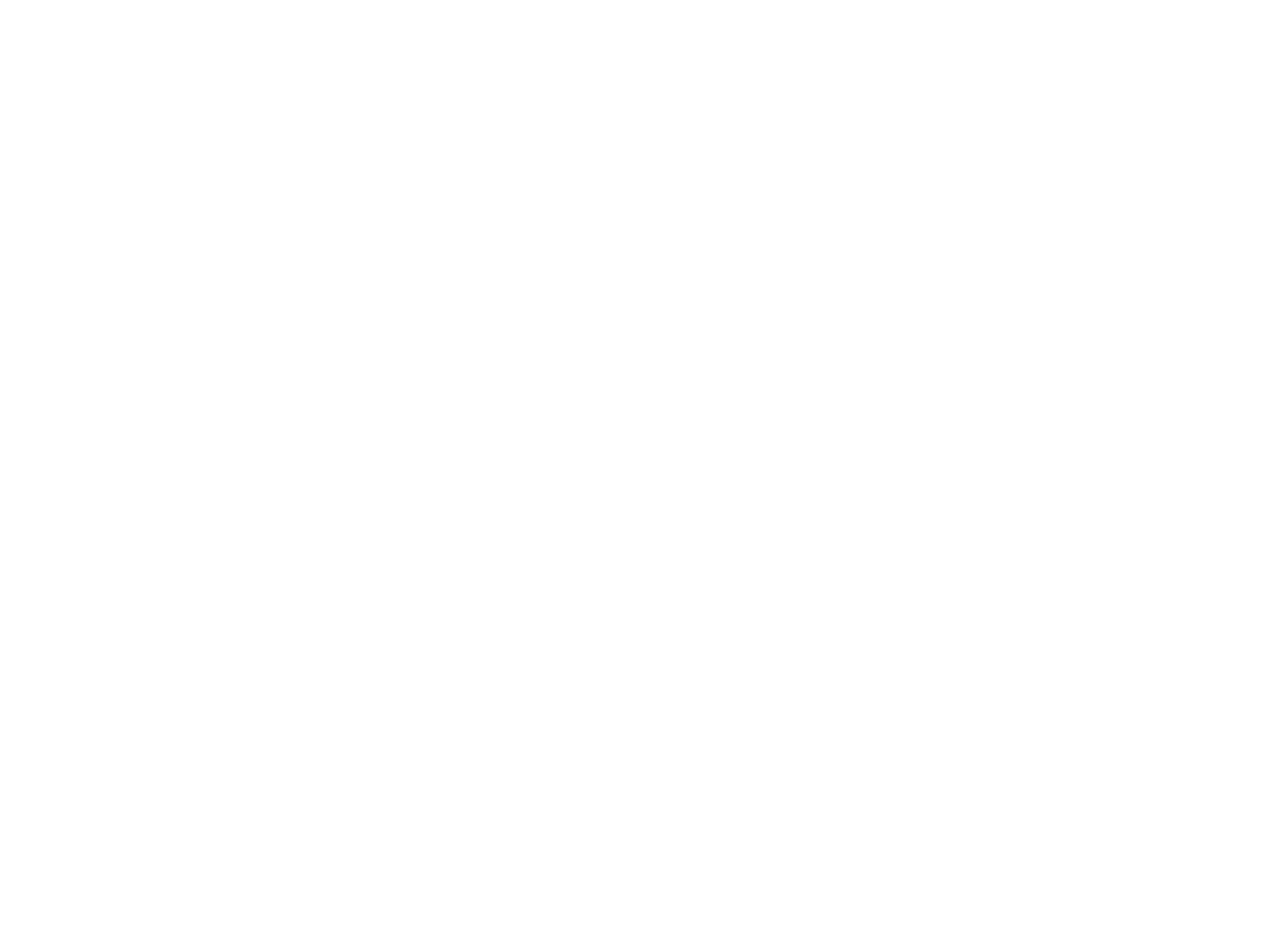دبي – 1935 1936 م
رأس
رأسان
وثلاثة
الثلاثة تحولت إلى عشرة في ظرف أسبوع.
والعشرة في ظرف أسبوع آخر صارت عشرين.
عشرون رأسًا، وأنينٌ واحد، وعطونةٌ تؤكد اتحادهم، ملامحهم ينز منها دمٌ أصيل معبرٌ عن الكارثة.
كانت “شما” تراقبهم من أعلى التل، وتتخيل الرائحة النافذة التي يتحدث عنها الجميع، كانت الأقرب إليهم من موضعها ذاك، وتتمنى في كل مرة تقف هناك، لو أن الريح، تحمل إليها العدوى، فتنضم إليهم إلى أن تحين لحظة الموت، لكنها كانت تفلت دائمًا، تنجو، لعله أنفها الغائب، لعله وباءٌ تنقله الرائحة، وهي بعد أيام مجدها في تقصي الرائحة، ليست إلا “شما” ذات الأنف المجدوع.
تراقب مصائراً محتومة، وتستغرب من رغبتها المستميتة في أن تكون مكانهم، بين المرتفعين القاحلين اللذان يمثلان تلتان بمحاذاة الساحل، المنفى الاختياري لكل من أصابته عدوى الجدري، يذهب إلى هناك، يحفر قبره بيده، يدفن الجسد، ويترك الرأس خارجًا كعلامة، كوصمة عار بكل تشوهات الملامح، حتى تحين لحظة الموت، ليبقى بوجه معلق، ينتظر انقضاء لحظة الوباء، حتى تنطفئ الروح، ويميل الرأس المتعفن.. العلامة الفارقة على فرار الروح
تستذكر بداية الأمر، مع “عبود بوراسين”، ارتفاعٌ مباغت في الحرارة، ثم نتوءات مقززة بدمامل مائية راحت تنتشر على كامل الجسد، كان يجر جسده جرًا، قبل أن يتشوه الجسد، لم تنفع معه علاجات العطارة، ومع انتشار الرائحة، كان أن ذهبوا به إلى الطبيب الإنجليزي في القاعدة العسكرية البريطانية في الإمارة، الذي كان أمل أهله الوحيد، استقبل الطبيب حالته برعب، لقد عرف الوباء، إنه الجدري، عليه أن يعزل نفسه بعيداً عنهم.
حمل “عبود بو راسين” نفسه واتجه إلى الساحل، لقد دنت النهاية ولعلها تكون بالقرب من أكثر مكانٍ تاق إليه طوال حياته، دفن الجسد وأبقى الرأس الكبير الذي لطالما كان كأنه رأسان مدمجان، لكنه اختار موضعها بين كثيبين، لقد كان مرض الرائحة، فما هما إلا يومان حتى لحق به شقيقه محمد في الأعراض، كانا ينامان في الغرفة نفسها، يتبادلان الهواء، والعطب المحتمل والمصير الوشيك ذاته.
فعل محمد الشيء ذاته
جسم مدفون
ورأس مشوه في الخارج
إلى أن يميل، وتنتهي الحكاية..
تبع محمد
سعيد
علي
مبارك
منصور
ثم غالية المرأة الأولى التي تصاب بالمرض بعد أن ظنت السيدات مجازًا أنهن محميات منه بشكل ما، وظنت شما أنه لا يصيبها، ليس لأنفها المجدوع، بل لأنها سيدة منهن أيضا، لكن الأمر بالنسبة لهن كان مجرد وقت ولحظة عدوى مناسبة، وبالنسبة لها، بقي الأمر غامضًا.. كانت معهن دائماً بعد أن جدع أنفها، لم تعد محتفظة بفرادتها، لم يعد لها أن تكون في أي مكان تريد وسط أروقة “سوق الدويات” لتختبر التوابل والروائح وتخبر عن أصلها وتكوينها، توارت معهن خلف الأبواب، ثم إنها كانت تخيف أطفال الحي، وتنفر قوافل التجار الآيبة، فمن يرغب بأن يصادف مسخا بشكل يومي، وفيما تفشى الأمر بينهن بعد غالية كعقد انفرط لتتساقط حباته.. بقيت هي خارج المعادلة
تحلم “شما” يومياً بتلك الحادثة، بالنصل البارد ممتزجًا بدمها الحار الذي تدفق، معاً يصنعان هزيمتها، لا تعرف إن كان كابوسا أم حلماً، لأنها تستيقظ دائمًا بشعور الذي يطفو على الماء، بعد أن ينزف دمها بشدة وتصرخ، ثم ترى شقيقها يركض مبتعداً برعب، لقد ظن أنها ستموت، رأته يغسل يده لاحقا، ويختبئ عدة أيام بعد أن وجدها الصبية على الشاطئ فجراً، لكن ويا للغرابة، لم يشك به أحد، ولم تتكلم هي، كانت تخاف أن تخسر عضوا آخر.. نُسجت بعدها وكالعادة، خرافة صغيرة عن كون الجنية التي كانت قد منحتها سابقا الأنف الخارق لسلالة التوابل، انتبهت للخطأ الذي ارتكبته عندما منحته للفتاة بدلًا من الفتى.
توازيا بعدها كثيرًا، هي و”عزيز”، ، لا ترفع عينها أبدًا، لكنها تدرك حضوره، ويتحاشى هو أن يتحول هذا التوازي إلى تقاطع، لكنه كان حاضراً يومياً حولها، وفي تفاصيلها، كيف للقاتل أن يرى ضحيته يومياً دون أن تظهر منه أي بادرة أسف؟، تسأل نفسها في لحظات استنارة نادرة، قبل أن تعود لشعور مبهم بالذنب، شعور غريب يخبرها بأنها نالت ما استحقته، وبأن “عزيز” كان يجب أن يفعل ذلك.. لكن ما هي الجريمة في هذا العالم المنضبط، الأدوار بين الرجل والمرأة هنا مرتبة بشكل تلقائي، ولكن لا أحد يستطيع التعامل مع الحالات الاستثنائية لأي منهما لو خرج عن دوره المفترض، كل حالة استثنائية، تصنع قصتها بنفسها، بين أن تكون في قمة الهرم الاجتماعي، أو في أدناه.. خارجة إلى منطقة النبذ، كان من الغرابة أنهما تشاركا الأمران، خرج هو من منطقة النبذ لضعف حاسة الشم لديه إلى قمة الهرم الاجتماعي بعد أن خسرت هي قمة الهرم الاجتماعي مع أنفها الذي جدع، وانتقلت لمنطقة النبذ.
لم يستطع “عزيز” أن يميز الروائح أبدا، حتى بعد الحادثة، لكنه كان الرجل بجوار الفتاة التي لم تعد تملك أية ميزة، وهذا ما كان كافياً ليحسم الأمر، تفكر أحياناً أن تسأله عن مكان أنفها، هل رماه في البحر، هل هو في مكان ما مخبأ لديه، لكن سؤالها له سيعني أن يتقاطعان، يعني أن يقر كل منهما بأن ما حدث على ليل الشاطئ في ذلك اليوم كان قد حدث فعلًا.
عندما أدركت ميلان رأس “عبود بو راسين” لفها شعور غامر باليأس، شعرت بأنها الآن فعلا قد خسرت كل شيء، لقد كان الوحيد الذي بقي على حاله معها، وأدهشها عندما أخبرها قبل مرضه بيومين أن عرض الزواج منها لا يزال قائمًا، كانا ليشكلان عائلة عظيمة من المسوخ، فكرت في نفسها ذلك اليوم قبل أن تلومها على عجرفتها.
بعد غالية
كانت أسماء
فسعاد
فآمنة
ثم نورة
لم تحتمل، تراكم الرؤوس على السطح، لم تحتمل الأنين، وقررت في ليلة، أنها ستذهب إلى الأسفل، لا شيء لديها لتخسره، ما الحياة التي ستخسرها على كل حال؟، بل لعلها ستكسب إن فعلت، أن تكون في منطقة اللاتباينات، حيث يتساوى الجميع في عطبهم، حملت قربة ماء، و “خيشة” من الجريد ملأتها بالتمر، وقصدت العالم السفلي الجديد، انسلت ليلا لكي لا يثير خروجها من البيت أي ارتياب، فقد باتت لا تغادره إلا لماماً بعد حادثة الأنف.
الليل يسري بصوت الأنين المكتوم القادم من هناك، وسكان الحي تشاغلوا عن الصوت بالرائحة، فلا شيء يضاهي رائحة المرض المزكمة التي لفت الحي من أقصاه إلى أقصاه وانتقلت كسلسلة مرعبة من حي إلى آخر، بين ثنايا البيوت المعروشة.
نظرت من الأعلى لمرة أخيرة، واستجمعت ما تبقى لها من شجاعة ممكنة، نزلت خطوة حذرة بعد أخرى، تقترب أكثر وتتبين مدى التشوه والتفسخ الذي استشرى في المكان، بدت الرؤوس كأنها رؤوس حجرية نحتتها الرياح بنتؤات بارزة مقززة، لا شك أنها رائحة مروعة، تلك التي يعبق بها هذا المكان، ولعلها في نعيم اليوم بسبب عدم قدرتها على إدراك الروائح.
وصلت، كان القمر بدراً شتويا، اصطفت الرؤوس في تساويها المروع في الحياة والموت، والأجساد المعطوبة المدفونة، دون حواجز تذكر بين جسدٍ لذكر أو أنثى، ومكان يخص الرجال وآخر للنساء، أو قيود تفرضها عوراتٌ محرمة، كان الآيبون دون شرط الجنس يحفرون قبورهم النصفية بأيديهم ثم لاحقا بعد تكاثرهم بالأدوات البدائية التي يحضرها كل مصاب معه كل واستطاعته، ثم يتجرد أيهم من ملابسه المشبعة بالرائحة العفنة وآثار الدمامل الدامية التي استبدت بالجسد دون أن ينظر إليه أي من أصحاب الرؤوس، وكل منصرف في بلواه الخاصة وألمه الشديد، ليدلف إلى حفرته، هنا الكل متساوون في تفسخ الجسد وانعدام الشهوات.
سمعت “مظفر” يئن، تتذكر مظفر القوي، سيد سوق التوابل أحد أبناء عمومتها، البارع في المقايضة والأخذ والرد، اقتربت منه بحذر، كان أنينه هذيان الحمى، عيونه منتفخة والنتؤات تنز عن الخد بدم متقيح، انتفخ أنفه الذي كان حاداً، أضحى يشبه كثيراً أنفها الأفطس الذي غاب، ودت لو تسأله إن كان لا زال يستطيع أن يميز الروائح، لكنها أحجمت عن الأمر لما تبينت لهفته للماء، أدنت قربة الماء من شفاهٍ متآكلة، كشفت عن صف من الأسنان المتخلخلة، كانت تسقي مسخاً، أدركت ذلك لكنها لم تخف، بعكسه أول مرة رآها بعد أن جُدع أنفها، تتذكر أنه بعد اتسعت عيناه في رعب لمرآها بعد أن عولجت وبقي الفراغ محل الأنف كاشفًا عن نتوء لحمي يابس وفتحتان عشوائيتان، أشاح بوجهه في تقزز، بقي طويلاً بعدها في كل تقاطعاتهما القليلة وهو يزور والدها أو يدلف لمجلس آل تجار التوابل، يتحاشاها، لكنه ينظر إليها الآن، مسخٌ يواجه آخرًا، ويألفه.
بعض الرؤوس التي بقيت كان غالب أصحابها قد أصابهم العمى، مضاعفة ماكرة أخرى من مضاعفات الجدري، راحت تسقيهم رشفات، حتى وصلت إلى الرأس المائل الأول، كانت الآن في منطقة التقاطع، صفان أفقيان من الرؤوس الحية، في مقابل أربعة صفوف أفقية أخرى من الرؤوس المائلة، الخامدة، التي راحت تتفسخ ويحمل البحر كلما امتد، كتلا من اللحم البشري منها، لتطفو أياما قبل أن يذيبها الملح أو تمضي عميقا فتلتهمها كائنات البحر.
أتتركهم هكذا؟
تذكرت “عبود بو راسين” كيف لها أن تغفل رأسه الضخم، لكن اللحم المتقيح والمنتفخ المتعفن والمزرق ضاعف من أحجام الرؤوس جميعها، لقد أضحى “عبود” طبيعيا أخيرا بينهم، حاولت أن تتذكر علامة أخرى فيه، لا شيء سوى الرأس الكبير، تأملت أول رأس في الصفوف الأربعة، كان أقدمهم وأكثرهم تفسخا، وباعتباره المائل الأول، لا بد أن يكون هو.. يأسها الحي هناك في رأس “عبود” الميت.
أتتركه هكذا؟
اقتربت، جلست بمحاذاة الرأس، أو ما تبقى منه، قربت القربة، لعل الماء الحلو يصلح ما أفسده الملح، لعل معجزة ما تحدث فيستيقظ، قربت القربة أكثر فسقطت قطعة لحم متعفنة، آخر ما تبقى من الشفة، وبقيت الأسنان الصفراء المتخلخلة، حاولت أن تتذكر ابتسامة “عبود”، هل كانت أسنانه بهذا الصفار الفاقع دائماً؟
فشلت في أن تتذكر.
كان رمل الشاطئ رطبا ليلتها، لعله مدٌ قريب انحسر، في لحظة لم تفهمها، حملت شيئاً من ذلك الرمل الرطب وراحت تحاول أن تعالج شفة “عبود” بواحدة أخرى من هذا الرمل الرطب الطيني، الإنسان طينٌ في النهاية، أليس كذلك؟ فكرة طافت ببالها وهي تستذكر ما علمها إياه والدها لما كان يدرسها القراءة والكتابة، وجدت نفسها بعد ذلك تهيل الطين على الرأس كاملًا، لا تدفنه بل تعيد تشكيله من جديد، لقد أرادت في لحظة مجنونة توازت مع جنون دخولها للعالم السفلي في هذه الليلة أن تعيد كرامة هذا الميت، برأس بديل، من الطين.. وهكذا بدأ الأمر.. من رأس عبود الجديد المنحوت بشكل اعتباطي راحت تنحت رأسا بعد آخر، وتنتظر الشمس لتجفف عملها، تكون الصورة عظيمة في النهار رؤوس طينية، سوت من ميلانها وعدلت ما فقدته، تتأملها بفخر وهي تحاول مواصلة إعانة الرؤوس الحية برشفة ماء حلو حتى نفذ، تحولت بعدها لرشفات من الماء المالح متبوعة بأنين ملسوع، الملح يزيد من آلام التقيحات، لكن العطش مرير، حتى وإن كان عطشًا يروى بعطش آخر مالح، وبلسعات، لعلها محاولات التشبث بالحياة رغم كل شيء.. ثم يأتي الغروب، ومعه مد البحر، ليكشف عن عورات الرؤوس الميتة الممسوخة، ويحمل الطين واللحم المتعفن، فتعود هي لما بدأته، يومياً، لقد ظنت أنها محمية من المرض لأجل هذه الغاية.
لم تعلم وسط انهماكها، إن كان أحدهم يبحث عنها هناك في العالم المفترض، هي تعلم جيداً أن أحداً منهم لن يتجرأ على أن يغامر باحثًا عنها هنا، لكن من كان يأتي، مصاباً إلى منطقة العزل المروعة هذه، كان يجدها، حارسة الرؤوس التي ستعينه على المضي بسلام.. وكان يعينها كل رأس بطريقته وهو يأتي بطعام يعينه على
أيامه الأخيرة، طعام كانت تستهلكه مناصفة بينها وبين من تبقى من الرؤوس.
ثم لم تعلم كم من الوقت مضى عليها وهي تزاول هذا الأمر الجديد، لكنها لاحظت تقلص أعداد الرؤوس الآتية، وزيادة عدد الرؤوس المائلة، وانخفاض ضجيج الأنين واللسعات.
ثم أتى رأسٌ أخير، أخبرها بأن هناك علاجاً أتى به الإنجليز أخيرا للحي مع الدكتور “هولمز” وأن أعداد المصابين أخذت بالتقلص، وبأنه قد يكون آخر الملعونين بالمرض.
هل هذا يعني أنها فقدت قدرتها الخارقة من جديد، تساءلت وهي تعين ذلك الرأس، وتسوي ميلانه بعد أن انضم لرؤوس الموت وهي تنحته بالطين مرة بعد أخرى بين النهار والليل، هو وأقرانه من الرؤوس.
ثم سمعتهم يقتربون، بخطوات قوية، غير تلك التي ألفتها من الأجساد المتعبة بالمرض، وعرفت أن النهاية حانت، سمعت عبارات بعيدة تأتي عن ضرورة إكرام الأموات بدفنهم وأنه لم يعد هناك ما يعدي وما يخيف بعد اللقاح وأن الرائحة المروعة يجب أن تضمحل مع ذاكرة الناس عن المرض.. ميزت صوتاً واضحاً بينهم كان صوت شقيقها “عزيز”.. شعرت بغضبٍ عارم يتفجر بداخلها.. وبين عالمهم العلوي والبحر الممتد خلفها، اختارت البحر، ومضت نحوه.
____________________________
- الأرشيف الوطني الإماراتي : عرفت سنة 1935 بسنة الجدري في الإمارات حيث تفشى مرض الجدري بين السكان بمعدل 100 إصابة في رأس الخيمة و12 وفاة في الشارقة، و30 إصابة و4 حالات وفاة في رأس الخيمة، وظهرت 80 إصابة و4 وفيات في أم القيوين، و15 إصابة و7 وفيات في عجمان، و30 إصابة وحالتين وفاة في الحيرة، فيما سجلت دبي أكبر حالات من الإصابات بلغت 500 إصابة و60 وفاة ، وفي يوم 4 يناير من عام 1936 وصل الطبيب المعين محمد سلمان سطور وبدأ عمله بتطعيم سكان إمارة الشارقة، ليتوجه بعدها إلى إمارة رأس الخيمة لإتمام عملية التطعيم، وفي دبي ولدراية المغفور له بإذن الله الشيخ حشر بن مكتوم، بعملية التطعيمات قام الوكيل الوطني خان صاحب حسين بإعطاء التطعيمات إلى المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم. وفي يوم 12 يناير وصل الطبيب هولمز لإمارة الشارقة وقام بزيارة المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم، كما شارك بتطعيم أهالي دبي خلال فترة وجوده، حيث بدأت حالات الإصابة بالانخفاض إلى 22 إصابة و9 وفيات و24 حالة شفاء بالكامل .وفي شهر مارس 1936 وصل معدل الإصابات إلى 115 إصابة و61 وفاة و89 شفاء، ومنذ ذلك الحين أصبح المعدل في انخفاض مستمر إلى أن توقف مع نهاية عام 1936.
- قصة: صالحة عبيد حسن