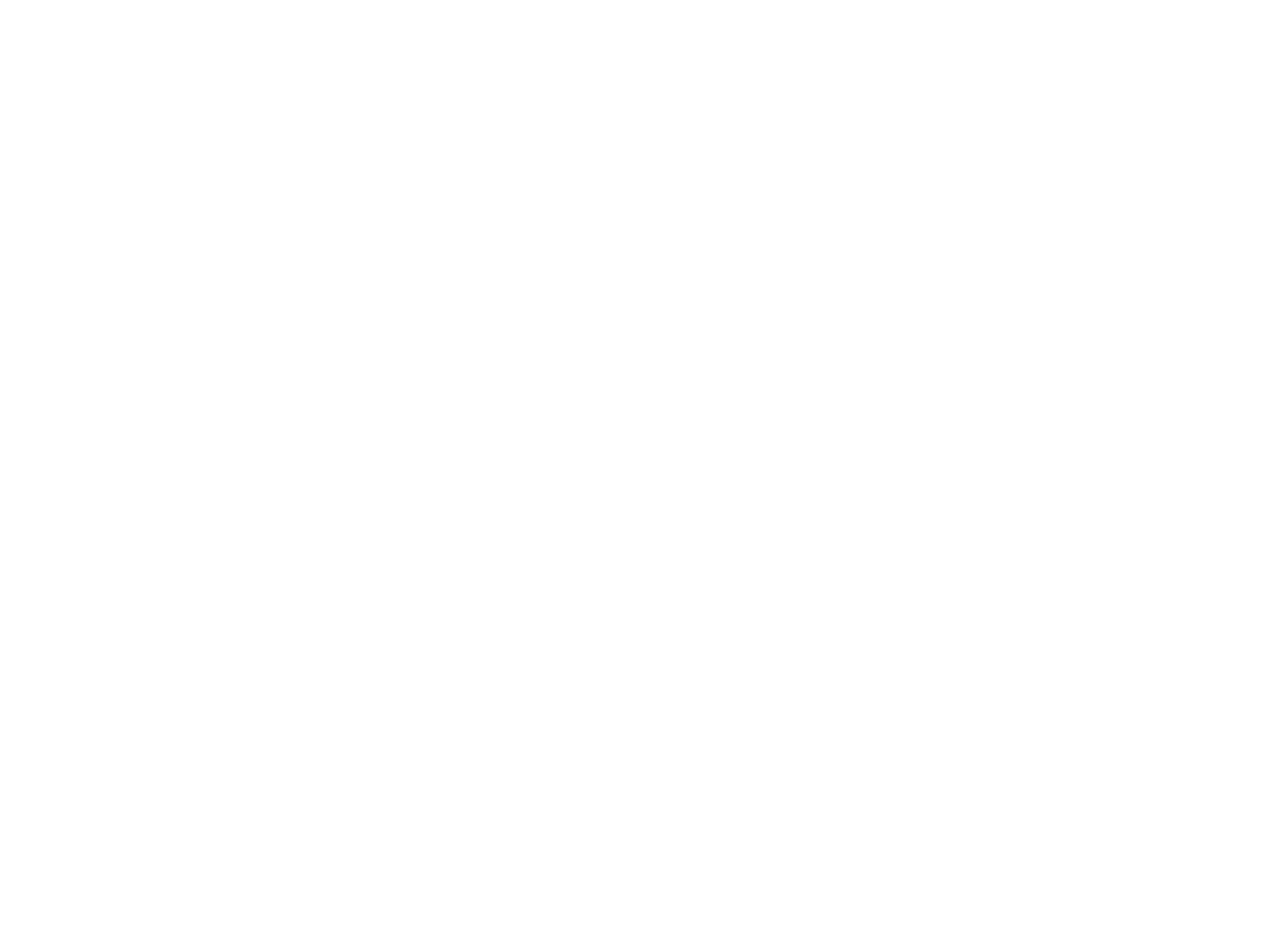بلاغة الصور
بينما أحدثه عن اشتياقي، يرسل صورة، ليس أميًّا، يُجيد لغتين، ولكنه ينأى عن الكلمات، يترك للصور عناء التعبير، مرةً أرسل لي صورة برج إيڤل وهو في فرنسا، فعلمت أنه اشتاق لي بطول هذا البرج، ومرة أخرى أرسل لي صورة نهر المسيسبي الذي زرناه سوياً، فتيقنت أنه اشتاق لي بعمق هذا النهر، ومرةً أرسل لي صورة وجهه باسمًا، فآلمني أن يشتاق لي بهذا التعب. وحين انشغلنا طويلا عن بعضنا، أرسل لي ثلاث عشرة صورة، هكذا دفعة واحدة، خجلت من نفسي، أنا التي تتباهى بالكلمات، لم أرسل له حرفًا واحدًا. وحين زرته في بوسطن، لم نقل شيئًا، ولم أخبره كم كنت أشتاقه، غير أنه أخذني في اليوم التالي إلى متحف، ابتاع تذكرتين، ودلّني على ركن بديع مليء بالصور.
امرأة بطيئة في حادث سريع
انتظرنا هذه السائقة كثيرًا، كنا نخطط لكل الأماكن التي سنذهب إليها، ستوصلنا إلى كل مكان، قد تبعدنا عن هذا الجحيم. حين وصلت كانت تمشي بغرابة، ظنناها في بادئ الأمر خجلة من العائلة الجديدة، كنا نقف عند الباب مثل يتامى، وجدوا أخيرًا، أمًّا تتبنى أحلامهم. ثمة غرابة ما في مشيتها، تجرأنا على التحديق في قدميها، كانت طبيعية، وحذاؤها يبدو مريحًا. بدا لنا كما لو أن عُطلًا في قدميها يجعلها تمشي، ولا تصل. لم تكن تعرج، ولا يبدو على قدميها اليأس، كانت بكل بساطة، بطيئة جدًّا. فهمناها على مضض، تقول إن الناس في بلادها بطيئيون وفي كل شيء. ومن سوء حظها، أن الناس في بلادنا، سريعون جدًّا. يقودون بسرعة، ما يحبب الموت فينا. لأننا لا نأخذ كثيرًا من وقته. أما هم فلا يموتون بسرعة، لأنهم يقودون السيارات كما لو أنهم يمشون على مقابر أحبتهم. الحديث معها مسألة في غاية الطول، فهي تستمع إليك ببطء شديد، ذلك أن حركة في عينيها تجعلك تتمهّل، كما لو أنك في صلاة. وإن أسرعت في حديثك، فلن تطلب منك الإعادة، ولن تحملق بوجهك مثل أبله لم يفهم لغة الآخر؛ إنما ستشعرك بطريقة مريبة، أنك أحمق، وقد خرمت للمروءة. كلماتها كحبة برتقال، تحتاج أن تقشّرها، لتفهمها. غضبها من البطء ما يجعلها تُهدئ نفسها بنفسها، لا يمكن استفزازها بسهولة، فالاستفزاز صفة السرعة. تعد حبيبات الملح وقت الطعام، بالطبع هي لم تخبرني بذلك، ولكن الوقت الذي تقضيه في الأكل يجعلني أؤكد ذلك. بالنسبة إلى وظيفتها كسائقة؛ فهي لم تتعرض لحادث سيارة واحد؛ ذلك أن الطريق نفسه لا يعي وجودها، وإذا ما انتبه إليها فسيظنها سيارة معطلة، تركها صاحبها ومات. أما عند الدوّار فالكل يمر قبلها، لا تجد أي مشكلة في أن تسمح للعالم بالمرور، لا شيء يفوتها، الأوان يمر من عندها ويضجر، يشعر بإهانة فلسفية من تلك الإنسانة، أي بطء؟ أي حكمة؟ أما عن بقائها معنا حتى هذا الوقت فلأنها ذكية، تنطلق لمواعيدنا قبل وقتها بكثير، حتى تصل في الوقت المناسب. تجيد الانتظار، لا تسأم من الانتظار، حتى في خطواتها تستشعر انتظارًا ما. لا تسمّيه انتظارًا، تسمّيه أمورًا لم يحن وقتها بعد. عندما نذوي من انتظار أمي في السيارة، أمي التي تبدد الوقت في مجادلة بائع لأجل خصم لا يتعدى درهمين؛ تجدها تبتسم للفراغ، تشمّ بطءًا مزعجًا، تودّ لو تفتعل مشكلة ما معها، لماذا لا يستفزها الانتظار! لا تظهر عليها اللهفة البشرية حين يتحقق أمر منتظر، فهو بالنسبة إليها مجرد أمر حصل في وقته المناسب. لا شيء فاتها في حياتها سوى شقاء الانتظار. بعد مرور سنة من البطء، الذي اعتدناه، كنت جالسة في غرفتي، أنتظر، لا أعرف ماذا أنتظر، لربما كنت أنتظر حياتي التي لم أحصل عليها يوما. سمعت ركضا غريبا، أعرف صوت خطوات إخوتي، أعرف ارتباك خطواتهم إذا حدث ما يقلق. أما تلك الخطوات، فكانت تركض بوحشية مرعبة، كانت تعوي، تعوي مثل غزالة مزقت الضباع ابنها، فجعلت تركض في العراء لا تجد ربًّا يُطفئ هذه الحرقة. كانت سائقتنا، تنوح وتنطق بكلمات سريعة، كأنها تخرج من عصّارة، فهمت على مضض أن أحدًا مات، كان أباها. أفزعني الخبر وزلزلني، كل موت هو زلزلة للكائن الذي يحلم بالخلود، لكن الذي أفزعني أكثر، هو انسلاخها من بطئها. هذه المرة، أنا من تحدث ببطء، وعانقها ببطء، وبكى ببطء. وهي بسرعة وحشية، تردد اسم الله، وتناجيه، تدور في الصالة، بسرعة مخيفة، أفزعت طمأنينة الجدران. ولأنني الوحيدة التي أدركت ذلك الفزع، فقد استيقظت في اليوم التالي بهدوء، ووضعت قدمي على الأرض، ببطء شديد، ببطء من يمشي على أرض مشبوهة، تحمل في قلبها لغمًا قديمًا.
الرجل الذي تمنيته أبي
كان يتوسط المجلس والجميع من حوله، مأخوذون بعذوبة حديثه. يُضحِكهم جميعًا، في جيبه نكات لكل الأعمار، حتى إن لديه من العبقرية ما يكفي لجعل نكتة واحدة تضحك الجد والحفيد على حد السواء، لم يكن مثيرًا للسخرية، بل إنه فوق ذلك محط احترام الجميع، تريد كتم تنفسّهم ليتسنى لك الاستماع إلى صمته المرهف. ابنته الصغرى في حضنه، كان يمسد على رأسها، بينما بدا وجهها مدهوشًا كما لو أنها تحت هيمنة السحر. في عينيها ضرب من الارتباك الذي يشبه شكًّا مدفونًا، لا غرابة؛ ولديها أبٌ بهذا الحنان. نحن -البشر- تربكنا غزارة أي شيء، ولو كان المطر على أرض صحراوية. الشمس مثلنا كذلك، يربكها الطوفان. فكرت في نفسي، لا بد وأنها لم تعتد حنانه، حنان كهذا لا يعتاده المرء، يريد المزيد منه دائمًا، وإن أربكه. وكنت أؤكد لنفسي أنني لو كنت مكانها لاستطاع -بلا شك- أن يمسح عن رأسي كل أفكاري السوداوية؛ كل مرّات انتحاري، وكل جراحي. تصورت أن لمسة يده على وجهي كفيلة بفهم تخبّطي، يده أيضًا بدت متفهّمة؛ مثل صديق يقرأ في عيني صديقه كل الكلام. عندما يتحدث أحدهم، يصغي إليه باهتمام بالغ، ويُشعره أنه نجم السهرة لهذا الليلة، بالطبع يتحول الجميع إلى نجوم آخر السهرة. سحرني أيضًا، أنا الحانقة على كل الآباء، لم أصدق أنني سأقول لنفسي «لو أن هذا الرجل أبي!» كان يبتسم لي ابتسامة أليفة من شأنها سحق كل الغربة التي تسكنني، ابتسامة كهذه خُلقت لوجه يستحيل أن يمسّه الحنق، الحنق؟ أكاد أجزم أن الحنق يغترب في وجهه، وإن مرّ، فمثل عجَلةٍ في روح مغترب، مارّ بضفة عبور إلى الوطن.
حين عدت إلى المنزل بعد تلك السهرة الرائعة، فكرت به كثيرًا إلى أن أخذني النوم، ولما استيقظت فجرًا، أمرتني أمي بإيقاظ أبي للصلاة، كنت مترددة وخائفة من غضبه الدائم، حاولت إغراء أختي الكبرى، فعرضتُ عليها أن تقوم بالأمر في مقابل أن أجلي الصحون وأعد لها القهوة، إلا أنها لم تجب حتى. لا أحد يحب إثارة غضب أبي الغاضب أصلًا على الدوام. استسلمتُ وتوجهت إلى غرفته، وحين سقط الضوء على عينيه، استيقظ من فوره ورمقني بنظرته الحانقة التي تسكن وجهه، واستغرقتُ دقائق إضافية لأدرك أن ذاك الرجل الذي أعجبت به البارحة، كان أبي.
*نصوص: عبير أحمد
* المصدر: كائن يفترس نفسَه – دائرة الثقافة: الشارقة، 2021م.