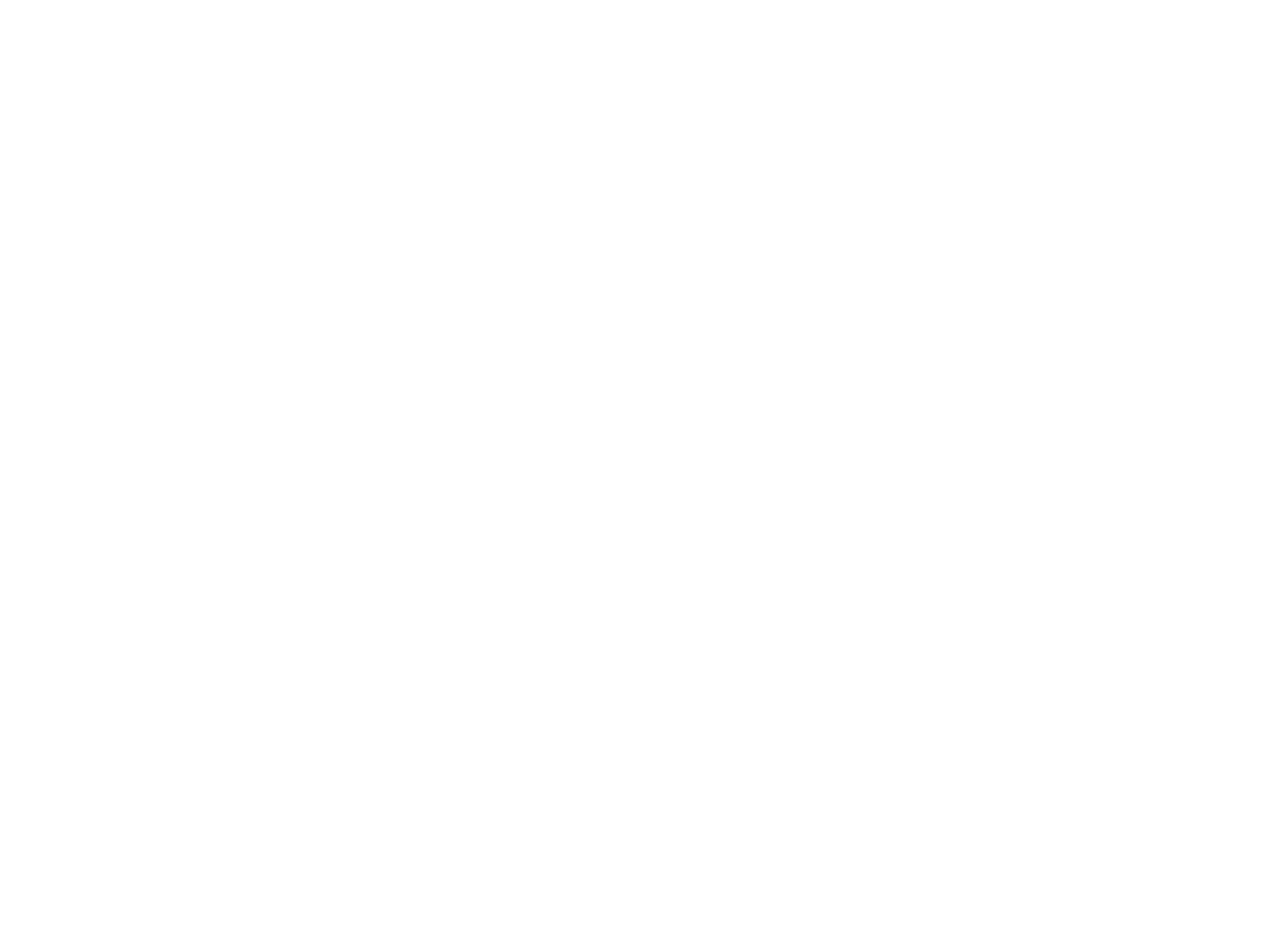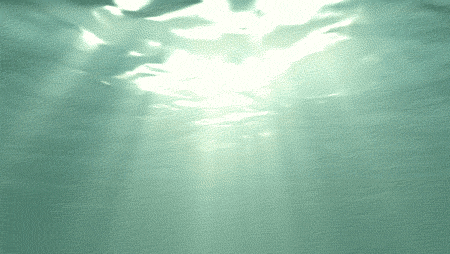المقدمة
يحاكي فن الإنسان الطبيعة، وهي ذلك الفن الذي بموجبه خلق الله الكون ولا يزال يحكمه، في أمور كثيرة من ضمنها أنه قادر على صنع حيوان اصطناعي. فبما أن الحياة ليست الا حركة الأعضاء، حيث تكون بدايتها في عضو داخلي رئيسي، ألا يجوز القول إن لجميع الماكينات (تلك المحركات التي تحرك نفسها بمساعدة النوابض والعجلات، كما هي الحال في ساعة اليد) حياة اصطناعية؟ فما هو القلب ان لم يكن نابضا، والأعصاب ان لم تكن أوتارا، والمفاصل ان لم تكن عجلات تعطي الحركة للجسم كله حسب قصد الفنان (أو الصانع)؟ ولكن الفن يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يحاكي ذلك الكائن العاقل والرائع الذي صنعته الطبيعة، ألا وهو الإنسان. فبالفن يتم خلق ذلك ” التنين ” الذي يسمى ” الدولة ” أو ” المجتمع “ (وباللاتينية civitas). والذي لا يعدو كونه إنسانا اصطناعيا، وان كان أكبر قوة وأعظم شأنا من الإنسان الطبيعي، الذي يهدف إلى حمايته والدفاع عنه. في هذا الكائن، السلطة السيادية هي الروح الاصطناعية التي تعطي الحياة والحركة لكل الجسم، الحكام وبقية موظفي القضاء والتنفيذ هم المفاصل الاصطناعية، العقاب والثواب (اللذان يربطان كل مفصل وعضو بمقعد السلطة السيادية ويحركانه لأداء مهمته) هما الأعصاب، التي تقوم بنفس المهمة في الجسد الطبيعي، الثروة والغنى لجميع الأعضاء هما قوته، أمن الناس هو عمله، المستشارون الذين يزودونه بكل ما يحتاج معرفته هم الذاكرة، العدل والقانون هما العقل والإرادة الاصطناعيان، الوئام هو الصحة، الفتنة هي المرض، والحرب الأهلية هي الموت. وأخيرا، فان العهود والمواثيق، والتي بواسطتها تم في البدء صنع أجزاء هذا الجسم السياسي فانها مجتمعة تشبه ذلك الأمر الإلهي ” ليكن هناك إنسان ” الذي صدر عن الله عند خلق الكون.
ولوصف طبيعة هذا الإنسان الاصطناعي، يتوجب النظر إلى:
أولا: مادته وصانعه، وكلاهما الإنسان.
ثانيا: كيف، وحسب أي مواثيق، يصنع، وما هي الحقوق وما هي السلطة أو الصلاحية العادلة التي يتمتع بها صاحب السيادة، وما الذي يحافظ عليه أو يؤدي إلى انحلاله.
ثالثا: ما هو المجتمع المسيحي؟
وأخيرا: ما هي مملكة الظلام؟
الجزء الأول: عن الإنسان.
ما يشتهيه الناس نقول أيضا إنهم يحبونه، وما ينفر منه الناس، نقول أيضا انهم يكرهونه، ولذا فإن الشهوة (desire) والحب هما شيء واحد، سوى أن الشهوة تدل على غياب الموضوع، بينما يدل الحب عادة على وجوده، وكذا بالنسبة للنفور (aversion) الذي يدل على غياب الموضوع خلافا للكراهية التي تدل على حضوره. ولأن جسم الإنسان في تغير دائم، فمن المحال أن تثير نفس الأشياء دائما نفس مشاعر الشهوة والنفور في الإنسان. ومن المحال أيضا أن يتفق جميع الناس على شهوة نفس الموضوع. ولكن مهما يكن موضوع الشهوة أو الرغبة عند الإنسان، فان هذا الشيء المشتهى يسمى “الخير” بينما يسمى موضوع النفور أو الكراهية “الشر”، وموضوع الاحتقار يسمى “الحقير” أو ” التافه”. وهذه الكلمات (الخير، الشر، الحقير) تكون دائما نسبية إلى الشخص الذي يستعملها، إذ لا يوجد شيء كهذا ببساطة وبصورة مطلقة. كما لا يوجد مقياس مشترك للخير والشر يمكن أن يستمد من طبيعة الأشياء ذاتها. مثل هذا المقياس يمكن أن يستمد فقط من شخص الإنسان (في حالة غياب المجتمع أو الدولة)، أو من الشخص الذي يمثل المجتمع أو الدولة، أو من المحكم أو القاضي الذي يتفق الناس على تعيينه، والذين يحصلون من حكمه قاعدة ومقياسا.
( من الفصل 6)
لا أعني بعبارة “الآداب العامة” (manners) هنا آداب السلوك مثل كيف يتوجب على المرء أن يحيِّي الآخر، أو كيف يتوجب عليه أن يغسل فمه أو ينقب أسنانه أمام الجماعة، أو غيرها من صغائر التصرف اللائق. ولكنني أعني تلك الصفات الإنسانية التي تعنى بعيش الناس سوية في وحدة وسلام. ولهذا الغرض، علينا أن نلفت النظر إلى أن السعادة في هذه الحياة لا تكمن في راحة النفس التي ارتوت. فليس هنالك هدف نهائي (finis ultimus) أو خير أعلى (summum bonum) كما جاء في كتب فلاسفة الأخلاق القدماء، فلا حياة لمن أتت شهواته إلى نهايتها، مثلما لا حياة لمن توقفت حواسه وخياله عن العمل. السعادة هي التقدم الدائم للشهوة من موضوع إلى آخر، حيث يكون الحصول على الأول محطة للوصول إلى التالي. والسبب في ذلك هو أن هدف الشهوة عند الإنسان ليس التمتع مرة واحدة وللحظة واحدة فقط، وإنما التأمين الدائم لطريق الشهوة المستقبلية. ومن هنا فان الميول والأعمال الإدارية لجميع الناس لا تهدف فقط إلى الحصول على، وإنما أيضا إلى تأمين حياة راضية. السبل فقط تختلف، وذلك مرده، جزئيا، إلى اختلاف عواطف الناس، وجزئيا إلى التفاوت في المعرفة وفي الآراء حول السبب الذي يؤدي إلى النتيجة المرغوبة.
وبادئ ذي بدء، فإنني أعتقد بوجود نزعة عامة لدى جميع الناس: شهوة مستمرة لا تهدأ من أجل الحصول على القوة والمزيد من القوة، شهوة لا تتوقف الا في حالة الموت. والسبب في ذلك ليس دائما لأن الإنسان يطمع في لذة أشد قوة مما حصل عليه من قبل، أو لأنه لا يكتفي بالقوة التي في حوزته، ولكن لأنه لا يستطيع تأمين القوة والوسيلة المتوفرتين للعيش الكريم بدون الحصول على قوة إضافية. ولهذا السبب، فإن أكثر الملوك قوة لا يكفون عن بذل الجهود الكبيرة من أجل تأمين القوة داخليا بواسطة القوانين، وخارجيا بواسطة الحروب، ومتى أنجزوا ذلك، تثور شهوة جديدة لديهم، لدى البعض من أجل الشهرة الناجمة عن انتصار (أو احتلال) جديد، أو من أجل الراحة والملذات الحسية، ولدى البعض الآخر، من أجل الحصول على الإعجاب والإطراء وعلى التميز في أحد الفنون أو إحدى القدرات الذهنية.
التنافس على الثروة، الشرف، السيطرة، أو على قوة أخرى، يثير النزعة نحو الخصام والعداء والحرب، وذلك لأن الواحد يحصل على مبتغاه عن طريق قتل أو إخضاع أو قمع أو صد الآخر. وعلى وجه الخصوص، فان التنافس على المديح يثير النزعة نحو احترام القدماء. وذلك لأن الناس يتخاصمون مع الأحياء، وليس مع الأموات الذين يغدق عليهم أكثر مما يستحقون مما يمكن من التعتيم على مجد الأحياء.
الرغبة في الراحة وفي ملذات الحواس تثير في الناس النزعة للانصياع إلى قوة (سلطة) مشتركة. وبسبب هذه الرغبات يتنازل الإنسان عن الحماية التي يأمل في الحصول عليها بجهده وسعيه الذاتيين. الخوف من الموت ومن الإصابات يثير نفس النزعة، وللسبب ذاته. وعلى نقيض ذلك، فان المحتاجين الجسورين الذين لا يقبلون بوضعهم الحالي، وكذلك جميع الناس الذين يطمحون إلى السيطرة العسكرية، ينزعون إلى استدامة أسباب الحرب وإثارة المتاعب والفتن. وذلك لأن الإنسان لا يحصل على الشرف العسكري الا بالحرب ولا أمل له في تحسين حظه في اللعبة الا إذا أعاد خلط الأوراق وتوزيعها.
الرغبة في المعرفة وفي فنون أيام السلم تثير في الناس نزعة الانصياع إلى سلطة مشتركة. وذلك لأن مثل هذه الرغبة تنطوي على رغبة في وقت الفراغ، وتبعا لذلك، على رغبة في الحماية من قِبل قوة غير القوة الذاتية.
(من الفصل 11)
لقد جعلت الطبيعة الناس متساوين في قدراتهم الجسدية والعقلية. وإذا ظهر واضحا للعيان أحيانا أن فلانا أقوى جسدا أو أسرع خاطرا من علان، فإننا إذا عملنا الحساب الإجمالي، نجد أن ليس هناك فرق كبير بين الإنسان والإنسان، فرق كبير يبرر للواحد المطالبة لنفسه بمنافع لا يمكن للآخر أن يطالب بها. وفيما يتعلق بقوة الجسد، فلأضعف الناس قوة تكفي لقتل أقواهم، إما بالحيلة والمكيدة، واما بالتحالف مع الآخرين الواقعين تحت نفس المخاطر.
وأما بشأن القدرات العقلية… فإنني أجد قدرا أكبر من المساواة بين الناس من المساواة في قوة الجسد. فما التعقل (prudence) سوى التجربة التي يكسبها الوقت المتساوي المعطى لجميع الناس بالتساوي في تلك الأمور التي يعطيها الناس قدرا متساويا من الجهد. ان ما قد يجعل مثل هذه المساواة غير قابلة للتصديق هو أن كل واحد تقريبا يميل إلى الغرور الفارغ بحكمته، معتقدا أنها تفوق حكمة الناس العاديين، أي جميع الناس باستثنائه هو وباستثناء القلة التي حظيت بالشهرة أو أولئك الذين تلاقت آراؤهم مع آرائه. فهذه هي طبيعة الإنسان: فكلما اعترف أن الكثيرين يفوقونه من حيث الفصاحة أو التعلم أو البراعة اللفظية، كلما وجد صعوبة في الاعتراف بأن الكثيرين ذوو حكمة مثله. وذلك لأنه يلاحظ عقله عن قرب، بينما عقول الناس الآخرين يلاحظها عن بعد. ولكن هذا يدل على أن الناس متساوون في هذه النقطة، أكثر مما يدل على عدم المساواة، وليست هناك عادة علامة أبرز على التوزيع المتساوي لأي شيء من كون كل شخص راضيا بنصيبه.
من هذه المساواة في القدرة تنشأ مساواة في الأمل في تحقيق الأهداف. ونتيجة لذلك، فإذا رغب شخصان بنفس الشيء ولم يكن بالإمكان أن يتمتع كلاهما به، فانهما يصبحان عدوين. وفي سعيهما من أجل الهدف، والذي هو أساساً الحفاظ على البقاء، وأحيانا البهجة فقط، فان الواحد منهما يحاول تدمير أو إخضاع الآخر. ومن هنا فإذا لم يخشَ الغازي سوى القوة الفردية للآخر، وإذا كان هذا الآخر يزرع ويغرس ويبني ويملك بيتا مناسبا، فمن المتوقع أن يجيء الآخرون موحدي القوة لتجريده من أملاكه وحرمانه ليس فقط من ثمار عمله، وإنما من حياته أو حريته أيضا. وللغازي يكمن خطر مماثل من قبل الآخرين.
وفي طبيعة الإنسان نجد ثلاثة أسباب رئيسية للخصام. الأول: التنافس؛ الثاني: عدم الثقة بالنفس؛ الثالث: المجد.
السبب الأول يجعل الناس يغزون من أجل الكسب؛ الثاني من أجل الأمن؛ والثالث من أجل السمعة الحسنة. في الحالة الأولى يلجأون إلى العنف كي يصبحوا أسيادا على أشخاص الآخرين، زوجاتهم، أولادهم، وقطعانهم. في الحالة الثانية، لكي يدافعوا عنهم. وفي الحالة الثالثة من أجل أمور تافهة مثل كلمة أو ابتسامة أو رأي مختلف أو أي علامة تقليل من قيمة، مباشرة تجاه أشخاصهم أو غير مباشرة تجاه أقربائهم، أصدقائهم، شعوبهم، مهنهم، أو أسمائهم.
ومن هنا يظهر جليا ان طالما يعيش الناس بدون قوة مشتركة ترهبهم جميعا، فانهم يظلون في حالة تسمى حالة الحرب. ومثل هذه الحرب هي حرب كل شخص ضد كل شخص. فالحرب ليست أساسا معركة أو قتالا فقط، وإنما في فترة زمنية تكون خلالها إرادة الناس للقتال معروفة بما فيه الكفاية. ولذلك فان مفهوم الزمن يجب النظر إليه على أنه غير منفصل عن جوهر الحرب، تماما كما أنه غير منفصل عن جوهر الطقس. فكما أن الطقس العاصف لا يكمن في وابل واحد أو وابلين من المطر، وإنما في الميل لهذا لعدة أيام متتالية، كذلك فان حالة الحرب لا تكمن في القتال الفعلي، وإنما في النزعة المعروفة لذلك خلال الوقت الذي لا يوجد فيه ضمان لعكس ذلك، وكل وقت آخر هو سلام.
ونتيجة لذلك، فان كل ما ينتج عن زمن الحرب، حيث يكون كل شخص عدوا لكل شخص، ينتج أيضا عن الزمن الذي يعيش خلاله الناس بدون أمن سوى ذلك الذي تؤمنه وتزوده قواهم ومكائدهــم. وفي وضــع كهــذا، لا مكان للكـــد والاجتهاد لأن ثــــماره غير أكيدة: ونتيجة لذلك، لا فلاحة ولا ملاحة ولا استعمالا للبضائع التي تجلب عن طريق البحر، ولا بنايات مريحة، ولا وسائط لنقل تلك الأشياء التي تحتاج إلى قوة كبيرة، ولا معرفة بسطح الأرض، ولا حساب للزمن، ولا فنون، ولا آداب، ولا مجتمع، والأسوأ من كل هذا، خوف دائم وخطر من الموت العنيف، وحياة الإنسان: وحيدة، فقيرة، قذرة، حيوانية، وقصيرة.
وقد يظن أنه لم يكن هنالك وقت كهذا أو حالة حرب كهذه، وأنا بدوري اعتقد أنه لم يكن على العموم وضع كهذا في العالم بأسره. ولكن هناك أماكن كثيرة حيث يعيش الناس هكذا هذه الأيام. فلا توجد حكومة على الإطلاق لأولئك المتوحشين في أماكن كثيرة في أمريكا (سوى حكم العائلات الصغيرة حيث يعتمد الوئام على الشهوة الطبيعية). وهم يعيشون الآن حسب الطريقة الحيوانية التي تحدثت عنها سابقا. وبالرغم عن ذلك، يمكن ان يتصور المرء كيف يمكن أن يكون شكل الحياة في غياب قوة مشتركة يهابها الناس، إذا نظرنا إلى شكل الحياة التي ينحدر إليها الناس في حالة الحرب الأهلية وذلك بعد أن عاشوا سابقا في ظل حكومة سلمية.
وهناك نتيجة أخرى لهذه الحرب، حرب الكل ضد الكل: لا شيء يمكن أن يكون جائرا. ومفاهيم الصواب والخطأ، العدل والجور، ليس لها مكان هنا. فحيث لا توجد قوة مشتركة لا يوجد قانون، وحيث لا يوجد قانون لا يوجد جور (أو ظلم). العنف والاحتيال في الحرب هما الفضيلتان الرئيسيتان. العدل والجور ليسا من ملكات الجسد أو ملكات الروح. ولو كانا كذلك، لوجدا في الإنسان الواحد والوحيد في العالم، تماما كحواسه وعواطفه. انهما صفتان للإنسان داخل المجتمع، وليس للإنسان المنعزل. ومن نتائج هذا الوضع أيضا عدم وجود ملكية أو تمييز بين ما هو لي وما هو لك، وإنما لكل إنسان ما يستطيع الحصول عليه، وللمدة التي يستطيع المحافظة عليه. إلى هذا الحد من الوضع البائس للإنسان، ذلك الوضع التي أوجدته فيه الطبيعة فعلا، رغم إمكانية الخروج منه، إمكانية تكمن جزئيا بعواطفه، وجزئيا بعقله.
ان العواطف التي تجعل الناس يجنحون نحو السلم هي الخوف من الموت، الرغبة في تلك الأشياء الضرورية للعيش المريح، والأمل في الحصول عليها بالكد والاجتهاد. والعقل يقترح أسسا مناسبة للسلام يمكن ان يتفق الناس عليها. من هذه الأسس، والتي تسمى أيضا قوانين الطبيعة، سوف أتحدث بمزيد من التفصيل في الفصلين التاليين.
(من الفصل 13)
الحق الطبيعي، والذي يسميه الكتّاب باللاتينية (Jus Naturale)، هو حرية كل شخص في استعمال قوته حسب ما يريد لحماية طبيعته، أي حياته الخاصة، وتبعا لذلك، في عمل أي شيء يكون حسب حكمه وتفكيره وسيلة مناسبة لذلك.
الحرية، حسب الدلالة الصحيحة لهذه الكلمة، هي غياب العوائق الخارجية: تلك العوائق التي تعطل أحيانا جزءا من قوة الإنسان لعمل ما يريد، ولكنها لا تستطيع منعه من استعمال القوة المتبقية في حوزته حسب ما يمليه عليه حكمه وعقله.
قانون الطبيعة (Lex Naturalis) هو أمر، قاعدة سلوك عامة، أوجدها العقل لمنع الإنسان من عمل أي شيء يدمر حياته أو يجرده من الوسائل لحمايتها أو يحذف ما يعتقد أنه الأفضل لحمايتها. ولأن المهتمين بالموضوع خلطوا ما بين Jus و Lex، بين الحق والقانون، فمن الضروري التمييز بينهما. الحق هو الحرية في العمل أو الإحجام عن العمل، بينما القانون يلزم الإنسان بواحد منهما. ولهذا فان الحق والقانون يختلفان تماما كاختلاف الواجب والحرية، ويتعارضان في علاقتهما بنفس القضية.
وبما أن حالة الإنسان (كما أعلنا في الفصل السابق) هي حالة حرب الكل ضد الكل، وبما أن كل شخص يتصرف وفق إملاء عقله ويمكنه اللجوء لأي شيء يساعده في الحفاظ على حياته ضد أعدائه، ينتج عن ذلك أن لكل شخص في هذا الوضع حقا في كل شيء، فلا ضمان لأحد (مهما كان قويا أو حكيما) في استنفاذ ذلك القسط من الحياة التي تسمح به الطبيعة عادة لبني البشر. ولذلك، فمن أوامر العقل أو قواعده العامة: “أن على كل شخص أن يسعى نحو السلم طالما ان هناك أملا في ذلك، وإذا تعسر الحصول عليه، يجوز له أن يبحث عن وان يستغل جميع منافع الحرب”. الجزء الأول من هذه القاعدة يشتمل على قانون الطبيعة الأول والأساسي وهو: إسْعَ نحو السلم وابحث عنه. أما الجزء الثاني، وهو اختصار الحق الطبيعي، فهو: الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة.
من هذا القانون الطبيعي الأساسي، والذي يأمر الناس بالسعي نحو السلم، يستمد القانون الثاني: “إن على الإنسان أن يكون مستعدا، إذا كان الآخرون كذلك، والى الحد الذي يعتقد أنه ضروري من أجل السلام ومن أجل الدفاع عن النفس، للتنازل عن هذا الحق في كل شيء، وان يرضى بذلك القدر من الحرية تجاه الآخرين الذي يسمح لهم به تجاهه”. إذ طالما يتمتع كل شخص بهذا الحق في عمل أي شيء يريد، يبقى جميع الناس في حالة حرب. وإذا لم يتنازل الناس الآخرون عن حقهم، كما يتنازل هو، فلا مبرر لأحد بأن يجرد نفسه من حقه، لأنه بهذا يجعل نفسه فريسة (وهو ما لا يجب عمله) بدلا من أن يعد نفسه للسلام. وهذا القانون هو نفسه قانون العهد الجديد: “ما تطلب ان يعمله الناس لك، عليك أن تعمله لهم”.
…عندما يتنازل المرء عن حقه أو يتخلى عنه، يكون ذلك إما بسبب حق عكسي تم التنازل عنه لصالحه، أو بسبب نفع يأمل تحقيقه بواسطة ذلك. لأن ذلك (أي التنازل) عمل إرادي. والأفعال الإرادية للإنسان تهدف إلى تحقيق النفع له. ومن هنا فان هناك حقوقا لا يجوز فهم الإنسان سواء بالكلام أو بالعلامات الأخرى، على أنه تنازل عنها أو تجرد منها. أولا، لا يستطيع المرء أن يتخلى عن حقه في مقاومة من يعتدي عليه بالعنف كي يسلبه حياته، إذ لا يعقل أن يرجو المرء بهذا نفعا لنفسه. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الجروح والقيود والسجن. ليس فقط لأن تحملا كهذا ليس مفيدا له (كالصبر على الألم إذا أصيب أو إذا سجن له صديق) وإنما أيضا لأنه لا يستطيع أن يعرف إذا كان المعتدون يقصدون موته أم لا. وأخيرا، فإن الدافع أو الهدف الذي من أجله تم التنازل أو التخلي عن هذا الحق ليس سوى الأمن على شخص الإنسان في حياته، وفي الوسائل للحفاظ عليها لئلا يضجر منها. ولذلك إذا تظاهر المرء، بالكلمات أو العلامات الأخرى، أنه يسلب نفسه ذلك الهدف الذي من أجله وجدت هذه العلامات، يجب أن يفهم لا على أنه يقصد أو يريد ذلك، وإنما على انه يجهل كيف يمكن أن تفسر تلك الكلمات والأعمال.
والتنازل المتبادل عن الحق هو الذي يسميه الناس “تعاقدا”.
(من الفصل 14)
من ذلك القانون الطبيعي الذي يوجب علينا التنازل عن الحقوق للآخرين، والتي لو تمسكنا بها لوقفنا في طريق سلام الجنس البشري، يتبع قانون طبيعي ثالث هو: “من يوقع عقدا وجب عليه أن يحافظ عليه”. وبدون ذلك تكون العقود عبثا وكلاما فارغا ولأن حق كل شخص في كل شيء يبقى قائما، فاننا لا نزال في حالة حرب.
وقانون الطبيعة هذا هو منبع وأصل كل عدل. فحيث لا توجد اتفاقيات سابقة لا يتم التنازل عن أي حق ولكل إنسان الحق في كل شيء، ولا يعتبر أي عمل عندها جائرا أو ظالما. ولكن إذا عقد اتفاق، فان خرقه يعتبر عملا جائرا. وتعريف الجور (injustice) هو عدم المحافظة على العهود. وكل ما ليس جورا هو عدل.
… وقوانين الطبيعة ثابتة وأبدية. وذلك لأن الظلم، نكران الجميل، الغرور، الكبرياء، الإثم، والإيثار، الخ لا يمكنها أن تكون قانونية. لأن الحرب لا تحافظ على الحياة إطلاقا، ولأن السلام لا يكون مدمرها.
ولان هذه القوانين تستلزم الرغبة والجهد فقط، أقصد الجهد الصادق، فمن المتيسر مراعاتها. ولأنها لا تتطلب سوى الجهد، فمن يحاول جادا المحافظة عليها يمكنه القيام بذلك. ومن يحافظ على القانون يكون عادلا.
(من الفصل 15)
يصبح جمهور من الناس شخصا واحدا (One Person) حين يمثلهم فرد واحد أو شخصية واحدة، بالموافقة الفردية لكل واحد منهم. وذلك لأن وحدة الممثِّل وليس وحدة الممثَّل هي التي تجعل الشخصية واحدة. والممثِّل هو الذي يحمل شخصية، الشخصية الواحدة فقط. ولا معنى للوحدة بالنسبة للجمهور دون ذلك. ولأن الجمهور ليس بطبيعته فردا واحدا وإنما كثرة من الناس، فمن المحال اعتبارهم أصحاب عمل واحد، وإنما هم أصحاب أفعال كثيرة، فيما يتعلق بكل شيء يقوله أو يعمله الممثل بالنيابة عنهم. فكل واحد يمنح الممثل المشترك تخويلا فرديا عن نفسه فقط، وهو نفسه صاحب كل الأفعال التي يقوم بها الممثل، هذا إذا أعطي تخويلا غير مقيد.
[ملاحظة: يعدد هوبس 19 قانونا طبيعيا في هذا الفصل.]
… أما إذا حددوا بأي الأمور والى أي حد يمثلهم، فلا يعتبر أحدهم صاحب عمل أكثر مما فوض على عمله. وإذا كان الممثل يتألف من عدد من الناس، فان صوت العدد الأكبر يجب اعتباره صوتهم جميعا. فإذا صوت العدد الصغير، مثلا، بالإيجاب، بينما صوت العدد الأكبر بالنفي، فهناك عدد كاف من أصوات النفي لنقض عدد أصوات الإيجاب. ولذا فان فائض أصوات النفي التي لا تناقض، هي الصوت الوحيد الذي يملكه الممثل.
(من الفصل 16)
الجزء الثاني: عن المجتمع (Common – Wealth)
إذا كان الناس بطبيعتهم يحبون الحرية والسيطرة على الآخرين، فما هو السبب النهائي أو الغاية أو الهدف من وراء إدخال تلك القيود على أنفسهم (تلك القيود التي يعيشون وفقها في المجتمع أو الدولة)؟ الهدف هو الحفاظ على البقاء وعلى حياة أكثر رضى. هذا يعني إخراج أنفسهم من وضع الحر البائس ذاك، والذي هو النتيجة الضرورية (كما ذكرنا) للعواطف الطبيعية، في غياب قوة مرئية ترهبهم وتفرض عليهم بالخوف من العقاب، المحافظة على العقود ومراعاة تلك القوانين الطبيعية التي تحدثنا عنها في الفصلين الـ 14 و الــ 15.
ولأن قوانين الطبيعة (مثل العدل، الإنصاف، التواضع، الرحمة، وباختصار ان نعمل للناس ما نحب ان يعملوه لنا) بحد ذاتها، وبدون الخوف من قوة تفرض مراعاتها، مناقضة لعواطفنا الطبيعية التي تحملنا على التحيز، الكبرياء، الانتقام، وهكذا. والعقود بدون السيف مجرد كلام فارغ. وليس بمقدورها توفير الأمن للإنسان بتاتا. وبغض النظر عن القوانين الطبيعية (والتي يحافظ عليها من يريد المحافظة عليها فقط إذا تسنى له عمل ذلك في أمان)، فإذا لم تقم قوة كبيرة تكفي من أجل أمننا، فكل شخص يعتمد، وبحق على قوته وحيلته للحذر من كل الناس الآخرين.
إن الطريقة الوحيدة لإقامة قوة مشتركة كهذه، قوة يمكنها الدفاع عن الناس من الغزو الخارجي ومن الأذى الذي يسببه أحدهم للآخر، وتوفير الأمن الذي يمكنهم من العيش المريح من كدهم ومن ثمار الأرض، الطريقة هي، أن يمنحوا كل قوتهم لشخص واحد أو لمجلس من النواب يكون بإمكانه اختزال إرادتهم، عن طريق التصويت بالأغلبية، إلى إرادة واحدة. هذا يعني، تعيين شخص واحد أو مجلس نواب واحد يحمل شخصيتهم، ويعترف كل منهم انه نفسه صاحب كل تلك الأفعال التي يقوم بها أو يتسبب في عملها حامل الشخصية، في تلك الشؤون ذات العلاقة بالسلام والأمن العامين. وبهذا يلغي جميع الناس إرادتهم أمام إرادته وأحكامهم أمام حكمه. وهذا يعتبر أكثر من الاتفاق والوئام، انه وحدتهم الحقيقية في شخص واحد. وحدة نتجت عن اتفاق كل شخص مع كل شخص آخر، وبالشكل الذي يمكن الواحد أن يقول للآخر: أخول هذا الشخص أو ذاك المجلس، وأتنازل له عن حقي في حكم نفسي، وذلك شريطة أن تتنازل عن حقك له وأن تصادق على أعماله مثلي. عندما يتم ذلك، فان الجمهور الذي اتحد في شخص واحد يسمى المجتمع أو الدولة (باللاتينية Civitas). وهذا يخلق “التنين” (Leviathan) الكبير أو، إذا تحدثنا بمزيد من الاحترام، هذا “الإله الفاني” والذي نحن مدينون له، وأمام الإله الخالد، على سلامنا وأمننا. وبناء على هذا التفويض الذي يعطى له من قبل كل شخص في المجتمع، فان عليه استعمال تلك القوة الكبيرة التي منح إياها، والتي يمكنه التلويح بها من صياغة إرادتهم جميعا من اجل السلام في الداخل ومن أجل الدعم المتبادل ضد الأعداء من الخارج. وبه يكمن جوهر الدولة، والتي يمكن تعريفها كالتالي: شخصية واحدة، والتي بناء على الاتفاقيات المتبادلة صادق كل فرد من الجمهور على أعمالها، لكي يتسنى لها استخدام قوتهم ووسائلهم جميعا، وكما تجد ذلك مناسبا من اجل السلام والأمن العامين.
حامل تلك الشخصية يسمى “العاهل” (Sovereign) وهو صاحب السلطة السيادة (Sovereign Power)، وكل فرد آخر غيره “رعية” (Subject).
الحصول على السلطة السيادية يتم بإحدى طريقتين: الأولى، بالقوة الطبيعية، وهذا يحصل عندما يضع شخص أولاده وأحفاده تحت سلطته، وفي حالة رفضهم ذلك يدمرهم، أو عندما يستعبد أعداءه في الحرب مقابل ان يبقي عليهم أحياء. أما الطريقة الثانية: عندما يتفق الناس فيما بينهم، وبإرادتهم الحرة، على الخضوع. الثاني يمكن تسميته المجتمع السياسي أو “المجتمع بالتأسيس”، بينما يسمى الأول مجتمع بالاكتساب (Common-Wealth by Aquisition). سوف أتحدث، في البدء، عن المجتمع بالتأسيس (Common-Wealth by Institution).
(من الفصل 17)
يقال عن مجتمع أنه تأسس عندما يتفق جمهور من الناس ويتعاهدون، كل واحد مع كل واحد آخر، على التالي: بغض النظر عن الشخص أو المجلس الذي يمنح من قبل الجزء الأكبر من الناس حق تمثيل شخصيتهم جميعا (أي أن يكون مثلهم)، فعلى كل واحد منهم، سواء صوت مع أو ضد ذلك، أن يصادق على جميع أفعال وأحكام هذا الشخص أو المجلس، وكأنها أعماله وأحكامه وذلك لكي يعيش المتعاقدون بسلام فيما بينهم وفي حماية من الناس الآخرين.
من هذا التأسيس للمجتمع تستمد جميع الحقوق والصلاحيات الممنوحة لصاحب أو أصحاب السيادة حسب الاتفاق بين المجتمعين.
أولا، بما أنهم يوقعون عقدا، فمن الواجب أن يكون واضحا أنهم غير ملزمين بأي عقد سابق يناقضه. ونتيجة لذلك، إذا أسسوا مجتمعا والتزموا تعاقديا أن يعتبروا أنفسهم أصحاب تلك الأعمال والأحكام التي تصدر عن شخص واحد. فلا يستطيعون قانونيا أن يوقعوا عقدا جديدا فيما بينهم على إطاعة شخص آخر دون إذن منه. ومن هنا، فان رعايا الملك (أو الحاكم الفرد) لا يستطيعون، دون الحصول على إذنه، إلغاء الملكية والعودة إلى فوضى الجمهور الممزق، كما لا يستطيعون تحويل شخصيتهم من ذلك الذي يحملها إلى شخص أو مجلس آخر، وذلك لأنهم ملزمون كل تجاه الآخر، أن يكونوا أصحاب تلك الأعمال التي يقوم بها، أو يرى عملها مناسبا، صاحب السيادة. فإذا عارض أحد، يتوجب على جميع الباقين خرق العقد الذي وقعوه معه، وهذا ظلم (injustice). وبما أن كل واحد قد أعطى السيادة لذلك الفرد الذي يحمل شخصيتهم، فإذا عزلوه، فانهم بهذا يأخذون منه ما هو له، وهذا ظلم أيضا. إضافة إلى ذلك، من يحاول عزل العاهل، وقُتِلَ أو عوقب من قبله على تلك المحاولة، يكون نفسه صاحب ذلك العقاب، لأنه، وبناء على تأسيس المجتمع، يكون صاحب كل ما يعمله العاهل. وبما أنه من الظلم أن يقوم إنسان بأي عمل يعرضه للعقاب بتفويض من نفسه فإنه من هذه الناحية ظالم (unjust). وإذا علل بعض الناس عصيانهم للعاهل بذريعة عقد جديد وقعوه مع الله، وليس مع الناس الآخرين، فان هذا ظلم أيضا، فلا عقد مع الله الا بواسطة إنسان يمثل شخص الله. ولا ممثل لله سوى من يقوم مقامه وله السيادة في الأرض. وهذا الزعم بالتعاقد مع الله هو كذبة مكشوفة (حتى في ضمائر الزاعمين أنفسهم)، وهو ليس عملا ظالما فقط، وإنما أيضا عملا جبانا وحقيرا.
ثانيا، بما أن حق حمل شخصيتهم جميعا قد أعطي لمن جعلوه عاهلا بموجب عقد متبادل بين الناس، وليس بموجب عقد بين العاهل وبين أي منهم، فلا مجال لخرق العقد من جانب العاهل. ولذا فلا يستطيع أحد من رعاياه، وبحجة فقدان السيادة، أن يحرر نفسه من الخضوع. من نصب عاهلا لا يوقع عقدا مسبقا مع رعاياه – وهذا أمر غاية في الوضوح، لأن عليه عندها اما أن يوقع عقدا مع كل الجمهور كطرف واحد أو أن يوقع عقدا منفصلا مع كل شخص. عقد مع الجميع كطرف واحد هو أمر مستحيل، وذلك لأن الناس ليسوا شخصا واحدا بعد، وإذا وقع عقودا منفصلة مع كل واحد من الناس، تكون هذه العقود لاغية بعد أن يصبح عاهلا. وذلك لأن أي عمل يزعم أحدهم أن فيه خرقا، هو عمله وعمل البقية، نظرا لصدوره عن شخص، وبناء على حق كل منهم… إن الرأي القائل بأن أي ملك (أو حاكم فرد) يحصل على سلطته بواسطة العقد، أي بناء على شروط، مصدره سوء فهم لحقيقة بسيطة وهي: ان العقود مجرد كلمات ليست لها قوة إلزام أو كبح أو تقييد أو حماية أي إنسان، سوى تلك القوة المستمدة من السياق العام، أي من الأيدي غير المقيدة لذلك الشخص أو المجلس الذي له السيادة والمعترف بأفعاله من قبل الجميع، تلك الأفعال التي تنفذ بقوة الجميع متحدة بشخصه…
ثالثا: بما أن الأغلبية، بأصواتها الموافقة، أعلنت عن قيام العاهل، فعلى من كان معارضا من قبل أن يوافق الآن مع البقية، أي أن يعترف بجميع أعمال العاهل، والا استحق التدمير من قبل الآخرين. فإذا انضم شخص إلى جمع محتشد من الناس، فانه بهذا يعلن بما فيه الكفاية عن رغبته، وكأنه عقد اتفاقا ضمنيا، في الموافقة على ما تقرره الأغلبية. وإذا رفض الموافقة على ذلك أو احتج على أحد قرارات الأغلبية، فإن عمله هذا يكون مناقضا للعقد الذي وقعه، ويكون بالتالي عملا ظالما. سواء كان حاضرا في الحشد المجتمع أم لم يكن، وسواء طلبت موافقته أم لم تطلب، فان عليه الخضوع لقراراتهم، والا بقي في حالة الحرب التي كان فيها سابقا، حيث يجوز لأي شخص القضاء عليه دون أن يكون ظالما بحقه.
رابعا، بما أن كل رعية حسب هذا التأسيس (للمجتمع) يُعْتَبَرُ صاحب كل أعمال وأحكام العاهل، ينتج عن هذا أن أيا من أعمال العاهل لا ينطوي على إلحاق أي ضرر بأي من رعاياه، ولا يجوز لأي منهم اتهامه بالظلم. وذلك لأن من يقوم بعمل شيء بناء على تفويض من الآخر لا يلحق الضرر بمن عمل حسب تفويض منه. وبناء على هذا التأسيس للمجتمع، فان كل فرد يصادق على كل أفعال العاهل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من يتذمر من أي ضرر يسببه العاهل هو كمن يتذمر من عمل هو بمثابة صاحبه. ولكن لا يجوز أن يتهم نفسه بالضرر، لأنه من غير الممكن أن يضر الواحد نفسه. صحيح أن من يملك السلطة السيادية قد يرتكب بعض الشرور، ولكنه لا يسبب ظلما أو ضررا بالمعنى الدقيق.
خامسا، وبناء على ما قيل أخيرا، فلا يمكن عدلا إعدام صاحب السلطة السيادية على يد أي من رعاياه أو معاقبته بأي شكل من الأشكال. فبما أن كل رعية هو صاحب كل أعمال العاهل، فان من يعاقبه هو كمن يعاقب غيره على أعمال قام بها هو نفسه.
وبما أن الغاية من هذا التأسيس (للمجتمع) هو السلام والأمن للناس جميعا، وبما أن من له الحق في الغاية له أيضا الحق في الوسائل لتحقيقها، فمن حق صاحب السيادة، فردا كان أم مجلسا، أن يحكم بشأن الوسائل اللازمة للسلام والأمن وكذلك بشأن العوائق والعراقيل في وجههما، وان يعمل ما يعتقده ضروريا من أجل الحفاظ على السلام والأمن بواسطة منع الصراعات الداخلية والاعتداءات الخارجية، وكذلك من أجل إعادة السلام والأمن عند فقدانهما.
سادسا، فمن الصلاحيات الملحقة بالعاهل أن يكون قاضيا بشأن الآراء والمذاهب المعادية للسلم وتلك التي تؤدي إليه، وتبعا لذلك، بشأن مَن من الناس يمكن الوثوق به للتحدث إلى الجماهير، وفي أي المناسبات والى أي حد، وكذلك بشأن من يقوم بفحص المذاهب (والنظريات) في جميع الكتب قبل نشرها. وذلك لأن أعمال الناس تصدر عن أفكارهم، وفي حسن حكم الأفكار يكمن حسن حكم أعمال الناس من أجل السلام والوئام. ومع انه فيما يختص بالأفكار والعقائد يجب مراعاة الحقيقة فقط، الا أن ذلك لا يتعارض مع كون الحقيقة موجهة نحو السلام. فالنظرية المعارضة للسلام لا يمكنها أن تكون صحيحة، تماما كما لا يمكن للسلام والوئام ان يتعارضا مع قانون الطبيعة… ومن هنا فمن مصلحة العاهل أن يكون قاضيا، أو ان يعين القضاة، للبت في الأفكار والعقائد، لضرورة ذلك من أجل السلام ومنع الخصام والحرب الأهلية.
سابعا، ومن الصلاحيات الملازمة للسيادة الصلاحية الكاملة في تحديد الأحكام التي على أساسها يستطيع كل فرد أن يعرف ما هي الأشياء التي يمكنه التمتع بها وما هي الأعمال التي يمكنه القيام بها دون مضايقة من قبل بقية الرعايا. وهذا ما يسميه الناس “ملكية”. فقبل تأسيس السلطة السيادية (وكما بينا سابقا) كان لجميع الناس الحق في كل شيء، مما يؤدي ضرورة إلى الحرب. وبما أن هذه الملكية ضرورية للسلام، وبما أنها تعتمد على سلطة سيادية، فإنها من أعمال تلك السلطة السيادية من أجل السلام العام…
ثامنا، ومن الحقوق الملازمة للسيادة الحق في القضاء، هذا يعني في الاستماع إلى والبت في الخلافات التي قد تنشأ حول القانون، المدني منه أو الطبيعي، أو حول الوقائع فبدون البت في الخلافات لا حماية للناس من الضرر الذي يلحقه الواحد بالآخر، وتكون القوانين المتعلقة بما هو لي وما هو لك فارغة…
تاسعا، ومن الحقوق الملازمة للسيادة الحق في صنع السلام أو الحرب مع الأمم والمجتمعات الأخرى. هذا يعني، الحكم متى يكون الأمر في مصلحة الجمهور، وما هو حجم القوة اللازم تجميعها وتسليحها ودفع أجرها من أجل ذاك الهدف، وفرض الضرائب على الرعايا لتغطية النفقات التي يتطلبها ذلك…
عاشرا، ومن الصلاحيات الملازمة للسيادة اختيار المستشارين، الوزراء، القضاة والضباط، في زمن الحرب كما في زمن السلم. فبما أن من مهمة العاهل الحرص على الهدف، وهو السلام والأمن العامين، فمن الواضح أن له صلاحية استخدام تلك الوسائل التي يعتقد أنها مناسبة للقيام بواجبه.
وقد يقول قائل هنا بإن حالة الناس بائسة جدا لأنها عرضة للشهوات والانفعالات الاعتباطية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص الذين بأيديهم سلطة غير محدودة بهذا الشكل. وعلى العموم، فمن يعيش تحت حكم ملكي يظن أن هذا من نقائض الملكية (أو حكم الفرد)، ومن يخضع لنظام حكم ديمقراطي، أو لمجلس نواب سيادي، ينسب جميع المتاعب إلى هذا الشكل من المجتمع. ولكن الحكم، على جميع أشكاله، إذا كانت بدرجة من الكمال تكفي لحماية الناس، هو نفس الشيء. ويجب ألا ننسى أن حالة الناس لا يمكنها أن تكون بدون إزعاج من هذا النوع أو ذاك، وان أكبر المضايقات التي تحدث للناس عموما تحت أي من أشكال الحكم تكاد تكون غير محسوسة بالمقارنة مع الآلام والكوارث الهائلة التي ترافق الحرب الأهلية، أو حتى بالمقارنة مع الوضع الفاجر بدون حاكم، بدون الخضوع للقوانين وبدون سلطة الإرغام التي تقيد الناس وتمنعهم من السلب والانتقام. وكذلك يجب ألا ننسى أن معظم الضغط الذي يمارس على الناس من قبل حكامهم السياديين لا ينبع عن لذة أو منفعة يتوقعها الحكام من إلحاق الضرر بالرعايا أو إضعافهم (فقوة الناس هي أساس قوة ومجد الحكام)، وإنما من تهاون الناس في الإسهام في الدفاع عن أنفسهم، مما يضطر الحكام أن يأخذوا منهم ما أمكن في أيام السلم لتوفير الوسائل لمقاومة الأعداء وإخضاعهم في الحالات الاستثنائية ووقت الحاجة الطارئة.
(من الفصل 18)
المجتمع بالاكتساب (Common-Wealth by Acquisition) هو ذلك المجتمع الذي يتم فيه الحصول على السلطة في حالة بالعنف. ويتم الحصول عليها بالعنف حين يصادق الناس، فرادى أو جماعات، بأغلبية الأصوات، وبسبب الخوف من الموت أو الأغلال، على جميع أفعال ذلك الشخص أو المجلس الذي بين يديه حياتهم وحرياتهم.
السيطرة أو السيادة من هذا النوع تختلف عن السيادة بالتأسيس (Sovereignty by institution) في شيء واحد فقط: الناس الذين يختارون عاهلهم، يفعلون ذلك لأنهم يخافون من بعضهم البعض، وليس لأنهم يخافون من ذلك الشخص الذي ينصبونه عاهلا. ولكن في هذه الحالة فانهم يخضعون أنفسهم لذلك الشخص الذي يخافونه. وفي كلتا الحالتين، يفعل الناس ذلك بسبب الخوف، ولهذا الأمر يجب أن ينتبه أولئك الذين يعتقدون أن عقدا مصدره الخوف من الموت أو العنف يعتبر باطلا، فلو كان هذا صحيحا، لما أمكن إلزام أي شخص، في أي نوع من المجتمعات، بالطاعة.
ولكن الحقوق ونتائج السيادة هي ذاتها في الحالتين: بدون موافقة العاهل، لا يجوز نقل سلطته إلى غيره، ولا يمكنه فقدانها. ولا يستطيع أي من رعاياه أن يتهمه بإلحاق الضرر. ولا تجوز معاقبته من قبل الناس. وهو الحاكم بشأن ما هو ضروري من أجل السلام. وهو الذي يحكم بشأن العقائد والنظريات. وهو المشرع الوحيد، وهو القضاة، المستشارون، القادة العسكريون، الوزراء، وبقية الضباط والموظفون، وله الحق في تحديد العقاب والثواب وكل المراتب ودرجات الشرف. الأسباب لهذا هي نفسها المذكورة في الفصل السابق بشأن حقوق ونتائج السيادة بالتأسيس.
يبدو واضحا إذن، بموجب العقل أو الكتاب المقدس، ان السلطة السيادية، سواء كانت في يد شخص واحد كما في الملكية، أو في يد مجلس واحد كما في المجتمع الشعبي أو الأرستقراطي، هي من العظمة بقدر ما يستطيع المرء ان يتصور. وإذا كان يتهيأ للناس أن سلطة غير محدودة بهذا الشكل تؤدي إلى نتائج شريرة، الا ان نتائج غياب سلطة كهذه، والذي يعني حربا دائمة بين الإنسان وجاره، أسوأ من ذلك بكثير. ان حالة الناس في هذه الدنيا لن تكون بدون متاعب، ولكن أكبر المتاعب في أي مجتمع تنشأ عن عصيان الرعايا وخرقهم لتلك العقود التي تكمن في صميم المجتمع. وكل من يظن أن السلطة السيادية أوسع مما يجب، ويسعى إلى الحد منها، يكون عليه الخضوع لسلطة تستطيع تقييدها، أي لسلطة أوسع منها.
(من الفصل 20)
القوانين المدنية (Civil Laws) هي تلك القوانين التي يتوجب على الناس مراعاتها لأنهم أعضاء، ليس بهذا المجتمع أو ذاك، وإنما في أي مجتمع كان. وذلك لأن معرفة القوانين الخاصة هي من اختصاص أولئك المنهمكين في دراسة قوانين بلادهم المختلفة. ولكن معرفة القانون المدني بشكل عام هي من شأن كل إنسان. القانون الروماني القديم يسمى “القانون المدني” (Lex Civilis)، مشتق من كلمة (Civilas) والتي تعني المجتمع. وتلك البلدان التي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية والتي كانت تحكم حسب ذلك القانون، ما زالت تحتفظ بذلك الجزء منه الذي تعتبره مناسبا. تلك البلدان تسمي ذلك الجزء “القانون المدني” للتمييز بينه وبين بقية القوانين المدنية الأخرى…
ومن الواضح أولا ان القانون عموما ليس مشورة وإنما أمر، ليس أمرا يصدره أي شخص لأي شخص آخر، وإنما أمر يصدر عن الشخص الذي يوجهه إلى شخص آخر سبق والتزم بإطاعته اما حسب القانون المدني فيضاف اسم الآمر فقط والذي هو (persona civitatis) شخصية المجتمع.
وبناء على ما قيل أعلاه، فإنني أعرّف القانون المدني على النحو التالي: بالنسبة للرعية هو تلك القواعد والأحكام (Rules) التي يأمره المجتمع، شفاهة أو كتابة أو بأية علامة أخرى تدل على الإدارة، باستعمالها للتمييز بين ما هو مناف وغير مناف للقاعدة أو الحكم.
لا شيء في هذا التعريف يشوبه أي غموض. فكل شخص يعرف أن بعض القوانين موجهة إلى جميع الرعايا بعامة، بعضها الآخر إلى أقاليم معينة، بعضها إلى مهن معينة، وبعضها إلى جماعات معينة من الناس. ولذا فهي قوانين لمن هي موجهة إليهم، وليس لأي شخص آخر. وأيضا: القوانين هي الأحكام التي تحدد العادل والظالم. فلا شيء يعتبر ظالما إذا لم يكن منافيا لقانون معين.
ولا أحد يستطيع سَن القوانين غير المجتمع، وذلك لأننا خاضعون كرعايا للمجتمع فقط. كما أنه يجب الإعلان عن الأوامر بعلامات كافية والا فلا يعرف المرء كيف يطيعها. وتبعا لذلك، فان كل ما يمكن استنتاجه بالضرورة من هذا التعريف يجب الإقرار على أنه حقيقة. والآن استنتج منه ما يلي:
أ) ان المشرع في أي مجتمع هو العاهل فقط، سواء كان شخصا واحدا كما في الملكية أو مجلسا كما في الديمقراطية والأرستقراطية. المشرع هو الذي يسن القانون، والمجتمع هو الذي يأمر بمراعاة تلك الأحكام التي نسميها قانونا. ومن هنا فإن المجتمع هو المشرع. ولكن المجتمع ليس شخصا وليس في وسعه عمل أي شيء الا من خلال ممثله (أي العاهل). ولذلك فالعاهل هو المشرع الوحيد. وللسبب ذاته، فلا يستطيع أحد إلغاء قانون سوى العاهل. فلا يلغي القانون الا قانون آخر يحرم تنفيذه.
ب) العاهل في المجتمع، شخصا واحدا كان أم مجلسا، غير خاضع للقوانين المدنية، فبما أن لديه صلاحية سن القوانين وإلغائها، فانه يستطيع إذا أراد التحرر من الخضوع بواسطة إلغاء تلك القوانين التي تزعجه وسن قوانين جديدة. ولذلك، فهو متحرر من قبل. والحر هو من يستطيع أن يكون حرا متى شاء. كما أنه من المحال أن يكون الشخص ملزما تجاه نفسه، لأن ذلك الذي يلزم يمكنه أن يحرر من الالتزام. ولذا فان الملتزم تجاه نفسه فقط، لا يعتبر ملزما على الإطلاق.
ج) القانون الطبيعي والقانون المدني يشمل أحدهما على الآخر، ولهما نطاق متساو. فقوانين الطبيعة، والتي هي في أساسها الإنصاف والعدل والعرفان بالجميل وبقـــية الفضائل الأخلاقية التي تعتمد عـــليها في الحالة الطبيعية (كما قـــــلت في نهاية الفصل 15) ليست قوانين بالمعنى الدقيق، وإنما صفات تهيئ الناس للسلام والطاعة. حين يتأسس المجتمع فقط، وليس قبل ذلك، تصبح قوانين فعلية، حيث تصبح عندها أوامر المجتمع، وتبعا لذلك قوانين مدنية أيضا. وذلك لأن السلطة السيادية هي التي تلزم الناس بإطاعتها… القانون المدني والقانون الطبيعي ليسا نوعين مختلفين وإنما جزءان مختلفان للقانون: جزء مكتوب يسمى “مدني” وجزء غير مكتوب يسمى “طبيعي”. ولكن الحق الطبيعي، أي الحرية الطبيعية للإنسان، قد تكون مقيدة ومختصرة من قبل القانون المدني. ان الهدف من سن القوانين ليس سوى تلك القيود التي بدونها لا يمكن للسلام أن يسود. ولم يجلب القانون إلى العالم الا لتقييد الحرية الطبيعية للأفراد، وبالشكل الذي يضمن عدم إيذاء بعضهم البعض، والمساعدة المتبادلة والاتحاد ضد عدو مشترك.
(من الفصل 26)
رأي رابع مناقض لطبيعة المجتمع يقول: “صاحب السلطة السيادية خاضع للقوانين المدنية”. صحيح أن كل عاهل خاضع لقوانين الطبيعة لكون تلك القوانين مقدسة (إلهية) ولا يجوز إلغاؤها من قبل أي شخص أو أي مجتمع. ولكن القوانين التي يسنها العاهل نفسه، أي تلك التي يسنها المجتمع، فهو غير خاضع لها. فالخضوع للقوانين معناه الخضوع للمجتمع، أي لممثله السيادي، أي لذاته. وهذا ليس خضوعا وإنما حرية من القوانين. ان هذا الخطأ، ولأنه يصنع القوانين فوق العاهل، يصنع قاضيا فوقه أيضا، وسلطة لمعاقبته، وهذا يعني عاهلا جديدا، ولنفس السبب، عاهلا ثالثا لمعاقبة الثاني، وهكذا إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى والى انحلال المجتمع.
ترجمة د. سعيد زيداني.
توماس هوبز كان عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي يعد توماس هوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني.