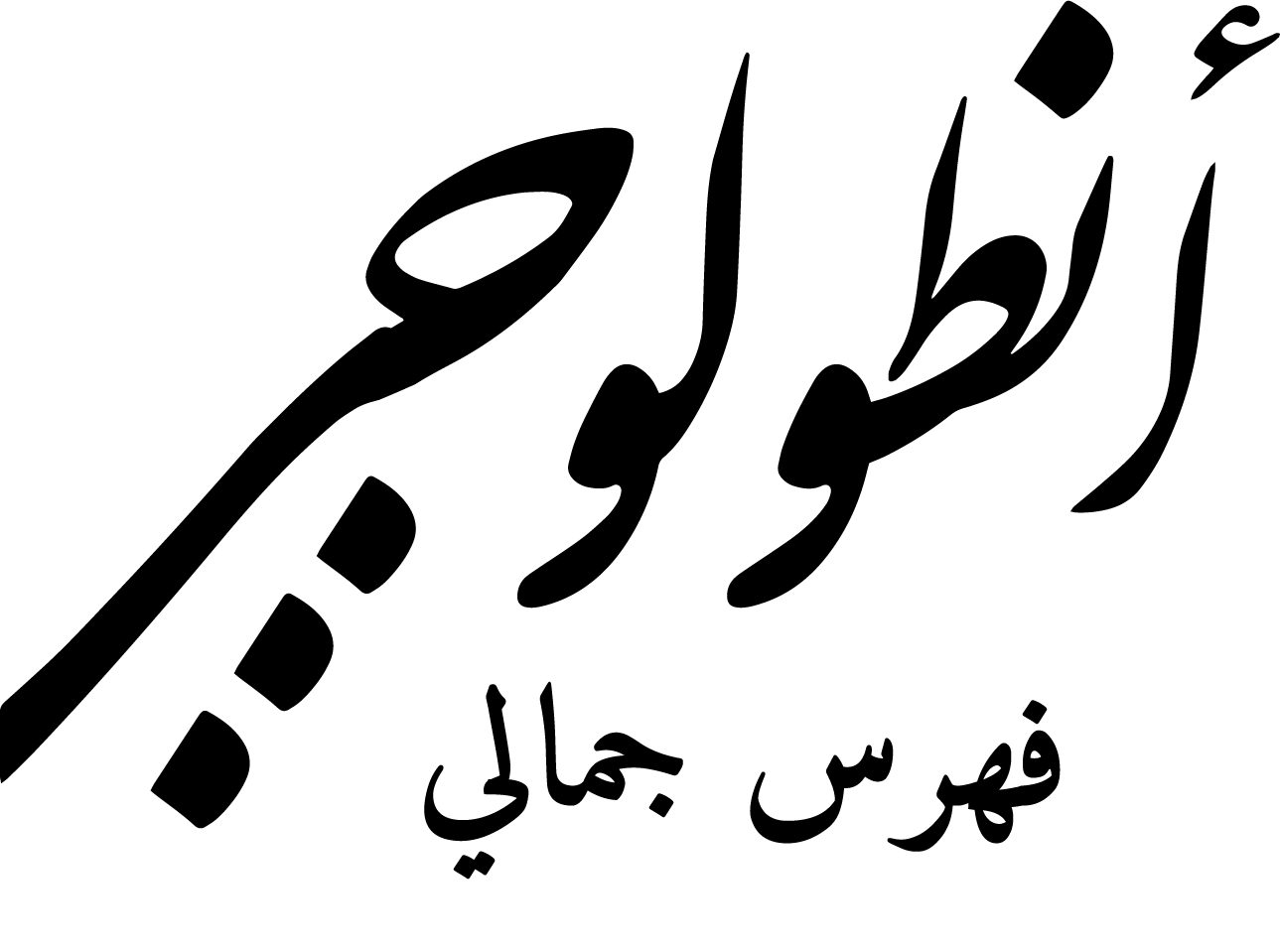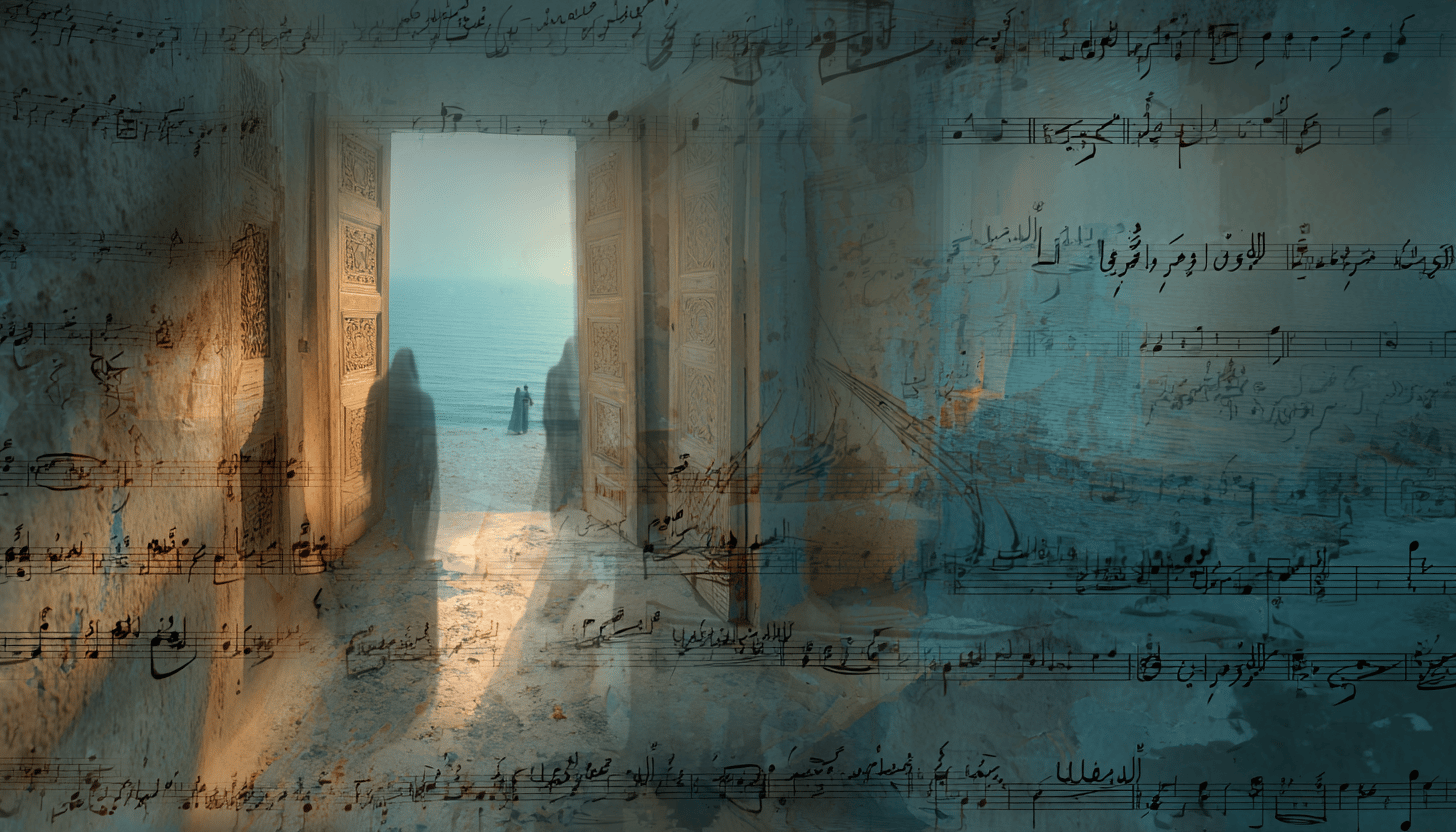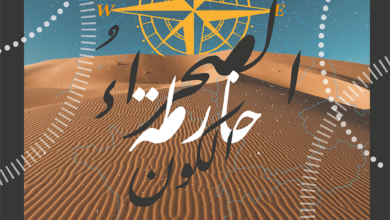قراءة في رواية: إلا جدتك كانت تغني، للروائية الإماراتية صالحة عبيد حسن
في رواية” إلا جدتك كانت تغني “تُطرحُ فكرة وعينا بحضور الغائبين أو بعبارة أخرى خلودهم في الذاكرة، التوق للخلود كرغبة وجودية أصيلة تلح علينا تبرز معالمها من خلال سلسلة من حكاياتٍ تتقاطعُ جميعُها في مجال واحدٍ هو علاقة الإنسان بالمكان ورغبته في الخلود، كلُّ الشخصيات المحورية في الرواية حملت بداخلها جذوة القلق الذي كان يحرضها على ترك أثرٍ ما تَخلُدُ به، فتناسلت الحكايات من جيلٍ إلى جيل منحدرة ًمن رحم الحكاية الأم: حكاية الجدة التي كانت تغني.

تمهدُ صالحة عبيد لروايتها بعبارة لبورخس تُبرز مفهوماً جوهرياً تنهض عليه الرواية : ( الموسيقى ذلك الشكل الغريب للزمن ) وهو بالضبط ما فعلتهُ الكاتبة في روايتها حيث كانت الموسيقى هي الإطار الذي قدمت لنا من خلاله تصوراً عن دبي منذ السبعينات وحتى الألفية وهو تصور قائم كلياً على الذاكرة الغنائية للمدينة وعلى الصوت وتحولاته بداية من النهمة الصوت الأكثر رسوخاً في ذاكرة دبي لإرتباطه بحياةٍ كان للبحر فيها سطوة كبرى كمحور تدور حوله التجارة و العمل وحياة كثير من العوائل قبل أن يتراجع دوره إثرَ مزاحمة الحوائط الإسمنتيّة له وتحوله إلى خلفية تاريخيّة للمدينة مروراً بالغناء الشعبي في الأعراس بنماذجه المختلفة ثم الأغاني المحلية فنمرعلى مراحل تطور الأغنية الإماراتية وأبرز الأصوات التي شكّلت ذاكرة الفن الإماراتي .حيث رصدت الكاتبة عبر السرد امتزاجَ الموسيقى بالحياة من خلال مراحل التطور الغنائي ومواكبته للتحولات المجتمعية في دبي .
ولأن الأغنية هي الأقدر على الخلود فقد كانت الوسيلة التي من خلالها تُبَثُّ الحياة مجدداً في جسد الذكريات؛ إذ تتوفرُ في الصوت إمكانيةُ الاسترجاع والتكرار وتجدد الحدوث على الدوام مما يُبقي الذكريات حيّةً متجددة. فمتى يَصدُرُ الصوت تنبعث الذاكرة.. الصوتُ خالدٌ.. يحضر فتحضر الذكرى. ومن هنا فالرواية ليست إلا فعلَ إحياءٍ لذاكرة المكان من خلال تتبعِ حكايات ساكنيه التي صدحوا بها في حياتهم وبقيتْ عالقة في تفاصيل ِالأمكنة بعد رحيلهم.
تبدأ الرواية في بيت من بيوت الثمانينات الميلادية في دبي ، حيث تعود الحفيدة للبيت القديم مستودع الذكريات لتبحث فيه عن صورة لوالدتها .و لكن البحث يقودها لاكتشاف ذاكرة أكبر وأعمق من حدود الصورة حين تستشعر حضوراً أثيرياً يربطها بصوت شاهين الغائب الحاضر وتبدأ بينها وبين صوته علاقة تمتد لتكشف ماضي ذلك البيت ،تنساق خلف الصوت من أجل استحضار ذاكرة المكان وتعود بالقارئ لجذور الحكاية وهنا تتوطد علاقتها أكثر بالمنزل القديم وقصصه ويصبح المكان بما يضخّهُ من ذكريات إرثاً لا تريدُ له أن يندثر وذاكرة ًخاصة بها يتداخل فيها أكثر من ماضٍ و أكثر من صوت تنتمي له وينتمي لها ، لذلك يدفعها الشغف والفضول لتمضي في تتبعِ أجزاء حكاية شاهين التي تبدأ من دبي وتقودها إلى جدة وبودابست. ومن هنا أُتيحَ للكاتبة أن تتعمق في طرح الجوانب الفلسفية العميقة التي تجمع بين الذاكرة والمكان والصوت وتنويعاتها التي تربط بين ذاكرة الإنسان الخاصة وبين الأمكنة التي تُبعثِرُهُ مُأَرقاً وساعياً في فسحة العمر القصير أن يترك وراءه شاهداً ينقذه من الفناء. فكان شاهين هو الصوت / الأثر الذي يتردد من عمق ذاكرة المكان ذلك أن صوته هو وسيلة حضوره الدائم المتجدد ما يضمن خلوده في الذاكرة، عن هذا التجسد للغائب من خلال استرجاع الأثر ( الصوت) ، إنه ذاتُ المبدأ المُكَوِّن لشخصية شاهين منذ طفولته واستمر حتى بعد موته بتجسّده ذاكرةً لا تتجلى إلا من خلال الصوت الذي يروي الحكاية.
والحقيقة أن الرواية لا تحتفي فقط بالموسيقى بل تذهب الكاتبة عميقاً في رصد مآلات حاسة السمع بأبعادها الواسعة وتأثير الصوت على الروح و الجسد من ذلك التراتيل و التلاوة على مقامات مختلفة و الطواف كفعل جسدي يسير على إيقاع الذِكر والتسبيح بل وحتى الموسيقى الكونية في الطبيعة ، فكل ما يُسمَعُ ويلامس الروح ينتجُ عنه ردُّ فعلٍ جسديٍ يعكس ذلك الشعور ،من هنا تأتي استجابة الجسد لأثر الإيقاع في الروح ، وهو ما جسدته الشخصيات في الرواية لاسيما شاهين أكثرالشخصيات تشبعاً بالإرث الفني لعائلته ، العائلة الممتزجة بالنغم والإيقاع والتي اختلفت عن غيرها من شخصيات المجتمع لكونها شخصيات مُرهفة وقلقة وحساسة ، تخضع لرهافة النغم وتستجيب له روحياً وجسدياً : ( المرونة التي تحرَكَ بها جسده جعلتني أشعرُ بأنني أستطيع أن أرى روحه صافية خلابة لا يحدها تصلّب الجسد وماديته) نرى بذلك أن الخفة التي يفرضها الغناء على الروح تجعلها تسمو على القيد بل وتتخطاه في أغلب الأحيان، سواء أكان قيد المجتمع أم الجسد الذي يتخفف و يتحرر من ثقله وماديته بالتمايل و الرقص وكلاهما -الغناء والرقص- مما ينكره المجتمع رغم انصياعه الفطري له، لذلك كانت الجدة عذيجة -تماماً كما يشير لها عنوان الرواية- استثناءً عن محيطها ( إلا جدتك كانت تغني)، فالرواية إذاً احتفاءٌ بسلسلة من الشخصيات التي شَكَّلَتْ استثناءً عن السائد والمألوف في محيطها على توالي الأجيال ، فمروان كان مختلفاً حين فضّل العمل كنوخذة في زمن هُجرت فيه تلك المهنة وكان مختلفاً حتى في رحلته إلى الحج التي خرج إليها منجذباً للصوت والإيقاع وعاد منها بمخزونٍ موسيقيٍ كبير، وزليخة كانت استثناءً بزواجها وهي “ابنة الطقاقة ” من ابن عائلة العابر الوجيه والتاجر الذي وجد فيها اختلافاً يجذبه في حين بقيت هي في أعين المجتمع نكرة و مرفوضة ، ونورة أيضاً مثّلت استثناء كونها تعرف الكتابة في مجتمع يعمه الجهل وبنظرتها العميقة لما وراء الوجوه و الأشياء حولها لاسيما إدراكها العميق لفكرة العمر و الموت ما أسبغ عليها سمة الغموض ، وتتجلى الفكرة بتركيز أكبر في شخصية شاهين الذي تشربت روحه هذا الإرث الفني وراكم العذوبة في صوته منذ نشأ في كنف جدته شغوفاً بالغناء والرقص في وسط يعتبر ذلك عاراً ونقيصه وإساءة لتاريخ عائلته العريقة.
وقد مثّل إنكار قيمة الموسيقى والغناء موطن الصراع الرئيسي في الرواية إذ أن المُغنّية كما جاء على لسان زليخة: ( ضرورية ووضيعة في الوقت ذاته ..فالجميع يريد المغنية في الأفراح ولا أحد يذكرها فيما عدا ذلك، هي دائماً مقصية وبعيدة وفي الأسفل..)، تلك المكانة التي خلقت ارتباكاً وقلقاً امتد عبر أجيال .الأمر الذي يعكس تناقضاً صريحاً بين ما جُبلت عليه الروح من أَنسٍ بالنغم وبين المكانة الاجتماعية الوضيعة التي يُدرج ضمنها من يمارس الغناء .لذلك نُبذت عذيجة و سلالتها التي يسري في عروقها حب الطار و المزمار كلعنة كان لابد من تبديدها ، وبالرغم من أن الغناء كمظهر اجتماعي مرتبط بالأفراح كان مقبولاً إلا أنه اقْتُرِنَ دائماً بالخزي حتى بداخل عائلة عذيجة نفسها و التي تحرجت ابنتها زليخة من هويتها وكانت تأمل أن تبتُرَ هي تلك السلسلة وألا يسري الولع باللحن في عروق ابنها شاهين ، ذلك الحرج هو تحديداً ما دفع بشاهين إلى أحضانِ جدته أكثر فأكثر فشُغِفَ بالموسيقى وخلف جدته في الغناء حتى ذاع صيته، بل وسمح لنفسه بأن يعبّر عن ذلك الولع بجسده الأمر الذي حشد ضده مزيداً من الكُره وتعاظُم شعورِعائلته الممتدة بالعار، عندها يبلغ الصراع في الرواية مداه حين يلجأ ابن عم شاهين لمحاولة إسكاته برصاصة لإنهاء تلك الحكاية للأبد، في مشهدٍ صاحَبَهُ توترٌ دراميٌ عالٍ يكشفَ عن خلل مجتمعي في تعريف مفهوم العار وما يصاحب الموسيقى وأجوائها من رفض وخزي إلا أن الصوت يجد سبيله للعودة رغم رحيل شاهين الذي كان موته صاخباً ومُدوّياً تماماً كحضوره فاستمر الصدى الذي تركه خلفه بالتردد والأثر بالبقاء شاخصاً في وجه الغياب.وهكذا نجد أنه إبتداءً من الجدة عذيجة لمروان وشاهين، وانتهاء بالفتاة الساردة للرواية، كان الكل يهيم باحثاً عن مساره الخاص في هذا الكون وعن سبيله للخلود في ذاكرة الأيام وما فعلته الرواية هو أن منحت أولئك الهامشيين صوتاً وذاكرة .

لم تبتعد صالحة عبيد عن مجال الحواس هذه المرة أيضاً، فبعد روايتها “دائرة التوابل” التي كانت حاسة الشم فيها محوراً تلتف حوله خيوط السرد، تخوض بنا في رواية” إلا جدتك كانت تغني ” نطاق الصوت والاستماع بكل تنويعاته، ولا يمكن لرواية بُنِيَتْ على مفهوم مُركّب وحيوي كهذا أن تأتي رتيبة أو خافتة، فكان أن منحتْ السرد إيقاعه الخاص فبدأ أول ما بدأ هادئاً يتناسب ومقامَ الحنين للماضي، ثم أخذت وتيرته في التسارع والاضطراب كلما تعمقنا أكثر، وكلما اقتربنا من صلب الحكاية اشتدّ وتكثف حتى بلغ ذروته في الفصول الأخيرة منها فغدت أكثر إيجازاً و تكثيفاً و وارتفعت فيها شِعريّة اللغة كما غلب عليها الطابع الدرامي حتى ليكادُ النص يجاري النص مسرحي في دراميته .
هذا التماهي بين مبنى الرواية ومضمونها كان ملائماً تماماً لطبيعة الموضوع، فتعدد مظاهر الصوت وكذا تعدد الرواة والأماكن والرؤى جعل السرد في أغلب مواضعه أشبه بجوقة من الشخصيات التي تصدح بين سطور الحكاية لتعلن عن حضورها المتأرجح بين الواقع والافتراض وبين الخلود والفناء. ويمكننا أن نجمل القول في أن الغناء كما قدمته الرواية لم يكن نغماً سارياً فحسب ولا وقعاً عابراً على السمع، بل هو حضور فعلي متجذر في المكان والزمان، إنه الجسر الذي عبره تمر الشخصيات إلى فضاء الوجود وتضمن خلودها في الذاكرة.
*قراءة بقلم: إيمان الشنيني