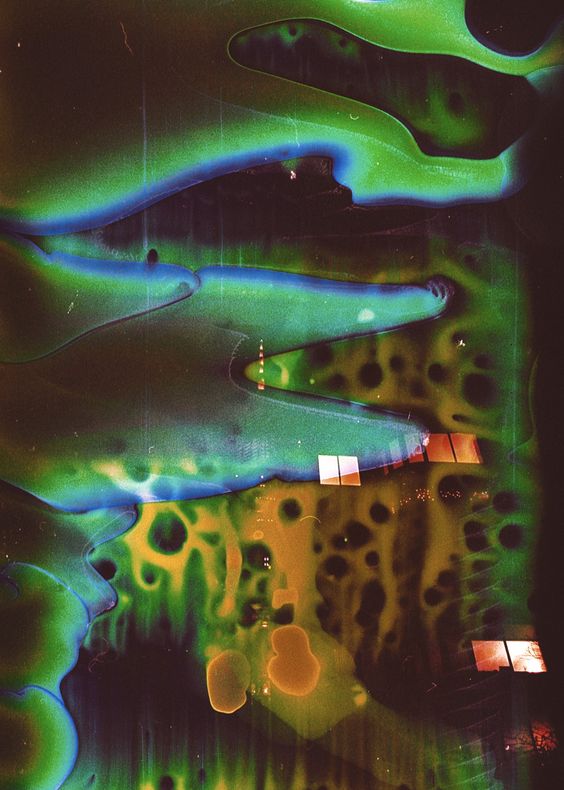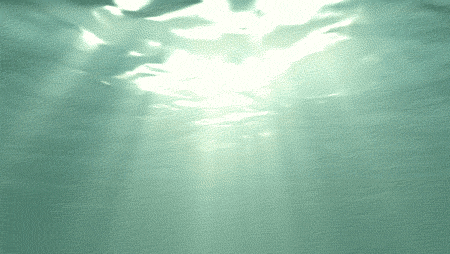لطالما تمسكتُ باللحظات، لكنها تتملص مني: اللحظات عدوٌّ لي، ترفضني، وتعلنُ رفضي بالاتحادِ ضدي. كلها بغيضة تشَهِّر بمنفايَّ وهزيمتي.
***
ليس بوسعنا أن نتحركَ وننخرطَ في الحياةِ دونَ أن نشعرَ بدعمها وحمايتها لنا. عندما تتخلى عنا، نفتقدُ النابضَ الضروريَ للقيامِ بأيّ عمل، مهما كانتْ درجةُ أهميته. مُحَقَّرين، دونَ مرجعيات، نتركُ لنواجهَ محنةً من نوعٍ خاص: أن لا يكونَ لنا حقٌ في الزمن.
***
إنني أراكمُ الماضي في داخلي، وباستمرارٍ أحولهُ وأخرجهُ في صيغةِ الحاضر- من دونِ أن أمنحهُ فرصةً ليستنفدَ فعاليته. أن نعيشَ يعني أنْ نخضعَ لشعوذةِ الممكن، ولكنْ بمَ أنَ الممكنَ كما يبدو لي هوَ في الماضي الآتي؛ فكلَّ شيءٍ يستحيل إلى ذكرياتِ ماضٍ مرتقب، ولا يعودُ ثمةَ حاضرٌ أو قادمٌ على الإطلاق. ما أميزهُ في كلِّ لحظةٍ من اللحظاتِ هو لهاثها واحتضارها، وليس انتقالها نحوَ لحظةٍ أخرى. أُهيئُ زمنًا ميتًا وأتمرغُ في اختناقِ الصيرورة.
***
يسقط الآخرونَ في الزمن؛ كما سقطتُ أنا منه. تترك الأبديةُ الجاثمةُ بكلَّ ثقلها فوقَ الزمن فسحةً لتتسللَ عبرها الأبديةُ الأخرى، منطقةٌ قاحلةٌ تمامًا حيثُ لا يمكنُ لي إلا أن أرغبَ في شيءٍ واحد: الرجوعُ إلى الزمن، أن أرجعَ بأيِّ ثمن، أن أستوليَ على قطعةٍ منه، أن أسلمَ نفسي لوهمِ امتلاكِ المكان. ولكنَ بوابةَ الزمنِ محكمةُ الإغلاق، لا يمكنُ اجتيازها، واستحالةُ اختراقها هذه هي ما تؤلفُ هذه الأبدية السلبية، هذه الأبدية الضالة.
***
لقد انسلخَ الزمنُ عن دمي، كانا معتادينِ على تحملِ بعضهما البعض، كانا يتدفقانِ معًا؛ والآن بمَ أن كليهما معطوبان، أيجبُ الاندهاشُ لأن شيئًا لن يحدثَ بعد؟
قرارهما العودةُ معًا وحدهُ كفيلٌ بإعادتي إلى خانةِ الأحياءِ وإخراجي من هذهِ الأبديةِ الثانوية حيثُ أتعفن. لكنهما لا يريدان، بل لا يقدران. لا بد أنَ تعويذةً ملعونةً ما قد ألقيتْ عليهما: فلمْ يعودا يتحركان، صارا جثتينِ متخشبتين. ليس بوسعِ أيِّ لحظةٍ أن تتسللَ إلى أوردتي. دمٌ قطبيٌ متجمدٌ منذُ قرون!
كلُّ ما يتنفس، كلُّ ما لديه أيُّ سمةٍ من سماتِ الكينونة، يتلاشى ويندحرُ في قعرٍ سحيق. هل حقًا تذوقتُ طعمَ الحياة في الأشياءِ من قبل؟ وماذا كانَ مذاقه؟ إنهُ محظورٌ عليَّ الآن، لكني لا أشتهيه. لقد أتخمني العدمُ من البداية.
***
إذا كنتُ لا أشعرُ بالزمن، إذا كنتُ أبعدَ الناسِ عنه، فإنني أعرفهُ رغمَ كلِّ شيء، أراقبهُ دون توقف: إنهُ يشغلُ مركزَ وعيي. كيف يمكنني تصديقُ أنَ موجِدَهُ نفسَهُ قد تأملهُ وفكّرَ فيه بهذا القدر؟ أتحدثُ عن الرب، إذا كان بالفعل قد خلقه، فلا يمكنهُ أن يعرفَ عمقه، فليس من عاداتهِ أن يجعلَ الزمنِ موضوعًا لتأملاته. أما أنا، فقانع أنني مبعدٌ عَنِ الزمنِ لأجعلهُ موضوعَ هواجسي. في الحقيقة، أنا أُعرِّفُ نفسي بالحنين الذي يلهمني إياه الزمن.
على افتراضِ أني عشتُ ذاتَ مرةٍ في الزمن، فكيف وبأيَّ طريقةٍ تعرفتُ عليه؟ الفترةُ التي كانَ فيها الزمنُ مألوفًا عندي كانتْ دائمًا غريبةً عني، ضاعتْ في ذاكرتي، لا تنتمي أبدًا لحياتي. وأن أجدَ لي مكانًا في الأبديةِ الحَقّةِ لهو أسهلُ من أن أجَد نفسي من جديدٍ في الزمن. ارحموا من كانَ في الزمن ولم يعد قادرًا أن يكونَ فيه.
“انحطاطٌ لقيط: كيفَ أمكنني أن أُفتَتنَ بالزمن، رغم أنني على الدوام لم أكن أتصورُ خلاصي إلا خارجه، كما عشتُ بيقينِ أنهُ يستنفدُ آخرَ ذخائره، وينخرُ داخلهُ مفسدًا بذلكَ جوهره، و أنهُ فاقدٌ للديمومة؟”
***
جالسينَ على عتبةِ الزمن، نتأملُ عبورَ اللحظات، ننتهي إلى اكتشافِ متسلسلٍ دونَ مضمون، زمنٍ فقدَ مادته، زمنٍ مجرد، صياغةٍ جديدةٍ لفراغنا. من تجريدٍ لآخر، يتضاءلُ الزمنُ بسببنا منكمشاً إلى حادث، إلى ظلِ نفسه. تعودُ إلينا مسألةُ إعطاءِ حياةٍ للزمنِ ومسألةُ اتخاذِ إجراءٍ واضحٍ في حقه، أن نسلكَ تجاههُ سلوكًا لا لبسَ فيه. لكنْ أَنّى لنا بهذا، في ظلِ المشاعرِ المتنافرةِ التي يثيرها، من نوباتِ الاشمئزازِ إلى الافتتان؟
***
أساليبُ الزمنِ الملتبسة توجدُ لدى أولئكِ الذينِ جعلوا منهُ اهتمامهم الرئيس، والذينَ يميلونَ إلى جوانبهِ الشكوكية، للربكةِ التي يثيرها بينِ الكينونةِ والعدم، لصفاقتهِ وتقلبه، لمظاهرهِ الخداعة، مخاتَلتهِ ونذالتهِ الأصيلة، مديرينَ بذلك ظهرهم لجانبهِ الإيجابي. إن الزمنَ ماكرٌ على الصعيدِ الميتافيزيقي. كلما اختبرناهُ شبهناهُ بشخصيةٍ مريبة، لا نكفُ عن الشكِ بها، ولا يرتاحُ لنا بالٌ حتى ننزعَ عنها أقنعتها، وسرعانَ ما نخضعُ لسلطتها وفتنتها. ومن هذه النقطة، إلى التأليهِ والعبودية، توجدُ خطوةٌ واحدة.
***
لقد رغبتُ كثيرًا في الزمن ليس لأدحضَ زيفه، لقد عزلتهُ عن العالمِ جاعلاً منه واقعًا مستقلاً عن أيِّ شيء آخر، كونًا متوحدًا، بديلاً للمطلق: سيرورةً شاذةً تبقيهِ مبعدًا عن أيّةِ تضميناتٍ أو ارتباطات، رقيتهُ من كومبارس إلى بطل، ترقيةٌ لم تكنْ ضرورية، ولكن لم يكن منها مفر. يجب أن أكونَ آخر من ينكر حقيقةَ أنَ الزمن قد نجحَ في تشويشي. لكنه أيضًا لم يتنبأ بأن هوسي بهِ سيتحولُ يومًا ما إلى وضوح، مع كلَّ ما يحملهُ ذلك لي من تهديدات.
***
يبلغُ الزمنُ من شدةِ محافظتهِ أنهُ لا يقاومُ إلحاحَ العقلِ لسبرِ أغواره، تختفي كثافتهُ، تتلاشى دفاعاته، وكلُّ ما يتبقى هو بضعُ خِرقٍ ينبغي على محللِ الزمنِ أنْ يكتفيَ بها. لأنَ الزمنَ لم يُقصدْ ليُعرفْ بل ليُعاش، استكشافُ الزمنِ يعني إهانةَ الزمن، تحويلهُ إلى شيء. وكلُّ من يفعلُ ذلكَ سينتهي بهِ الأمرُ إلى معاملةِ نفسهِ بالطريقة ذاتها؛ لأنَ كلَّ تحليلٍ هو تدنيس، والاسترسالُ فيه فجور. كلما سبرنا أسرارنا الخاصة لنُقلبها، انتقلنا من الحيرةِ واحمرارِ الوجه إلى القلق، ومن القلقِ إلى الجَزع. معرفةُ النفسِ دائمًا ما تكلفُ كثيرًا، كما هي المعرفةُ ذاتها على كلَّ حال . وحالما نبلغُ القاع، لا يعودُ عناءُ الاستمرارِ في العيشِ يعنينا. في كونٍ كلُّ ما فيه مُبيّنٌ وواضحٌ تمامَ الوضوح؛ لن يتبقى معنى لأيَّ شيءٍ سوى الجنون. كلُّ ما نخرجهُ للعلنِ لا تعودُ له أيّةُ قيمة . وعليه فما إنْ ننفذُ إلى عمقِ شخصٍ ما ونسبرُ أغوارهُ، فأفضلُ ما يمكن أن يفعلهُ هوَ أنْ يختفي. وبدافعٍ من الخجلِ أكثرَ من غريزةِ حمايةِ النفسْ، يخفي جميعُ الأحياءِ زَيفهم ويرتدونَ الأقنعة. وأن نمزقَ تلكَ الأقنعة يعني أنْ ندمرَ مرتديها ومعهم أنفسنا. مما لا شكَ فيهِ أنَ التسكعَ تحتَ ظلالِ شجرةِ المعرفة -عادةٌ رذيلة.
***
ثمةَ شيء ما، مقدسٌ، في كلَّ كائنٍ لا يعي وجوده، في أشكالِ الحياةِ كافة المعفاةِ من الوعي. ومن لم يحسدِ النباتَ فسيلتحقْ فورًا بالمأساةِ الإنسانية.
***
لأنني قمتُ بقذفهِ في كلَّ موضعٍ، ينتقمُ الزمنُ مني بجعلي طالبَ إحسانٍ منه، بإكراهي الندمَ عليه. كيفَ أمكنني أن أشبههُ بالجحيم؟ الجحيم، هو الحاضرُ الثابت، هذا الشدُ في الرتابة، هذه الأبديةُ المعكوسةُ التي تفضي إلى لا شيء، ليسَ حتى إلى الموت، حيثُ إنَ الزمنَ الذي يستمرُ في التدفق، في المرور، يعطي على الأقل العزاءَ في شيءٍ منتظر، حتى لو كانَ هو الموت. ماذا يمكنُ أن ننتظرَ هنا، عند نهاية السقوط، حيثُ لا يمكن السقوط أكثر، أو حتى الأملُ في هاويةٍ أخرى؟ وماذا ننتظرُ من هذه الشرورِ التي تنتظرنا في الأسفل معلنةً دون توقفٍ أنها الشيءُ الوحيدُ الذي يوجدُ هناك، بل إنها الوحيدةُ الموجودةُ فعلا؟ ولو مكنّا هذا الغضبُ من البدءِ من جديد، وهو ما يشكلُ نبضَ الحياةِ والأملَ في النور، فسنجدها أمورًا زائفة في هذا الخرابِ الزماني الفرعي، هذا الانسحاقُ التدريجي، هذا الدفنُ في تكرارٍ بلا نهاية، محبطٌ ومعتم، والذي يمكن التخفّف من وطأتهِ فقط عبرَ الغضب.
عندما يكفُ الحاضرُ الأبدي عن أن يكونَ وقتَ الله ليصيرَ وقتَ الشيطان، كلُّ شيءٍ سيفسد، كلُّ شيءٍ سيصيرُ أداةَ تعذيبٍ لا تطاق، يتهاوى كلُّ شيءٍ في تلكَ الهاويةِ حيثُ يأملُ المرءُ عبثًا في خاتمة، حيثُ يُتركُ ليتعفنَ في الخلود. من يهوي إلى تلكَ الهاويةِ يلتفتُ ويدوُر حولَ نفسه، يكافحُ بلا جدوى ولا ينتجُ شيئًا. وهكذا تتعاون كلَّ أشكالِ العقمِ والعجزِ في الجحيم.
***
ليس بوسعنا الشعورُ بأننا أحرارٌ وموجودونَ دائمًا مع أنفسنا، أمامَ أنفسنا، أمامَ الشخص نفسه. هذهِ الهوية، هذه النكبةُ وهذا الهوس، ما يربطنا بعهرنا، يجرنا للوراء، ويدفع بنا من جديدٍ خارجَ الزمن. وحينَ نُطرد خارج الزمن نتذكرُ المستقبل ولا نعودُ نهرعُ صوبه.
***
من الصعوبةِ أن نتحررَ من هذا اليقينِ بأننا لسنا أحرارًا. كيف يمكننا التحركُ ونحنُ نعلمُ أننا محكومونَ بمصير؟ كيفَ يمكنُ للآلاتِ أن ترغب؟ من حسنِ الحظِ أن هنالكَ هامشاً من عدمِ التحديدِ لأفعالنا – وأفعالنا فحسب: إذْ يمكنني اختيارُ القيامِ بهذا الفعلِ أو ذاك، لكني لا أستطيع أن أكونَ إلا ما أنا عليه. وإذا ملكتُ مجالاً للتصرفِ على السطح، ففي العمق، على العكسِ من ذلك، كلُّ شيءٍ محسومٌ سلفًا. من الحريةِ أنَّ الوهمَ وحدهُ حقيقي. دونه تغدو ممارسةُ الحياة ِغير ممكنة، بل لا يمكنُ حتى تصورها. ما يدفعنا لتخيلِ أننا أحرارٌ هو وعينا بالحاجةِ عموما، وبقيودنا خصوصا. الوعي يفرضُ مسافةً عن الأشياء، وكلُّ مسافةٍ تنتجُ في داخلنا إحساسًا بالاستقلال والسموّ، استقلالٌ وسموٌّ ذاتيٌ طبعا، أيّ بلا قيمة. بأيَّ شيءٍ يلطفُ وعيُ الموتِ فكرةَ الموتِ أو يقرّبُ قدومه؟ أن تعي بأنكَ زائلٌ، هو في الحقيقةِ أنْ تموتَ مرتين، لا، لا بد أننا نموتُ في كلِّ مرةٍ نعي فيها أننا هالكون.
الجميلُ في الحريةِ أننا نتعلقُ بها في النطاقِ الذي تبدو فيه مستحيلة. والأجملُ أيضًا أن بوسعنا أن ننفيها وهذا النفيُ يشكلُ المرجعَ الكبيرَ ولبّ عديدٍ من الدياناتِ والحضارات. لن نستطيعَ ردَ الجميلِ للحضاراتِ القديمةِ التي اعتقدتْ أنَ مصائرنا مطبوعةٌ سلفا على النجوم، وأنهُ لا شيءَ لم يكتبْ وأنَ لا مكانَ للارتجالِ أو الحظِ في مسرّاتنا ومآسينا. بعجزها عن مواجهةِ خرافةٍ نبيلةٍ لا لشيء سوى لمجردِ سيادةِ قانونِ الوراثة، فإنَ علومنا أثبتتْ عدمَ أهليتها للأبد. ذاتَ مرةٍ كانَ لكلّ منا نجمه، والآن صرنا عبيدًا لكيمياءَ نتنة. هذا هو ذروةُ الانحطاطِ لمفهومِ القدر.
***
ليسَ ببعيدٍ أنَ أزمةً فرديةً ستُعمَّمُ يومًا ما وتكتسبُ بذلك، بدلَ قيمتها النفسية، قيمةً تاريخيةً. لا يتعلقُ الأمرُ هنا بمجردِ فرضية، إنها إشاراتٌ يجبُ التعودُ على قراءتها.
بعدما ضَيَّعَ الأبديةَ الحقة، سقطَ الإنسانُ في الزمن، حيثُ إنهُ وإن لم ينجحْ في التألق، نجحَ على الأقل في الحياة : الأكيدُ أنه قامَ باستيعابِ الأمر. عمليةُ السقوطِ هذهِ واستيعابهُ لها اسم: هو التاريخ.
لكن ها هو يواجه تهديدًا آخر بالسقوط، يجهل هذه المرة مداه. لا يتعلقُ الأمرُ هذهِ المرة بالسقوطِ من الأبدية، بل بالسقوطِ من الزمن؛ والسقوطُ من الزمن يعني السقوطُ من التاريخ، إنهُ الصيرورةُ المعلّقة، التعَلّقُ بالخمولِ والرتابة، في مطلقِ الركودِ حيثُ الكلمةُ ذاتها تعلَقُ، عاجزةً عن التدنيسِ أو التوسل. وشيكةً أم لا، هذه السقطةُ ممكنةٌ، بل لا مفرَ منها. وحينَ تصبحُ المشتركَ بينَ البشر (حين يسقطُ كلُّ البشر)، سيتوقفُ الإنسانُ عن كونهِ حيوانًا تاريخيا. وحينَ يفقدُ أيَّ ذكرى عن الأبديةِ الحقة، عن سعادتهِ الأولى، سيزيحُ بصره عن الكونِ المؤقتِ إلى الجنةِ الثانية، تلكَ التي طُردَ منها سلفا.
***
طالما نحنُ في الزمن، لدينا أندادٌ سنتبارَى معهم؛ وما إن نخرجَ منه، فإن كلَّ ما يفعلهُ -أندادنا- وكلَّ ما يفكرونَ فيهِ حيالنا لا يعودُ يعنينا إطلاقا، لأننا بلغنا من الانفكاكِ عنهم وعن أنفسنا مبلغًا صارَ معهُ إنتاجُ صورةٍ لنا أو حتى التفكيرُ بها بعيدًا وسخفًا بالغًا.
انعدامُ الإحساسِ بالمصيرِ هو شيمةُ الساقطِ مِنَ الزمن، وكلما ترسخَ سقوطهُ أكثرَ وصارَ أوضح، ازدادَ عجزهُ عنْ إظهارِ نفسهِ وتلاشتْ أيُّ رغبةٍ لديهِ في أنْ يتركَ أثرًا في الوجود. لا بدَ من الاعترافِ بأن الزمنَ يشكلُ عنصرنا الحيوي؛ حينَ نفتقدهُ نجدُ أنفسنا بلا أيِّ سند، في قلبِ اللاواقعِ أو في قلبِ الجحيم. أو فيهما معا، في الملل، ذلك الحنينُ الظامئُ للزمن، واستحالةُ اللحاقِ بهِ والاندراجِ فيه، واليأسُ الذي من رؤيتهِ يتدفقُ هناكَ في الأعلى، فوقَ مآسينا. لقد خسرنا الأبديةَ والزمن! والضجرُ هو اجترارُ هذهِ الخسارةِ المزدوجة. يمكنُ القولُ إن الحالةَ الطبيعية، هي أن تُحِسّ رسميًا بأنكً من إنسانيةٍ منبوذةٍ أخيرًا من التاريخ.
***
لا ينفكُ الإنسانُ عن أن يتحدى الآلهة وينفيها، مع ذلك لا يزال يقرُّ بمكانتها كأطياف؛ سينزلُ الإنسانُ أسفلَ الزمنِ إلى نقطةٍ يجدُ فيها نفسهُ بعيدًا عن الآلهةِ لدرجةِ أنهُ لن يستوعبَ فكرةَ الإلهِ نفسها. وعقابًا على نسيانه هذا سيتعينُ عليه خوضَ تجربةِ السقوطِ الكامل.
ذاكَ الذي يسعى أنْ يكونَ أكثرَ مما هو عليه، لن يُفَوّتَ أن يكونَ أقل. هذا الاختلالُ الذي يولّدهُ ُالتوترُ سيغدو عاجلاً أو آجلاً مناسبًا لبيئةِ الركودِ والتخلّي. حالما نأخذَ ذلكَ بعينِ الاعتبار، فلا محيدَ عَنِ المضيِ قدمًا والإقرارُ بأنَ ثمةَ غموضاً في السقوط. الساقط. لا علاقةَ أبدًا بينَ الساقطِ والفاشل؛ إنهُ شخصٌ مدفوعٌ ميتافيزيقيا، كما لو أن قوىً شريرةً اتحدتْ ضدهُ وسحبتْ منهُ مَلَكَاته.
يتجاوزُ مشهدُ السقوطِ مشهدَ الموت: كلُّ الكائناتِ تموت؛ الإنسانُ وحدهُ يمكنهُ السقوط. إنهُ يعيشُ على حافةِ الحياة (كما هي الحياةُ على حافةِ كلِّ ما هو خارجَ المادة). وكلما ابتعدَ عنها، سواءً ارتفعَ عنها أو سقطَ منها، فهو لا يفعلُ غيرَ تقريبِ هلاكه. سواءً تمكنَ مِنْ تعظيمِ نفسهِ أو تشويهها، ففي الحالتين يضيّعُ نفسه. ويجبُ التنبيهُ إلى أن هذا الضياعَ لا يمكنُ تجنبهُ من دونِ التحايلِ على مصيره.
***
أن ترغبَ يعني أن تبقى دائمًا في حالةٍ من السخط ِوالانتظارِ والحمى. الأمرُ الذي يتطلبُ جهدًا مرهقًا وليس مؤكدًا أن الإنسانَ يستطيعُ تحمّلهُ دائمًا. أن تصدقَ أنَ بوسعهِ تخطي حدودهِ والانتقالِ إلى حدودِ الإنسانِ الأعلى، فهو يعني أنْ تنسى أنهُ بالكادِ يتحملُ كونهُ إنسانًا، وأنَ أقصى ما بوسعهِ هو أنْ يمددَ نابضه – إرادته – إلى حدودهِ القصوى. وتلك الإرادةُ التي تضمُ مبدأً شكوكيًا وكارثيًا، تنقلبُ ضدّ من يفرطُ في استعمالها. ليسَ من الطبيعي أن تريد، وبشكلٍ أدق، يجبُ أن نرغبَ فقط بما يكفي للعيش. متى ما رغبنا أقلّ أو أكثر، نتحطمُ أو نهوي عاجلاً أو آجلاً. إذا كان نقصُ الإرادةِ مرضًا، فالإرادةُ نفسها مرضٌ، بل أسوأُ من ذلك: من إفراطاتها، أكثر من نقصها، تجيءُ انكساراتِ الإنسان كافةً. لكنْ إنْ أرادَ حالته الراهنة، فماذا عساه يحلّ بالأنسانِ الأعلى؟ سيتحطمُ بلا شكٍ ويعود إلى ذاته. عبرَ انعطافةٍ مهيبةٍ، سيتجهُ الإنسانُ إلى السقوطِ مِنَ الزمنِ ليدخلَ الأبديةَ السُفلى، وهي – خاتمةٌ محتومة – وفي النهايةِ لا يهمّ كثيرًا إذا وصلَ هناك بانحدارٍ أو كارثة.