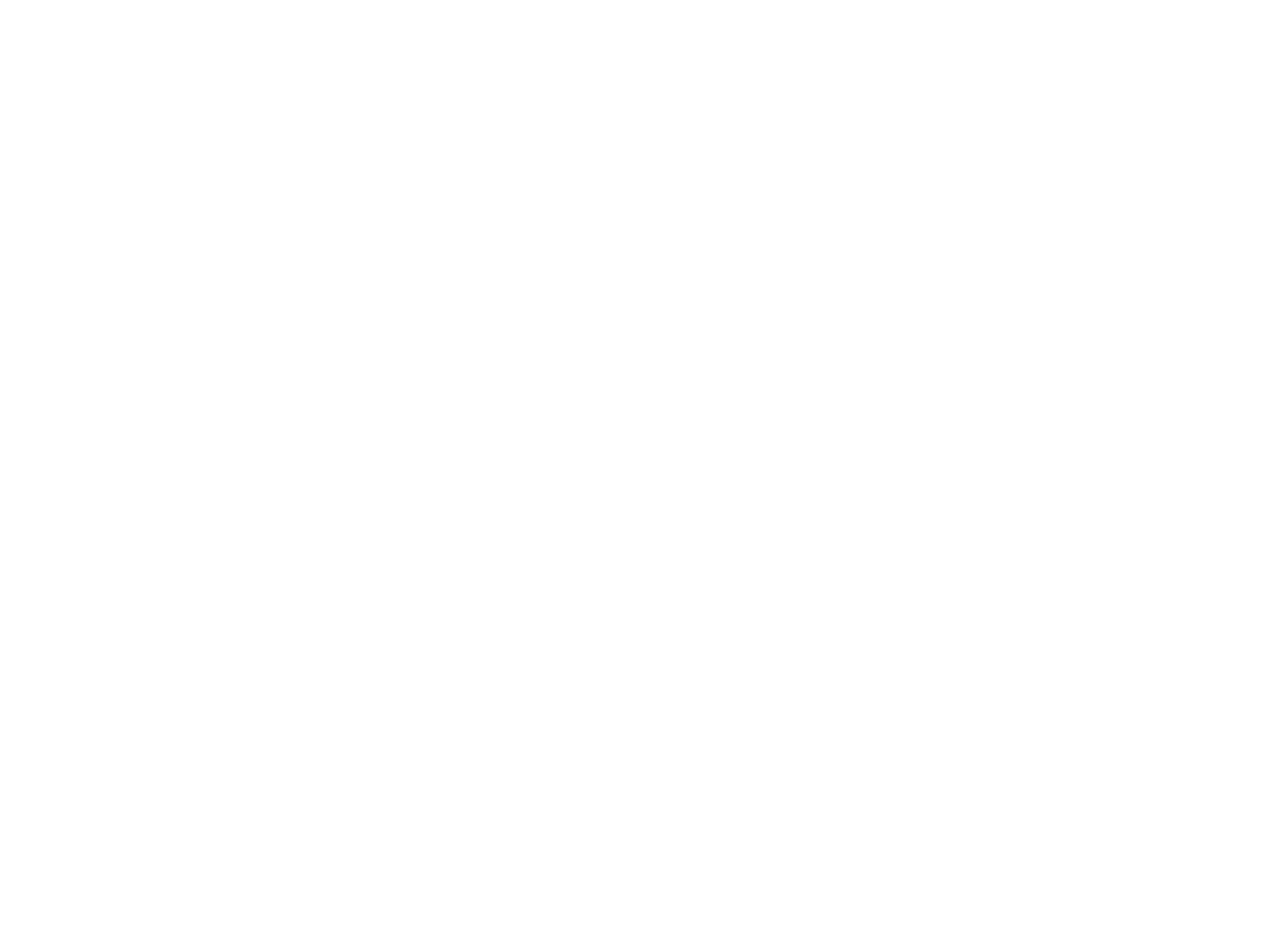عزيزي صاحب الظل الطويل:
سَمعتُ مقولةً:
“من أي مادة متلاشية صُنعت عواطفنا”؟
جملةٌ كهذه وشبيهاتها التي تحكي عن عواطف متبخرة؛ كانت تزرع في قلبي الخوف باعتباري شخص مُعمِّر في علاقاته، وكنت أعتبرُ أن اللاثبات من الخيانة، لكن الآن بعد أن مرت مياهٌ كثيرةٌ تحت الجسر، عرفت أننا نتحصَّن في هذه الحياة حول كلمة واحدة فقط “التغيير”. بل إنَّ التغيير هو الثبات الوحيد في الحياة. وهي كلمة مُخيفة لمن لم يعش كثيرًا، أعني يعش عميقا، يفهم المعنى وإرادته فينا. كانت جملة “القلب مُتقلب” تشعرني بالخوف؛ الخوف من نفسي أكثر من الآخر، فإن كانت لا ضمانة في قلب الآخر فلا ضمانة في قلبي بالمقابل، وكان يرعبني أن بين ضلوعي قلب يعبث وينسى ويحب ويكره ويصُور له ويتقلب، لكن كل ذلك كان فيما مضى، فالقلب أولى به أن يتقلب ويختبر حتى يعرف طبيعة الشعور الذي سينغلق عليه، ويأخذ كفايته من حقيقة لا تقلبها التأويلات.
حتى العقل؛ كُنتُ قلِقةً بشأن زحزحة حدوده الذهنية، وريشُ الوسائدِ المريحة، يمنعني من النومِ على حصى الأفكار، ثم فهمت أننا لسنا في هذه الحياة إلا من أجل هذه الزحزحة.
من جهة مقابلة آخرى، كان ذلك مهم، بل حتمي.. الحياة رحلة صعبة، والقلب يأخذ الصفعات والعقل يعالجها، ولا شئ يثبت. وعواطفنا على اشتعالها تتبخر، وبقدر مالصقت بنا أصبحت بعيدة عنّا. الأفكار والعادات لازالت كما هي, إنما نحن من نتغير، الكُتب التي كانت تدمينا والأغاني التي ذوبتنا ذَهبت، أو بالأحرى نفوسنا القديمة ذَهبت.
هناك من يرى أن “تحولات” الإنسان ودوراته وكبره على المكان والزمان عيبًا شخصيًا خطيرًا، لكني أعتقد أن العيب الشخصي الخطير هو ألا نسعى نحو تلك التحولات، ونصنع تلك المواقف والعواطف التي تجعل نفوسنا تتشظى وتعاد التركيب من جديد، خاصة إن كانت نفوسنا تهدر كنهر تجذبه قوى خرافية نحو الحقيقة.
وأنا ياصاحب الظل الطويل أريد من الحياة عواطف وأفكار وعلاقات ليست بها مِثقال ذرة من غِش!
أعرف أن هذا صعب، وأنه يتطلب مني نقاءًا مماثلا بالضرورة، لكنه وإن كان مستحيلاً، فالتطلع للمستحيلات كاف لأن يُبصرنا بخردة أفكارنا القديمة، ويوعينا بنفايات الزمن التي ترامت على شواطئ أرواحنا وعقولنا، والرفض أول طريق الحرية.
***
الأمرُ عندي ليس مجرد كتابة، أنا أصنع أطرافا تعويضية بالكلمات، أنا المُعاقة عن الحياة، عن الجناحين اللذين لم يكونا، عن الحب الجريح، والأمل الضائع، وكل العصافير التي اختنقت في صدري، عن الأمل الذي استيقظت حالما لمسته، وعن الصديق الذي امتدت بيني وبينه صحراء، كانت الكتابة في الوقت الذي لم يكن لي فيه أحد.
جعلتُ لها قوة الضمادات، ورهبة المبضع، وبركة كلمات الصالحين، ولهفة العشاق المفارقين، وانتحاب الخطائين التائبين، وأنين الوحيدين.. روحي توسدت جملتي التي صنعتها خصيصا لتربت على قلبي المُلتهب..غزلت من كلماتي شالا شتويا، وثوبا قطنيا ناعما للصيف، ان القوة فيها أكثر من كونها كلمات.
وهي، هي منحتني الحب والطهر أيضا، فبت أعترف على يديها بأدنس الذنوب وأقدسها، وأواجه نفسي بأحط الرغبات وأخلصها، أبكي بها، وأعصر الورق دموعًا وندى وفراشات وزهورًا وعطرًا.
أخذت بها وجهة نظر في الحياة، وحملتها أرجوحة ولعبة، لعبة مناسبة لعزلة مقدسة. عشت في الكلمات أكثر مما عشت في الحياة، فالحياة لم تمنحني غير مساحة للوقوف على رجل واحدة، أو القفز كمخلوق أعرج، بينما الكتابة خدعتي الطيبة، وسمائي الصافية وسبع أراضين ليس لهن من قرار.
منحة الكتابة منحة حرية، فرصتي لأتنفس، لأرفض، أعتصم أثور وأغضب، أقتل وأحي، أكون نفسي تمامًا، دون خليط مع وجوه من مروا، فرصة لأنقي ملامحي تماما، بعيدا عن إمتداد النسب والبيئة؛ إنسان بكامل اختياره الواعي لملامحه الداخلية.
فرصتي الجميلة لأكون شفافة، وأطول عمرا من عمري، وأعمق من وقتي، وأثبت أثرا لقدم مشت على أرض.
***
حين أبصرتُ داخلي، وجدت أن كثيرًا من الألم الذي عايشته على يد آخرين، لم يكن بخصوصهم هم على وجه التحديد، ولا في قوة رابطة علاقة ذُبحت، ولكن جزءًا كبيرًا من الألم ذهب للمعاني التي شوهها الخذلان داخلي، في يد العبث التي طالت وجداني. في أنه للأبد يهمس فيك هذا الأمر بالتهدم.
ونبهتني تلك الالتفاتة من الألم، لعجزي عن القدرة على مَدّ جسوري ثانية تجاه آخرين، وبت صاحبة أُصعِّب تعاملًا عاطفيًّا حَذِرًا تجاه البشر عموما.. ففي الأخير القلب ليس غير قطعة لحم واهنة ترقد في جنوبنا.
سألت نفسي أن الكثيرين منّا ليسوا في بلاغة الشعراء ليقدوا جرحًا مماثلا من الكلمات، ولسنا رسامين لنرسم قلبًا منفطرًا. إذا..لماذا ليس لنا نحن الناس العاديين قوة الجرّاحين فنشق عن صدورنا ونكشف عن قلبٍ ماذا فعلت فيه الكلمات والأفعال بالتعيين؛ فالعتاب في أوقات كثيرة غير مُجْدٍ، وفي لحظاته القصوى تفاجئنا الكلمات بسقوطها للداخل، لأنها لن تُفهَم غير هناك.. يخدّرنا الصمت لجرح لم يكن سطحيا كما تصورنا، شرخ لن يُعافَى أبدًا بوقت.
وجّهت أصابع الاتهام لنفسي، أكان خطأي أني منحت أحدًا كل تلك السلطة الروحية عليّ؟، أو أني تركت نفسي تنغمر باطمئنان في نفس أخرى لهذه الدرجة؟.
وتساءلت أيضا، كم إنسانًا غيري انجرح، فسأل نفسه هذا السؤال، هل على الإنسان أن يثق تماما بإنسان؟.
إذ ربما يكون هذا الألم جماعيًّا وليس شخصيًّا، سألته الإنسانية العاقلة الحساسة في كل مكان، وما قام زمان، هل تخطئ الأنهار حين تتجه بكل غريزتها قاطعة الأراضي، متدفقة ومنصبة في عمى لقلب المحيط!.
أراحني أن يكون هذا همًّا إنسانيًّا، ولا يحتاج كل هذا الحزن المسرحي مني!.
لكن الذكريات تعاودني بمكر؛ تقابل إنسانًا تثق به، فتفتح له قلبك، وتتركه هناك، الكل حدث معه الأمر هكذا، لكن ما بعد ذلك كل منّا يمسرحه بطريقته..
في إحدى الرويات التي قرأتها، في مشهد يبدو متكررا، كان هناك رجل استيقظ من نومه، يبحث عن صديقه الذي يعتبره “أناه الثانية”، فوجده واقفا على الشرفة، يجافيه النوم وينظر للبحر ذاهلا، فسأله: ما الذي يوقظك الآن؟.
فأشار له إلى صخرة بعيدة، وقال له: أتحسب كم لها من زمن هناك؟.
فأجابه: لا أدري…ربما قرون…ربما منذ خلق الله الأرض.
فرد صديقه: أتمنى أن تنشق هذه الصخرة وتطويني.
لم يكن هناك ردٌّ على أسئلة التعب، غير أن صوت “ربابة” في ذلك الوقت انسال من الأفق البعيد، فسالت معه الكثير من الدموع.
فاطمة علي – مصر