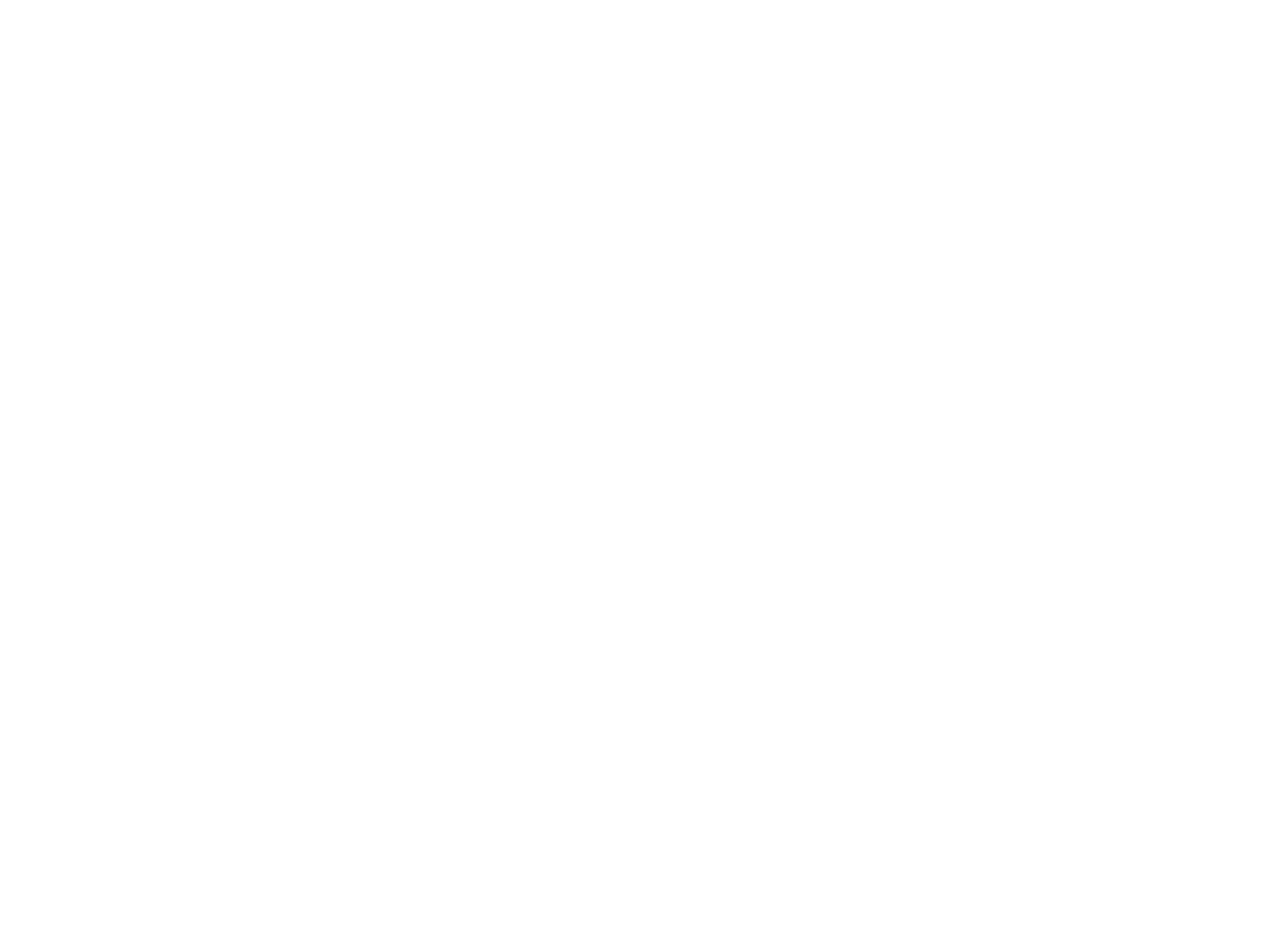نيويورك/ نوفمبر/ الشارعُ الْخَامس/
الشمسُ صَحنٌ من المعدنِ المتطايرِ/
قلتُ لنفسي الغريبةَ في الظلِّ:
هل هذه بَابلُ، أم سدوم؟
هناكَ، على بابِ هاويةٍ كهربائيةٍ
بعلوِّ السماء، التقيتُ بإدواردَ
قبلَ ثلاثينَ عاماً،
وَكانَ الزَّمانُ أقلَّ جموحاً منَ الآن
قالَ كِلانَا:
إذا كانَ مَاضيكَ تجربةً
فاجعلِ الغَدَ مَعنىً وَرُؤيا!
لنذهبْ،
لنذهبْ إلى غَدِنَا واثقين
بصدقِ الخيالِ، ومُعجزةِ العشبِ /
لا أتذكَّرُ أنّا ذهبنا إلى السينما
في المساء. ولكنْ سمعت هنوداً
قُدَامَى يُنادُونَنِي:
لا تَثِقْ بالحصانِ ولا بالْحَدَاثَةِ /
لا، لا ضَحيَّة تسألُ جَلاَّدَها:
هل أنا أنت؟ لو كان سيفيَ
أكبرَ من وَردَتِي، هل ستسألُ
إن كُنتُ أفعلُ مِثلَكْ؟
سؤالٌ كهذا يُثيرُ فُضولَ الرِّوَائِيِّ
فِي مَكتبٍ مِنْ زُجَاجٍ يُطِلُّ على
زنبقٍ في الحديقةِ… حيثُ تكونُ
يدُ الفَرَضِيَّةِ بيضَاءَ مثلَ ضَميرِ
الرِّوَائِيِّ حينَ يُصَفِّي الحسابَ
مَعَ النَّزعَةِ الْبَشَرِيَّةِ: لا غَدَ
فِي الأمس، فَلنتقدَّمْ إذاً !
قَد يَكُونُ التَّقَدُّمُ جسرَ الرُّجوعِ
إلى الْبَرْبَرِيَّة… /
نيويورك. إدوارد يَصحُو عَلى كَسَلِ
الْفَجرِ. يَعزِفُ لَحنَاً لموتسارت. يَركُضُ
فِي مَلعَبِ التنسِ الْجَامِعِيِّ. يُفَكِّرُ في
هِجرَةِ الطيرِ عَبرَ الْحُدُود وفوقَ الْحَوَاجِزْ.
يَقرأ “نيويورك تايمز”. يَكتُبُ تَعلِيقَهُ
الْمُتَوتِّرَ. يَلعنُ مُستَشرِقَاً يُرشدُ الجنرالَ
إلى نُقطَةِ الضعفِ في قَلبِ شَرقِيّة.
يستحمُّ. ويَختَارُ بدلَتَهُ بَأناقَةِ دِيكٍ.
وَيشربُ قَهوتَهُ بالْحَليبِ. ويصرُخُ
بالفجرِ: هَيَّا، ولا تَتَلَكَّأ /
عَلى الريحِ يَمشي. وفي الريحِ
يعرفُ مَن هُوَ. لا سقفَ للريحِ.
لا بيتَ للريحِ. والريحُ بوصلةٌ
لشَمالِ الغريب.
يقولُ: أنا من هُناكَ. أنا من هُنا
ولستُ هُناكَ، ولستُ هنا
لِيَ اسمانِ يلتقيانِ ويفترقانِ
ولي لُغتانِ، نسيتُ بأيِّهما
كُنتُ أحلمُ،
لِي لُغةٌ إنجليزيةٌ للكتابةِ،
طَيِّعَةُ المفردات،
وَلي لُغةٌ من حِوارِ السماءِ معَ
القدسِ، فِضيَّةُ النبرِ، لَكنها
لا تُطيعُ مُخيلتي !
والْهُوِيَّةُ؟ قلتُ
فقالَ: دفاعٌ عن الذاتِ…
إنَّ الْهُويَّةَ بنتُ الولادةِ، لكنها
في النهايةِ إبداعُ صاحِبها، لا
ورَاثةَ ماضٍ. أنا الْمُتَعَدِّدُ. في
داخلي خَارِجي الْمُتجدِّدُ.. لكنني
أنتمي لسؤالِ الضحيَّةِ. لو لم
أكن من هُناكَ لَدَرَّبتُ قلبي
على أن يُربي هناكَ غزال الكِنايَةِ.
فاحملْ بلادكَ أنَّى ذهبتَ…
وُكن نَرجسياً إذا لَزمَ الأمرُ /
– مَنفىً هوَ العالمُ الخارجيُّ
ومَنفىً هوَ العالمُ داخليُّ
فمَنْ أنتَ بينهما؟
– لا أُعَرِّفُ نفسي تماماً
لئلاَّ أضيِّعها. وأنا ما أنا
وأنا آخري في ثُنائيةٍ
تتناغمُ بينَ الكلامِ وبينَ الإشارةْ.
ولو كنتُ أكتبُ شعراً لقلتُ:
أنا اثنانِ في واحدٍ
كَجناحي سُنونوةٍ،
إن تأخرَ فصلُ الربيعِ
اكتفيتُ بحملِ البشارةْ
يُحبُّ بلاداً، ويَرحلُ عنها
( هل المستحيلُ بعيدٌ؟)
يُحبُّ الرحيلَ إلى أيِّ شئٍ
ففي السفرِ الحرِّ بينَ الثقافاتِ
قد يجدُ الباحثونَ عن الجوهرِ البشريِّ
مقاعدَ كافيةً للجميع.
هُنا هامشٌ يتقدَّمُ. أو مَركزٌ يتراجعُ
لا الشرقُ شرقٌ تماماً
ولا الغربُ غربٌ تماماً
لأنَّ الهويَّةَ مفتوحةً للتعدُّدِ
لا قلعةً أو خنادق /
كانَ المجازُ ينامُ على ضفةِ النهرِ،
لولا التَلَوُّثُ،
لاحتضنَ الضفَّةَ الثانيةْ
– هل كتبتَ الروايةَ؟
– حاولتُ… حاولتُ أن أستعيدَ بها
صورتي في مرايا النساءِ البعيدات،
لكنهنَّ توغلنَ في ليلهِنَّ الحصين
وقلنَ: لنا عالمٌ مُستقِلٌّ عن النصِّ
لن يكتبَ الرجلُ المرأةَ اللغزَ والْحُلمَ
لن تكتبَ المرأةُ الرجلَ الرمزَ والنجمَ
لا حُبَّ يُشبهُ حباً
ولا ليلَ يُشبهُ ليلاً
دعونا نُعدِّدْ صفاتَ الرجالِ ونضحكْ!
– وماذا فعلتَ؟
– ضحكتُ على عبثي
/ المُفَكِّرُ يكبحُ سردَ الروائيِّ
والفيلسوفُ يُشَرِّحُ وَردَ المُغَنِّي /
يُحبُّ بلاداً ويرحلُ عنها:
أنا ما أكونُ وما سأكونُ
سأصنعُ نفسي بنفسي
وأختارُ منفايَ
منفايَ خلفيةُ المشهدِ الملحميِّ
أدافعُ عن حاجةِ الشعراءِ
إلى الغدِ والذكرياتِ معاً
وأدافعُ عن شجرٍ ترتديهِ الطيورُ
بلاداً ومنفى
وعن قمرٍ لم يزلْ صالحاً لقصيدةِ حُبٍّ
أدافعُ عن فكرةٍ كسرتها هشاشةُ أصحابها
وأدافعُ عن بلدٍ خطفته الأساطيرُ /
– هل تستطيعُ الرجوعَ إلى أيِّ شئٍ؟
– أمامي يَجرُّ ورائي ويُسرعُ…
لا وقتَ في ساعتي لأخطَّ سطوراً
على الرملِ. لكنني أستطيعُ زيارةَ أمسِ،
كما يفعلُ الغرباءُ،
إذا استمعوا في المساءِ
إلى الشاعرِ الرعويِّ:
( فتاةٌ على النبعِ تملأ جرَّتها
بحليبِ السحابْ
وتبكي وتضحكُ من نخلةٍ
لسعت قلبها في مهبِّ الغيابْ
هل الحبُّ ما يُوجعُ الماءَ
أم مَرضٌ في الضبابْ.. ؟
إلى آخرِ الأغنية )
– إذن قد يُصيبكَ داءُ الحنين؟
– حنينٌ إلى الغدِ.. أبعد أعلى
وأبعد. حُلمي يقودُ خُطايَ. ورؤيايَ
تُجلسُ حُلمي على ركبتيَّ كقطٍّ أليف.
هوَ الواقعيُّ الخياليُّ وابن الإرداةِ:
في وُسعنا
أن نُغَيِّرَ
حتميةَ الهاويةْ !
– والحنينُ إلى أمسِ؟
– عاطفةٌ لا تخصُّ المفكِّرَ إلا
ليفهمَ توقَ الغريبِ إلى أدواتِ الغيابْ
وأمَّا أنا فحنيني صَراعٌ على حاضرٍ
يُمسكُ الغدَ من خصيتيه
– ألم تتسلَّلْ إلى أمسِ، حينَ ذهبتَ
إلى البيتِ، بيتكَ، في حارةِ الطالبيَّة؟
– هَيَّأتُ نفسي لأن أتمدَّدَ في
تختِ أمي، كما يفعلُ الطفلُ حينَ يخافُ
أباه. وحاولتُ أن أستعيدَ ولادةَ
نفسي، وأن أتتبَّعَ دربَ الحليبِ
على سطحِ بيتي القديم، وحاولتُ أن
أتحسَّسَ جلدَ الغيابِ ورائحةَ الصيفِ
من ياسمينِ الحديقة. لكنَّ وحشَ الحقيقةِ
أبعدني عن حنينٍ تلفَّتَ كاللصِ خلفي
– وهل خفتَ؟ ماذا أخافكَ؟
– لا أستطيعُ لقاءَ الخسارةِ وجهاً
لوجه. وقفتُ على البابِ كالمتسوِّلِ.
هل أطلبُ الإذنَ من غرباءَ ينامونَ فوقَ
سريري أنا.. بزيارةِ نفسي لخمسِ دقائق؟
هل أنحني باحترامٍ لسُكَّانِ حُلمي الطفوليِّ؟
هل يسألونَ: من الزائرُ الأجنبيُّ
الفضوليُّ؟ هل أستطيعُ الكلامَ عن
السلمِ والحربِ بينَ الضحايا وبينَ ضحايا
الضحايا، بلا جُملةٍ اعتراضيَّةٍ؟ هل
يقولونَ لي: لا مكانَ لحُلمينِ في
مَخْدَعٍ واحدٍ؟
( لا أنا، أو هُوَ
ولكنه قارئٌ يتساءلُ عَمَّا
يقولُ لنا الشعرُ في زمنِ الكَارِثَةْ )
دمٌ،
ودَمٌ،
ودَمٌ
في بلادك،
في اسمي وفي اسمكَ، في زهرةِ
اللوزِ، في قشرةِ الموزِ، في لبنِ
الطفلِ، في الضوءِ والظلِّ، في
حبَّةِ القمحِ، في عُلبةِ الملحِ /
قَنَّاصةٌ بارعونَ يُصيبونَ أهدافهم
بامتيازٍ
دَماً،
ودَماً،
ودَماً..
هذه الأرضُ أصغرُ من دمِ أبنائها
الواقفينَ على عتباتِ القيامةِ مثلَ
القرابين. هل هذه الأرضُ حقاً
مُباركةٌ أم مُعَمَّدةٌ
بدمٍ،
ودَمٍ،
ودَمٍ
لا تُجفِّفه الصلواتُ ولا الرمل.
لا عدلَ في صفحاتِ الكتابِ المقدسِ
يكفي لكي يفرحَ الشهداءُ بحريةِ
المشي فوقَ الغمام. دمٌ في النهارِ.
دمٌ في الظلامِ. دمٌ في الكلامْ.
يقول: القصيدةُ قد تستضيفُ الخسارة
خيطاً من الضوءِ يلمعُ في قلبِ جيتارة.
أو مسيحاً على فرسٍ مثخناً بالمجازِ
الجميل. فليسَ الجماليُّ إلا حضورَ
الحقيقيِّ في الشكل /
في عالمٍ لا سماءَ له، تصبحُ الأرضُ
هاويةً. والقصيدةُ إحدى هباتِ العزاءِ
وإحدى صفاتِ الرياح، شماليةً أو جنوبيةً.
لا تصف ما ترى الكاميرا من جُروحك.
واصرخ لتسمعَ نفسكَ، واصرخ لتعلمَ
أنكَ ما زلتَ حياً وحيَّا، وأنَّ الحياةَ
على هذه الأرضُ ممكنةٌ. فاخترع أملاً
للكلامِ، ابتكر جهةً أو سراباً
يُطيلُ الرجاء،
وغَنِّ، فإنَّ الجماليَّ حريةٌ /
أقولُ: الحياةُ التي لا تُعَرَّفُ إلا
بضدِّ الموتِ… ليست حياة
يقولُ: سنحيا، ولو تركتنا الحياةُ
إلى شأننا. فلنكن سادة الكلماتِ
التي سوفَ تجعلُ قُرَّاءها خالدين –
على حدِّ تعبيرِ صاحبكَ الفذ ريتسوس /
وقالَ: إذا مِتُّ قبلكَ
أوصيكَ بالمستحيلْ !
سألتُ: هل المستحيلُ بعيدٌ؟
فقالَ: على بُعدِ جيلْ
سألتُ: وإن مِتُّ قبلكَ؟
قالَ: أعزِّي جبالَ الجليلْ
واكتب: ” ليسَ الجماليُّ إلا بلوغَ
الملائمِ”. والآنَ، لا تنسَ:
إن متُّ قبلكَ أوصيكَ بالمستحيلْ
عندما زُرته في سدومَ الجديدةِ،
في عامِ ألفينِ واثنين، كانَ
يُقاومُ حربَ سدُومَ على أهلِ بابلَ
والسرطانِ معاً،
كانَ كالبطلِ الملحميِّ الأخيرِ
يُدافعُ عن حقِّ طروادةٍ
في اقتسامِ الرواية /
نسرٌ يودِّعُ قمَّتَهُ عالياً
عالياً،
فالإقامةُ فوقَ الأولمب
وفوقَ القِمَمْ
قد تُثيرُ السَّأمْ
وَدَاعَاً،
وَدَاعاً لشعرِ الأَلَمْ!
نص: محمود درويش، إلى روح إداورد سعيد
من ديوان: كزهر اللوز أو أبعد