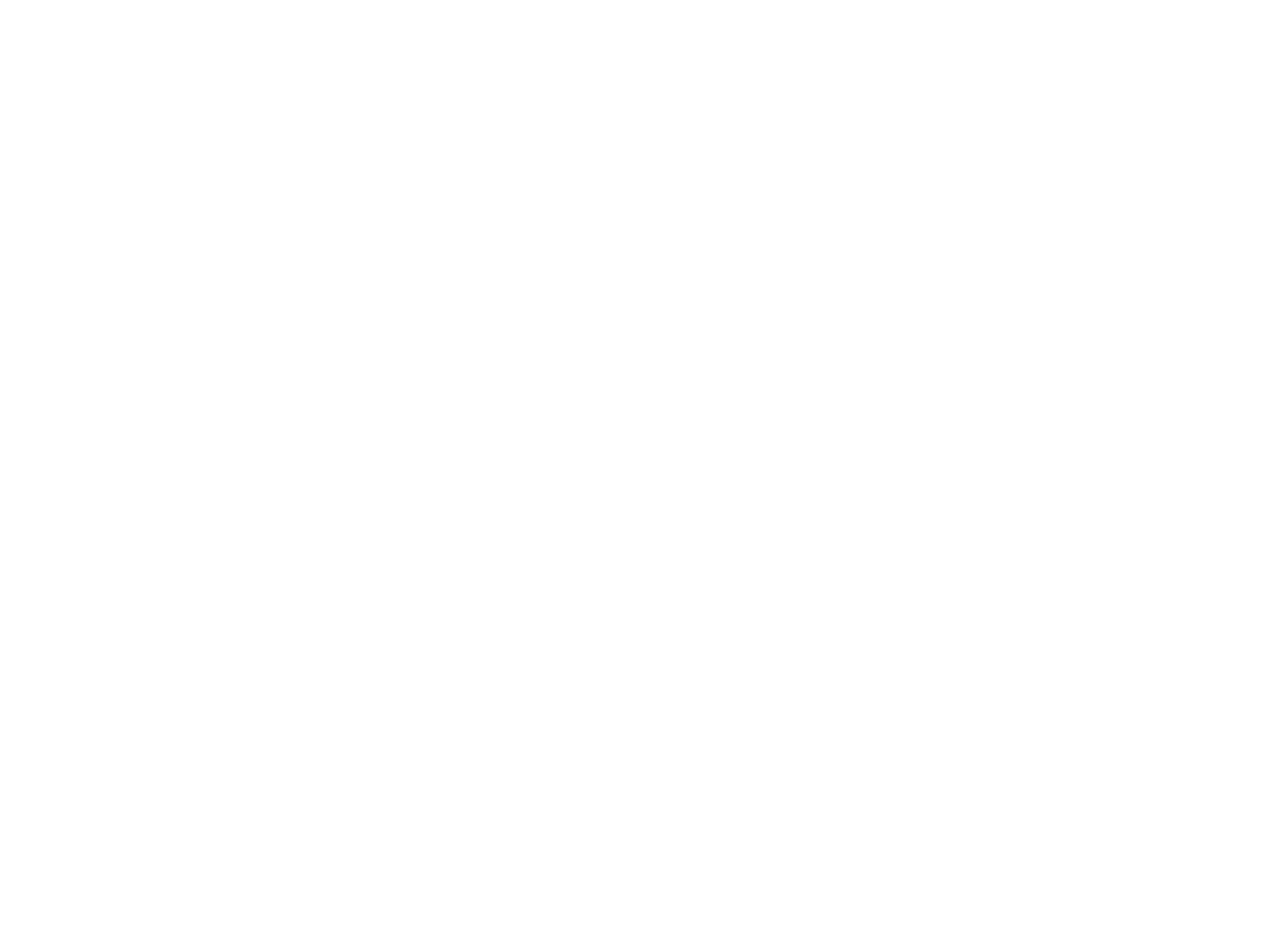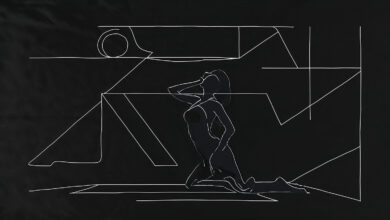لا ينبغي تسميةُ فراشاتِ العثِّ التي تطيرُ في النهار فراشاتِ عث؛ إنها لا تثير ذلك الإحساسَ الساحرَ لليالي الخريفِ المعتمةِ وزهرِ اللبلابِ الذي لا تخطئ فراشةُ العثِّ ذات الجناحِ الباطنيِّ الأصفرِ، نائمةً في ظلِّ الستارةِ، إيقاظَه فينا. إنها كائناتٌ هجينةٌ، فلا هي زاهيةٌ كالفراشاتِ ولا هي قاتمةٌ كجنسِها. بَيْد أن النموذجَ الماثلَ أمامنا، بأجنحتِه النحيلةِ بلون القشِّ، مُهدَّبا بشرّابةٍ من اللونِ نفسِه، بدا قانعاً بالحياة. كان يوما لطيفا، منتصفَ أيلول، معتدلاً، هادئاً، إلا أن له نسمةً أحمى من نسمةِ أشهرِ الصيف. كان المحراثُ قد بدأ يخدشُ الحقلَ المواجهَ للنافذةِ، وحيثما مرّت شفرةُ المحراثِ، فإن الأرض قد سُوِّيت وتبرق نداوةً. دخلتْ تلك الحيويةُ متدفقةً من الحقولِ والسهبِ البعيد لدرجة أن إبقاءَ النظرِ مركزاً على الكتابِ غدا صعباً. الغربانُ أيضا كانت تقيم أحدَ احتفالاتِها السنويةِ، وهي تحلّقُ فوق رؤوسِ الأشجارِ حتى بدا الأمر وكأن شبكةً عريضةً بآلافِ العُقَدِ السوداءِ قد رُميت في الجو، ثم نزلت ببطءٍ بعد لحظاتٍ قليلةٍ على الأشجارِ حتى بدا كلُّ غصنٍ بعُقدةٍ في نهايتِه. ثم تُنفضُ الشبكةُ مرةً أخرى في الهواءِ، في دائرةٍ أوسع هذه المرة، بأقصى ما يكون من صياحٍ وجلبةٍ، كما لو كان رميُها في الهواء واستواؤها ببطءٍ على قممِ الأشجارِ تجربةً في منتهى الإثارة.
الطاقةُ نفسها التي ألهمتِ الغربانَ والفلاحينَ والخيولَ، بل وحتى الجناحَيْن الهزيلَيْن العاريَيْن بزغبِهما، دفعتْ فراشةَ العثِّ إلى الرفرفةِ من جهةٍ إلى أخرى في حيّزِها من لوحِ النافذةِ الزجاجيِّ. لم يكن بوسع امرئٍ ما تفادي مشاهدتِها. بل إن هذا المرء كان واعيا لشعورٍ غريبٍ بالشفقةِ حيالَها. بدت احتمالاتُ المتعةِ ذلك الصباحِ هائلةً جداً ومتنوعةً جداً حتى غدا الاقتصارُ على دَوْرِ فراشةِ عثٍّ في الحياةِ، وفراشةِ عثٍّ نهاريةٍ فوقَ ذلك، قَدَراً قاسياً، وبدت شهيتُها في التمتعِ الكاملِ بالفرصِ الضئيلةِ التي تمتلكها بائسةً. طارت بنشاطٍ إلى ركنٍ من مقصورتِها، ثم طارت إلى الآخر بعد ثانية من الانتظار. ما الذي بقي لها سوى أن تطير إلى ركنٍ ثالثٍ ثم رابع؟ كان ذلك كل ما بوسعها القيام به، على رغم حجم السهوب وعرض السماء والدخان البعيد للمنازل والصوت العاطفي، بين الحين والآخر، لسفينة في البحر. قامت بما بوسعها القيام به. بدا الأمر حين مشاهدتها وكأن ليفاً من الطاقة الهائلة للعالم، دقيقاً جداً لكنه نقي، قد دُفع في جسدها الضعيف والصغير. وكلما عبرت اللوح الزجاجي كنت أتخيل أن خيطاً مفعماً بالحيوية يتبدى للعيان. كانت صغيرة أو لا شيء سوى الحياة.
مع ذلك، لأنها كانت صغيرة جداً وشكلاً بسيطاً من الطاقة التي كانت تتدفق عبر النافذة المشرّعة وتقود طريقها عبر كثير من الدهاليز الضيقة والمعقدة لدماغي وأدمغة سائر البشر، كان هنالك شيء مدهش عنها ومثير للشفقة أيضاً. كان الأمر كما لو أن أحداً أخذ خرزةً صغيرةً من جوهر الحياة، وبعد تزيينها بألطف ما يمكن بالزغبِ والريشِ وضعها راقصة ومتأرجحة ليُريَنا الطبيعة الحقيقة للحياة. لا يمكن لامرئ أن يتجاوز غرابتها، وهي معروضة بهذه الهيئة. بل حريٌّ به نسيانُ كل شيء عن الحياة، وهو يراها محدبةً ومسيطَراً عليها ومزخرفةً ومُثقلةً بحيث عليها أن تتحرك بأقصى درجات الحذر والوقار. ومرة أخرى، دعته فكرةُ كيف كانت الحياة ستكون لو وُلدت فراشةُ العث في أي شكل آخر، إلى أن يتابع حركاتها البسيطة بنوع من الشفقة.
حطت بعد حين، وقد أرهقها رقصها فيما يبدو، على حافة النافذة تحت الشمس، ونسيتُها، بينما المشهد على انتهاء. بعد ذلك، وبينما كنت أرفع بصري، استرعت انتباهي. كانت تحاول استئناف رقصها، لكنها بدت إما من التصلّب أو من الخراقة بمكان بحيث لم تقدر سوى على الرفرفة إلى أسفلِ لوح النافذة، وعندما حاولت أن تطير عبر النافذة فشلت. منصرفةً إلى شؤون أخرى، قضيت وقتاً في مشاهدة المحاولات غير المجدية هذه من دون تفكير، وأنا أنتظر بغير وعي أن تستأنف طيرانها، كما ينتظر أحدهم آلةً توقفت عن العمل هنيهاتٍ أن تعمل من جديد من دون النظر في سبب إخفاقها. بعد محاولة سابعة، ربما، انزلقتْ من الحافة الخشبية وسقطت على ظهرها، مرفرفةً بجناحيها، على حافة النافذة. حرضني عجزُ سلوكها. دار بخلدي أنها في ورطة، فهي لم تعد قادرة على رفع نفسها، كما أن سيقانها كانت تصارع عبثاً. لكنني أدركت، وأنا أمدّ قلمَ رصاص بنيّةِ مساعدتها على تعديل هيئتها، أن الإخفاق والارتباك كانا لدنوّ الموت. وضعتُ قلم الرصاص مرة أخرى.
هزت السيقان من جديدٍ بعضها. بحثتُ عما يبدو العدو الذي كانت تصارعه. نظرتُ إلى الخارج. ما الذي حصل هناك؟ من المفترض أنه منتصف النهار، وأن العمل في الحقول قد توقف. أخذ السكونُ والهدوءُ مكانَ ما كان من حيوية. طارت الطيور بعيداً لطلب القوت في الجداول. الخيول واقفة في أماكنها. لكن الطاقة كانت هناك على حالها، محشودة بالخارج غير مبالية، غير شخصية، غير مصغية إلى أي شيء تحديداً. كانت معادية، بطريقة ما، لفراشة العث الصغيرة بلون القش. لم يكن هناك طائل من محاولة القيام بأي شيء. كل ما يمكن لامرئ فعله هو مشاهدة الجهود الاستثنائية التي تبذلها تلك السيقان الضئيلة في مواجهة موت آزف، كان بإمكانه، لو أراد، أن يغمر مدينة كاملة، ليس مدينة فحسب، بل جموعاً من البشر. ما من خيار لأي شيء حيال الموت، كما أعرف. بيد أن السيقان ارتعشت ثانية بعد فترة من الإعياء. كان رائعاً هذا الاحتجاج الأخير، وغاية في الاهتياج لدرجة أنها نجحت أخيراً في تعديل هيئتها. كان تعاطف الإنسان متّجها بأكمله إلى صفّ الحياة. أيضاً، عندما لم يكن هنالك أحد يهتم أو يعرف، فقد أثار المرءَ بغرابةٍ هذا الجهدُ الضخمُ من جانب فراشة عث تافهة صغيرة في مواجهة قوة مفرطة في الحجم، للاحتفاظ بما لم يقدّره أو يرغب في الاحتفاظ به أحد سواها. مرة أخرى، بطريقة أو بأخرى، رأى المرءُ الحياةَ خرزة خالصة. رفعتُ قلم الرصاص من جديد، على رغم إدراكي لعدم جدوى فعلي. لكن حتى وأنا أقوم بذلك، برزت أمارات الموت جلية. ارتخى الجسد، وحالاً أخذ في التصلب. انتهى الصراع. عرف الكائنُ الحقير الصغير الموتَ الآن. وبينما كنت أنظر إلى فراشة العث الصريعة، غمرني بالدهشة هذا الانتصارُ الجانبي التافه لقوة بالغة العِظم على غريم دنيء. فكما أن الحياة كانت غريبة قبل بضع دقائق، فإن الموت الآن غريب. استلقت فراشة العث الآن وقد عدلت هيئتها في غاية الاحتشام والهدوء دون تشكٍّ. أجل، بدا أنها تقول: الموت أقوى مني.
*نص: فرجينيا وولف
*ترجمة: علي المجنوني