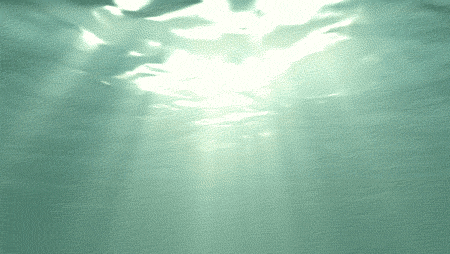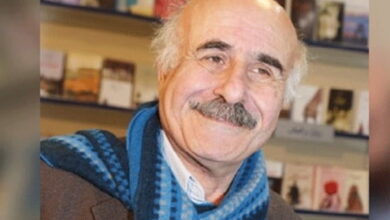ليلتها، تسكَّعتُ طويلاً في الغابة، وعاودتني رؤيا النسر: سماء زرقاء أنا تحتها نسر رماديٌّ يحلق عالياً، ويطير مائلاً، بسرعة فائقةٍ، ويرى كلَّ جُغرافيا ذاكرتي، جُغرافيا سأعيدُ صياغتها كلَّها، ورآني النسر هنا، في ممَّرات الغابة، وحدَّقنا في بعضنا قليلاً، وبدا وكأنَّه يتأمَّلني، ثم واصلَ طيرانه، نحو ما لم أكنه بعد: فنَّاناً في إعادة تصميم نفسي.
كنتُ أيامها أقرأ، للمرة العاشرة ، ربما ، كتاب «رأس المال» لماركس. وذهبتُ إلى بيت «بري» ليلاً، ولاحظ الكتاب معي فقال، وكنَّا قاعدين، في الصالون ، «يا رجل! الحياة ليست تركيباً منطقياً ألمانيَّاً. أقسم بالله سأكتبُ يوماً ما كتاباً عما تفعله الطوائف بالعقول».
-«هل قرأت ماركس؟»
-«نعم»
– «ما رأيك فيه؟»
– «ليس فيه يا رجل ، فالمعرفة لا شخصية»
– «حسناً.. فيما كتبه؟»
– «كتب ألغازاً يا رجل! درستها لأربع سنوات»
-«هل فككت ألغازه؟»
– «تعلمت منه شيئاً: ألا أفقد «حسي» العادي بالأشياء وبالعوالم الغريبة التي تسري روحي فيها، هذا نافع، أعني لا تفقد يا حسين حسّك العادي بالدنيا».
– «وما هذه العوالم الغريبة التي تسري فيها؟ أي ، أين أنتَ الآن؟»
– «لا جدوى مما لا حدس عندكَ بوجودهِ»
– «أعني كيف يبدو لك عالمي؟»
– «لا أعرفُ عنكَ شيئاً. فعمقُ البحر لا يعرف شيئاً عن شواطئهِ. وجهُكَ شاطئ».
هزَّتني جملة «وجهك شاطئ». تخيَّلتني في مكانه، في «عمق البحر»، وأنظر نحو الشاطئ: وجهي. وصعقتني فكرة أُخرى: كانت تبدأُ مُطاردة البحرِ لي في حُلمي في بيروت، وأنا طفل صغير جالس على حجرٍ في رمال الشاطئ عارياً، وملابسي بيدي، وأُحدِّقُ في البحر مذهولاً وخائفاً. كنتُ أرى البحر بعيني الطفل دائماً ، ولا مرَّة جرَّبتُ فيها أن أرى الطفل بعيون البحر. كنتُ أرى البحر «رائعاً»، وأرى زرقته ، موجه، انفصام شخصيته، رماله، استداراته، وأراه يُطاردني، ولكن، لم أر أبدأ كيف «كان البحر يراني». و«وجهك شاطئ» جعلتني أرى الطفل بعين البحر.
تخيَّلتني بحراً: في أقاصي ضبابٍ أزرق واسع فيه قوارب ضائعة، وموج يترامى مثل خيول من الزبد، بروعة يترامى، وفي كلِّ الجهات، ولكن الصياغة كلَّها حمقاء: كيف يقنع بحر بهذه العظمة والقوة نفسه بمطاردةِ طفل يحلمُ، أصغر من دمية بنت حمراء على شاطئه، منكمشٍ، عارٍ، وملابسه بيديه الصغيرتين ويخشى الموت غرقاً، كيف تقنع نفسها قوة الكون العظمى بمطاردتهِ؟
بدأتُ أدخل في شبه غيبوبة، كمن نوَّم نفسه مغناطيسياً. وقلت: «بري.. لسنين، كان البحر يُطاردني، وكان وجهي شاطئاً».
قال: «اسبر نواياه».
إنَّني أسبرها: فأنا الآن أُحدِّقُ في نَفسي بعينِ البحر. اختفى جسدي الفيزيائي وصار البحرُ لي جَسداً، وأسري فيه روحاً في مدى. لستُ سمكة في البحر الآن، أنا البحر، «بري»!
قال: «اسبر نواياه!». وفجأة، بدأتُ أرتفع، الزُرقة تنتفخ وترتفع، رويداً رويداً، وتغضب، ويعلو مَوجي في العمق، ويأتي من بطني، وأغواري، وكأني بطن أنثى حملت بقطيع أفاعٍ، وشرور، وينهار في الموج، لينتفخ البطن أكثر، وترتفع الزُّرقة: قد بدأ الفيضان وبيروت دمية!
قال: «اسبر نواياه، حسين، اسبر نواياه».
كلُّ هذا الغضب المكبوح، الفيضان، الرغبة في تدمير الدنيا، الجنون ، أنا وسطي لم يزل أزرق مشمساً، واسعاً، كلُّ هذا السطح، أنا تحت، سطحي من الشرور ما يجعل أمي تتمنى لو لم تكن قد ولدتني، أفتعرف ما معنى المنفى، «بري»، أفتعرف ما معنى المنفى؟ هذا الطفل الهش الصغير، الدمية الحمراء، في بطنه بحر! وفيضانات مكبوحة!
قال: «اسبر نوايا الطفل، حسين، اسبر نواياه!».
يغريه البحر أن يلتقي بنفسه، بغضبه الذي سنَّته عليه الآلهة والشياطين والقرون الماضية، كيف يقنع بحر نفسه بمطاردة طفل يا «بري»؟ وإلى أي مدى كان يحتاج الأمان ، إلهي! كم كان يلزم من القوة كي ينهش الناس قلبه ، كي يخلقوا بحراً كاملاً من الغضب في بطن طفل؟ لقد اغتصبوني حتى وصلوا قلبي يا «بري»، أنت من قلت لي عنك: اغتصبوني حتى وصلوا قلبي، وأنا أخوك!.
كنتُ أبكي وأبكي ، ولم أعد أذكر بعد هذه اللحظة ماذا حدث. كنتُ أخرج من نوبة بكاء لأخرى. قال: «دموعكَ آخر شكلٍ للفيضانات: الآن البحر يرشح منكَ على هيئة دمع».
ونهض وأخذ يغني ويصفق ويهتف وهو يدورُ حولي: «تعارف طفل الجبل الذي فيك والبحر الذي في ، وصرتما واحداً ، واتسعتَ، فطوبى لمن يتسعون».
وأدركتُ أنَّ خوفي من أن تَنفصم شخصيتي وتقوم شخصيتي الثانية باقتراف جريمة لا تعرف عنها شخصيتي الأُولى، ليس إلا حدساً بالبحر الذي في بطني، والموج الذي ذابت فيه كالملح كلُّ غرائز التدمير التي خلقها الله أو عبيده فيَّ وأنا طفل، «شخصيتي الأخرى» هي هذا البحر نفسه. كنت أخشى الفصام لأنَّني كنتُ منفصماً أصلاً! كان البحر يطاردني لأنَّه أعمق وأصدق وأوسع شكلٍ عرفه غضبي، ونواياه تدمير العالم كلِّه.
طفل الجبل على شاطئ البحر شمعة صغيرة مضيئة في الليل يا «بري»: إنَّها حاجة البحر للأمان . والبحر رغبة الشمعة في تحويل الكون إلى حطب وبدء الحريق الأعظم. والنتيجة طفل فيه هوج البحر وبحر فيه قلق الطفل. بدأتُ أَرَى الجنون، ويحلّ لمن يرى عمقاً كهذا أن يعيد صياغة نفسه.
والغضب أبيض
ولها وردتها
تلكَ السيدة
فلنعطها الكون!.
كنتُ بئراً، ويحق لها، تلك البئر، أن تصبح الآن سُلّمًا.
ولنعطها الكون.
وسألتُ «بري» وأنا لم أزل أفيض كالبحر: «ما هو الجنون؟»
«ألا تدرك نواياك من حيث إنها نوايا».
قلت: «لم أفهم. كان يطاردني بحر بيروت في حلمي ، لسنين يا رجل، دعني أفهم هذا».
– «عقلـي سكّين من الذهب صارت حافية وأنا أحاول أن أجعلك ترى نفسكّ».
– «ولكنك تتكلم ألغازاً! ماذا أن أدرك نواياي من حيث إنهَّا يعني نوایا؟»
-«يعني أن غضبك على الدنيا، غرائز التدمير فيكَ، خوفكَ من الموت غرقاً، حاجتك َللأمان، ليست إلا نوايا قلبكَ. ولكن عقلكَ لا يعرف ولا يفهم هذه النوايا ، هذا الذي تسميه «عقلك» لا يفقه شيئاً. قلبك عصر نفسه مثل ثمرة كبيرة ومُرَّة ، كلُّ مرارته في الدنيا عصرها في البحر، وذابت فيه كالملح، صار مذاق البحر مُرَّاً جداً. وهذا هو الفيضان: يحاول قلبكَ أن يأتي إليكَ، ويذيقكَ ثمرته السوداء، يريدكَ أن تشعر به، ويلاحقك ليعطيك البحر، ليقول لك: هذا المذاق المالح وهذه المرارة هي شعوري بالحياة ، وخلاصة عمرك!»
-«وما الجنون؟»
-«قلبك يأتي إليك متنكراً في هيئة بحر، فتعتقد أنَّ قلبك هو بحر بيروت. هناك بحران: بحر بيروت وبحر قلبك. الأول حقيقي، والثاني بحر نواياك. وأنت تجهل الفرق بين البحرين، وهذا جهل بنواياك من حيث إنهَّا نوايا، جنون يا رجل!»
-«وما الضمانة ضد الجنون؟».
أطرقَ طويلاً، وهو يلفّ لفافة تبغ ويبصق الفتات، وحل أثقل صمتٍ في حياتي، ثم قال: «الضمانة ضد الجنون ألا تنَوي أبداً».
*نص: حسين البرغوثي
*من رواية: الضوء الأزرق